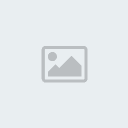
(رسالة إلى حسن بن عثمان)
في العام 1996، اقترح محمود درويش أن نكتب، استنادا إلى تجارب شخصية، عن العلاقة بين الوطن والمنفى. كان قد مرّ عامان على عودتنا من تونس، وكانت “الكرمل” على وشك الإقلاع من رام الله، بعيدة عن مسقط رأسها البيروتي، ومنفاها القبرصي، وقريبة من وطن أحلامها.
لم تكن العلاقة بين الوطن والمنفى، آنذاك، نوعا من التأملات النظرية، بقدر ما كانت جزءا من السيرة الذاتية. ولأنها كانت كذلك، كان فيها ما يحرّض على البحث في الجزئي، والذاتي، عمّا يقبل التعميم. ولعل أوّل سؤال، في هذا الصدد: هل العودة ممكنة، فعلا، بعد سنوات طويلة في المنفى؟
العودة بالمعنى الفيزيائي ممكنة بطبيعة الحال، وهذا ما حدث، ويحدث في الواقع. لكن لا أحد يعود بكثير من المعاني الأخرى، التي لم تكفّ منذ الأيام الأولى، ومن خلال تجليات تكاد لا تلحظها العين عن صياغة السؤال الكبير، والمفزع في أحيان كثيرة: هل كنتُ حقا هنا؟
أشياء كثيرة تقول بأنني كنت، حقا، هنا. الوجوه، والروائح، واللهجة، وآداب السلوك، والجدران، والزواريب الضيقة التي لا يعرفها إلا من ركض فيها طفلا، تقول بأنني كنت، دائما، هنا، ولم أغادر أبدا.
حتى البيت، الذي وُلدت فيه، بشجرته العالية، وثقوب النمل التي استطيع تحديد مكانها مغمض العينين، والجدار الذي سقطت عنه ذات يوم بعيد، أشياء تشهد بأنني كنتُ هنا. خلف هذا الفرن اكتشفت، بعد أوّل قبلة، معنى الجنة. وفي هذا الشارع وزّعت المناشير، رغم حظر التجوّل، واحتمال رصاص سيبرق فجأة في الليل، ليضع حدا لحياة لم تكد تبدأ بعد. والذكريات التي حضرت فجأة، وكأن أصدقائي احتفظوا بها، وحافظوا عليها، كمقتنيات شخصية باهظة الثمن، تشهد بأنني كنتُ هنا.
ومع ذلك، كانت ثمة صعوبة خاصة في الرد على سؤال يكرره سائق التاكسي، وصاحب الدكّان، وعابر الطريق، والجالس على مائدة قريبة في المطعم، أو يتجلى في عيونهم بطريقة لا تقبل الشك: من أين أنت؟ ومصدر الصعوبة أن الرد بأنك من هذه البلاد غالبا ما كان يُقابل بنوع من الارتياب.
في تلك الأيام أصبح تعبير الفلسطينيين التوانسة قيد التداول. وكما في حالات لغوية مشابهة يصعب القول إن التعبير المذكور كان من صنع شخص بعينه، أو نشأ بفضل حادثة ما، فقد كان أقرب إلى الصياغة الجمعية منه إلى الاجتهاد الفردي، وكان مشحونا بدلالات أيديولوجية وسياسية تستهدف تعزيز الغيرية وتكريس الاختلاف بين العائدين والمقيمين.
ويصعب، في الواقع، لوم هؤلاء أو أولئك، بسبب ما انطوى عليه التعبير من دلالات سلبية. فقد التقت في لحظة تاريخية ملتبسة جماعتان من البشر بعد غياب طويل، ليكتشف الطرفان ما سبق واكتشفه عائدون ومقيمون منذ أزمنة بعيدة، وما تجلى في أهم ملاحم المنفى وأكثرها دلالة: عوليس لم يعد بكثير من المعاني، وبنيلوبي التي اتشح رأسها بالبياض لم تكن المرأة نفسها.
وإذا ما وضعنا الحقيقة الشعرية باعتبارها أداة لإدراك الواقع بطريقة لا تقل أهمية عن الحقيقة السياسية، أو الاجتماعية، فلنقل أن ما يكرّس الغيرية والاختلاف كان مصدره تضارب القيم، أيضا. ففي الزمن الفاصل بين الخروج والعودة طرأت تحوّلات يصعب حصرها على المجتمع الفلسطيني، كان من أبرزها صعود الأصولية ونجاحها في تصفية الكثير من ملامح مجتمع اتسم في أوقات سابقة بالانفتاح والتسامح.
وكما حدث في كل مكان آخر من العالم العربي، كانت مطاردة الإيروس في فلسطين، وتدمير مختلف تجلياته الفردية والجمعية، هي الشغل الشاغل للأصولية، وسبيلها إلى احتلال المجتمع.
والإيروس، هنا، يتجاوز الدلالة الحصرية للجنس، ويتعداها إلى كل ما يتصل حسب التعريف الفرويدي بدافع العيش مع كل ما ينطوي عليه من حض على الحياة، والحب، والبهجة، والإنجاز، والتقدّم، والتفريد، مقابل إرادة الموت التي تحض على ممارسة أشكال مجازية للموت مثل الاكتئاب، والنكوص، والعزلة، وكراهية الذات، وإدمان الفشل، ناهيك عن تنامي الميول الانتحارية، وتدمير الجسد في نهاية الأمر بالمعنى المادي للكلمة.
وقد عثرتُ على تلك الدلالات مجتمعة ذات ليلة في مخيم الشاطئ بغزة. كان الظلام حالكا، فلا أضواء تنير الشوارع، وأكوام النفايات مكدسة في كل مكان، على مداخل البيوت، وفي وسط الشارع، وتحت النوافذ، وفي كل مكان آخر يتسع للمزيد، وفوق أكوام النفايات آلاف الجرذان التي تركض بحثا عن طعام، وتتصارع عليه، ولا تخشى عابر السبيل، الذي يبدو في نظرها متطفلا، وفائضا عن الحاجة. فجأة، تقع العين على عناقيد من الضوء، شاحبة، وعليلة، تتدلى مما يشبه عمودا من الاسمنت، يتوّسط جزيرة صغيرة عند تقاطع شارعين.
الضوء الشاحب لا يبدد الظلمة، بقدر ما يوحي بثقل الكابوس، لكنه يحرّض على تحري حقيقة ذلك العمود الإسمنتي. أقترب من الجزيرة الصغيرة لأرى وسط سياج من حصى وحجارة متفاوتة الأحجام ما يشبه مسلة بدائية من الحجر، نُقشت عليها أسماء أشخاص قتلوا في مجابهات مع الاحتلال. وكما لمع الضوء في شارع مظلم، تلمع في الذهن فكرة مفزعة: لا شيء يضيء في هذا المكان سوى الموت.
الموت الذي يحرّض آخرين، ولا يندر أن تكون بينهم نساء، على توجيه نظرات حقد وامتعاض صوب نساء حاسرات الرأس في الشارع. وهو الموت نفسه الذي يدفع أستاذا للأدب العربي في جامعة محلية لامتهان حرفة مطاردة الجن، خاصة الجن اليهودي، الذي أتقن طرده من الأجساد المعطوبة بالقوة. وهو الموت الذي تمكن بفضله دجالون من افتتاح عيادات للطب الإسلامي، في كل شارع تقريبا، ونشر إعلاناتهم الدعائية في الصحف المحلية، والحصول على شهادات من أطباء محترفين.
كثيرة كانت تجليات الموت، لكن أخطرها كان تلك الممانعة التي تصعد من مكان عميق في الروح تجاه احتمال العودة إلى الحالة السوية، التي تعني ضمن أمور أخرى تطبيع الحياة اليومية للناس، وتحريرهم من قبضة الأصولية، التي رأت في إنشاء السلطة الفلسطينية خطرا ينذر بزوال الهيمنة، وتحرير الناس من وشم الطاعة، الذي وسمته على أجسادهم بوسائل مختلفة ليس أقلها الإرهاب المادي والمعنوي. لذلك، ورغم أن العائدين من تونس كانوا أقلية، مقارنة بعائدين من بلدان عربية أخرى، إلا أن دلالة الفئة الضالة، والساعية إلى تقويض التقاليد، ارتبطت بهم أكثر من الآخرين.
يمكن، بالتأكيد، الكلام عن جوانب إضافية في هذا الشأن. ولكن ما ينبغي إيضاحه، هنا، يتمثل في حقيقة أن التوظيف الأيديولوجي لتعبير الفلسطينيين التوانسة لم يظهر في أكثر أشكاله وضاعة وابتذالا كما ظهر في سياق الصراع على اقتسام كعكة السلطة الجديدة. لم يكن اقتسام السلطة، أو الانخراط فيها، هدفا من أهداف الأصولية، بل كان الهدف تقويضها، لذلك انحصرت مرافعات الأصوليين ضد العائدين في حقلي السياسة والأخلاق. فهم خونة بالمعنى السياسي، ومفسدون بالمعنى الأخلاقي.
أما مرافعات الباحثين عن نصيب أكبر في الكعكة، أو عن تحسين شروط الانخراط في بنية السلطة الجديدة، فغالبا ما كانت “وطنية”، أي تسعى إلى تبرير مطامح شخصية باسم الدعوة إلى العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، وعدم تجاهل تضحيات المقيمين، التي أسهمت ضمن أمور أخرى في تحويل أوّل سلطة فلسطينية في التاريخ إلى حقيقة قائمة. ولم يتوّرع بعض الطامحين في سياق كهذا إلى استخدام تعبيرات من نوع “السكّان الأصليين” و“الهنود الحمر” لوصف المقيمين نكاية وتنكيلا بالقادمين من مكان بعيد، الذين اقتسموا السلطة والثروة في ما بينهم.
ولم يكن في الواقع ما هو أبعد عن الحقيقة من وصم القادمين من مكان بعيد، وغالبا ما اختلطت أوصافهم المحتملة بتعبير الفلسطينيين التوانسة، باقتسام السلطة والثروة في ما بينهم. فقد كان بين هؤلاء من دفع ضريبة عدم الانتماء إلى فتح، التي أصبحت حزبا حاكما، أو من دفع ضريبة وجود خصوم أقوياء، أو من لم يجد الواسطة المناسبة، أو من استنكف عن الدخول في لعبة تفتقر إلى النـزاهة.
إجمالا، يمكن القول إن ديناميات الصعود في بنية النظام الجديد لم تعتمد على تقسيمات جغرافية، أو حتى أيديولوجية، وحزبية، بقدر اعتمادها على اجتهادات وتجارب عاشتها منظمة التحرير في عقود سبقت، وعلى محاولة إعادة إنتاج تجارب عربية معروفة في الإدارة والحكم.
وفي هذا الجانب بالذات يمكن العثور على مفارقات قد تسهم، رغم ما تنطوي عليه من كوميديا سوداء، في تفسير كيف ولماذا تتحوّل الدولة في النسق السياسي العربي إلى دولة فاشلة، بكل ما لأمر كهذا من تداعيات تهدد النسيج الاجتماعي، والوحدة الترابية، والهوية الثقافية.
ففي فلسطين، التي توّقع العرب والعجم، أن ينشئ أبناؤها بفضل خبراتهم السياسية، وتجربتهم الكفاحية الطويلة، نموذجا للحكم يختلف عمّا ألفه العرب من قبل، نشأ نظام أقصى ما لديه من طموح أن يعيد في أواسط التسعينات إنتاج نموذج الأنظمة الناصرية، والبعثية العراقية والسورية في الستينات، وحتى ما قبلها، رغم أن إفلاس الأنظمة المعنية لحظة ظهور النظام الفلسطيني إلى الوجود لم يعد قابلا للتمويه.
وفي سياق التماهي مع، وإعادة إنتاج، نماذج مفلسة نشأ في فلسطين نظام شعبوي جديد، يمثل خليطا من الناصرية والبعثين السوري والعراقي، حيث يحتل الفضاء السياسي والثقافي أقنومان هما القائد الملهم، والشعب المجيد، بينما تدير أجهزة الأمن، بالتعاون مع، ومن خلال، أو نيابة، عن الحزب الحاكم، شؤون البلاد والعباد، وتمارس مؤسسات مثل البرلمان لعبة الديمقراطية.
وقد تفوّق النظام الشعبوي الجديد، على مثاله العربي المحتذى، عندما اجتهد في إحياء البنى الاجتماعية التقليدية، وتقريب أهل الولاء مقابل إقصاء أهل الخبرة، وفي عسكرة الجهاز الإداري، وفي تحويل القضاء إلى موضوع للمساومة بين الحكّام والمحكومين، وفي اختزال عملية صنع واتخاذ القرار في يد الحاكم، الذي احتفظ لنفسه بحقوق لا تقبل النقض، بما فيها تعيين صغار الموظفين في أجهزة السلطة.
كان العثور على أوجه للتشابه بين النظام الشعبوي الجديد، وأنظمة عربية مفلسة، بمثابة فاجعة شخصية بالنسبة لي. وإذا ما وضعنا المشاعر الشخصية جانبا، فإن العمليات الاجتماعية والثقافية والسياسية، بملايين التفاصيل والنتائج المرئية وغير المرئية، المصاحبة لمشروع بناء النظام الفلسطيني، كانت مثل خلاّط هائل الحجم امتزجت في جوفه مكوّنات كثيرة، انصهرت، وتبعثرت، وتغيّرت، لتخلق واقعا جديدا لم يكن القادمون من أماكن بعيدة عنوانه الرئيس أو علامته الفارقة. ومع ذلك، ظل تعبير الفلسطينيين التوانسة قيد التداول، لأن شحنته المجازية تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، وفي سياقات مختلفة أيضا.
وإذا جازت العودة، عند هذا الحد، إلى الفردي، والخاص، فقد مررت بحالة ربما توجز، أو تشبه، ما عاشه آخرون. عند مغارة تونس في صيف العام 1994، بدا وكأن سحابة سوداء تجلل الذاكرة. في الأيام الأولى اتصلت عددا من المرّات بهاتف آخر بيت أقمت فيه، وأطلت الاستماع إلى رنين الجرس في بيت لم يسكنه أحد بعد. أقول لنفسي أسمع الآن رنينا يأتي من تونس، أو ربما أحاول التدليل بأنني لم أعد هناك.
ولسبب ما، ربما كان حيلة دفاعية من ألاعيب العقل الباطن، بدت تونس في تلك الأيام شبحا بعيدا، غامض الملامح، وغير واقعي تقريبا، ليس فيها ما يحرّض على حنين يوجع القلب، أو يسعف ذاكرة بما يمكن صاحبها من انتشال عالم يغطس في مكان سحيق. ربما كان في تأثيث المكان الفلسطيني المستعاد بحنين إلى أماكن أخرى ما ينتقص منه، أو ما يهدد بخيانة محتملة.
مهما يكن من أمر، عدتُ إلى تونس بعد خروجي منها بثلاث سنوات. وقد حدث آنذاك ما لم يكن متوقعا. فما أن هبطت الطائرة في المطار، حتى انتابني إحساس العائد إلى البيت. لم أتعجل في مغادرة المطار على عادة المسافرين، بل تمهلتُ كمن يطيل أمد المتعة بطريقة إرادية، تجوّلت في أنحاء المطار مسترقا السمع إلى اللهجة التونسية، التي سرعان ما قفزت جماليات المد والتسكين في لفظ حروفها إلى طرف اللسان، وتأملت الوجوه التي تبدو أليفة ومألوفة.
عندما خرجت من المطار كدت أن أفعل ما فعلته مرّات لا تحصى من قبل، أن أمد يدي إلى جيبي بحثا عن المفتاح. هجمت الذكريات والأشياء دفعة واحدة، وكذلك العادات اليومية، أي ما فعلته بطريقة روتينية تقريبا على مدار سنوات طويلة، ووجدتني مدفوعا إلى ممارسة تلك العادات مجددا، حتى وإن بدت مصطنعة، وفائضة عن الحاجة. المدهش، أيضا، أن علاقات عديدة بالناس وبالأمكنة بدأت من حيث توقفت قبل سنوات، وكأن الغياب مجرد انقطاع لا قطيعة.
وفي ذروة انفعال يفيض بتداعيات الوصل والوصال، كان معنى تونس يتجلى بطريقة تضفي على العلاقة الشخصية بعدا وجوديا غالبا ما تفشل لغة السياسة في اكتشافه، أو التعبير عنه. فقد نشأت في متن العلاقة بين الوطن والمنفى، ومنذ أزمنة سحيقة، تساؤلات حول أولوية البيت أم الطريق. من أجمل البيت أم الطريق إلى البيت.
كان إدوارد سعيد، مثلا، مفتونا بقصة لكونراد عن بحّار جنحت سفينته في بلد بعيد، فعاش منفيا عن وطنه وعن لغته، التي استعادها بينما كان يعاني سكرات الموت، ويتمتم بلغة غريبة، وكلمات غير مفهومة، كأن في استعادة اللغة ما يحقق عودة مجازية.
لكن سفينتنا لم تجنح على شواطئ تونس، ولم نعش فيها منفيين عن اللغة، أو غرباء إلى حد يجعل منّا آخرين، في نظر أنفسنا، وفي نظر الناس الذين أقمنا بين ظهرانيهم. وبهذا المعنى يمكن القول إن في الطريق إلى البيت بيوت، فالوصول إلى البيت يعني النفي من بيت سبقه، لذلك يصبح آخر البيوت ما لا يمكن الوصول إليه، وينفرد الطريق بجماليات يستمدها من استمرارية تستعصي على الانكسار، لا من نهاية محتملة. وهذه لعنة المنفى ونعمته الفائقة.
وبهذا المعنى، أيضا، تكتسب عبارة محمود درويش دلالة كونية، تتجاوز خصوصية المنفى في سياقه الفلسطيني: “لستُ من هنا ولا من هناك”. يصعب على بني البشر، بالتأكيد، ألا يكونوا من هنا أو من هناك.
ورغم أن وسائل النقل والاتصال الحديثة تجعل الانتماء إلى أكثر من مكان، في وقت واحد، جزءا من تجربة غير مسبوقة لملايين البشر في عالم اليوم، إلا أن للمنفى دلالة روحية أبعد من إمكانية الانتقال من مكان إلى آخر.
تعلمتُ، إذن، من تونس أن الطريق إلى البيت بيوت. خلال سنوات الإقامة في تونس، كنتُ كلما ذهبت إلى شاطئ البحر، ورأيت موجة تضرب الشاطئ أقول: هذه الموجة جاءت من هناك، من فلسطين. وعندما أقمت في غزة بعد العودة من تونس كنتُ كلما ذهبت إلى شاطئ البحر ورأيت موجة تضرب الشاطئ أقول: هذه الموجة جاءت من هناك، من تونس.
لقد ارتبطت حياتي بالعيش على سواحل المتوسط، وبموج يضرب الشواطئ قادما مرّة من تونس، ومرّة من لبنان، ومرة من فلسطين. وفي كل من هذه الأماكن ما يوحي باحتمال البيت. لذا، يمكنني الكلام الآن عن ثلاثة أوطان شخصية كان الخروج من أي منها ذهابا إلى المنفى، والذهاب إلى أي منها خروجا من وطن. وإذا تكلمتُ، هنا، عن تجربة فردية وخاصة، فمن المؤكد أن أعدادا يصعب حصرها من الفلسطينيين التوانسة، لن تجد صعوبة في القبول بخلاصة كهذه.
هذه، يا أخي العزيز، حسن بن عثمان، القصة من الجانب الآخر، لعل فيها ما يستكمل بعض ما جاء في مقالتك قبل أيام، ويفسر جانبا من العلاقة الخاصة التي نشأت بين عدد من الفلسطينيين وتونس.




