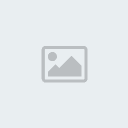
معظم دول الإسلام ـ رجل العالم المريض ـ تأتي في مرتبة متأخرة في لائحة البلدان الأكثر تخلفاً على كل المستويات، و ما زاد الأمر نكاية هو الصحوة الإرهابية التي جعلت من المسلمين أصحاب الحظ الأوفر في العمليات الإجرامية الأشد بشاعة في العالم، مما استجلب على المسلمين عداء العالم كله، في حين أنهم أشد الشعوب تخلفاً و أضعفها ،فما أكثر عددهم و ما أكثر هزائمهم ، و هو ما استتبع لا العداء فقط ، بل الاحتقار والحصار و معاملة المسلمين معاملة ترويضية ، كمن يروض حيوانات مفترسة لم يرتق إدراكها بعد ، و لا تملك حساً أو ضميراً إنسانياً ، فيطعمها و يسقيها بالمعونات لكن يحدد لها دوراً لا تتجاوزه ، و يقسو عليها أحياناً أخرى فيحاصرها ليتم تحجيمها باستمرار ، و يحافظ على بعضها من الانقراض كحفرية حية ، و يترك بعضها في مناطق أخرى يأكل بعضها البعض في فوضى خلاقة حتى تصفو النيران عن رماد خامد غير ضار.
وبسبيل العثور على ثقب في هذا الواقع الآسن نحو تغيير و إصلاح يؤدي إلى خلاص منطقتنا وانعتاقها مما هي فيه ، انقسم المفكرون في بلاد المسلمين على أطيافهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلى فريقين رئيسيين: فريق أرجع الأزمة إلى عدم التزام خير أمة أخرجت للناس بدينها حسب الأصول ، و هو ما يجعلها تطلب النصرة السماوية فلا تستجيب السماء لها ، بل تنزل بها النوازل والإهانات و الكوارث يقفو بعضها بعضا ، في عملية تأديب ربانية للأمة كلها ، ذلك أنها فرطت في فروض دينها وحدوده و تأثرت بما عند الشعوب الأجنبية من أساليب عيش هي على النقيض مما جاء في إسلامنا ، لذلك حقت علينا النقمة الإلهية ، و لا حل إلا بالعودة الكاملة الخالصة لهذا الدين والالتزام الدقيق بأوامره ونواهيه وفروضه وحدوده الشرعية و أخلاقه السامية، والتسنن الكامل بسنة رسول الله ( ص ) و سنن الراشدين الهداة المهديين. وعندما يتيقن ربنا من استئهالنا للرحمة حسب معاييره، و قدر رضاه عما حققنا من حسن عبادة و إخلاص، فإنه سيتدخل بنفسه لإنقاذ أمته التي اصطفاها لقيادة العالمين، و هذا الفريق هو الأكثر انتشاراً بين جماهير المسلمين.
و يغلب على أعضاء هذا الفريق روح التنظيم لتعودهم الطاعة المطلقة ، فيشكلون جماعات شديدة التنظيم والانضباط و الاستجابة الحركية السريعة ، تبدو بينها على السطح خلافات في الدرجة لكنها غير نوعية ، فهي تتوافق جميعاً على الأهداف وإن اختلفت الأساليب ، ويزعم هذا الفريق أننا قد جربنا العلمانية ( يقصدون الدكتاتوريات العسكرية ) و النظام الجمهوري و النظام الملكي و الاشتراكية و الرأسمالية ، و سقطت جميعاً وسقطنا معها في المزيد من التخلف و الانهيار، ولم تجلب تلك التجارب سوى الهزائم المتتالية دون خلاص واضح في المستقبل المنظور ، و لا يبقى سوى استيلاء أنصار هذا التيار على الحكم ليحكموا المجتمع حكماً إسلامياً ، أو بالأحرى أن يفرضوا سلطانهم من خلف ستار لحكام شكليين ، بحيث يكونون هم المرجعية في اتخاذ أي قرار أو إصدار أي قانون ، و أن يكونوا هم الهيئة المحاسبية الأولى الرقابية ، دون أن يحكموا بشكل ثيوقراطي مباشر ، و بموجب هذا الشكل من الحكم تتم الأسلمة الكاملة للمجتمع و الدولة ، و عندئذ سوف يتدخل رب السماء لينصر أمته و يعيد لها أمجاد الفتوحات ، كما نصر السلف.
أما الفريق الآخر ( العلماني ) فقد ذهب مذهباً هو على النقيض بالمرة من الفريق الأول، و هو الأقل انتشاراً بين الجماهير لكنه الأكثر قدرة على الوصول إلى حلول علمية، والأكثر منطقاً ، والأقوى حجة ، و يستند إلى الواقع الملموس في نجاح العلمانية أينما طبقت . لذلك تتم محاربة هذا التيار والطعن فيه لدى المسلمين بكونه يناهض الدين و يناوئه، حتى لا يصل إلى الناس أصحاب المصلحة فيه، و يعاني هذا الفريق إضافة إلى التحريض ضده وتبخيسه و تكفيره و تخوينه، من خلل شديد أصيل في بنيته، لأن العلمانية أو الليبرالية هي حرية فردانية بطبيعتها و بما تتضمنه من مفاهيم، فيكون الفرد عصياً على الانضباط و التنظيم الحركي، و لا يخضع العلماني إلا لقوانين العقل و العلم و الأصول الحقوقية و الدستورية للمجتمع المدني، التي يطيعها عن قناعة وإيمان بحفظها لسلامته و سلامة المجتمع . لذلك فالليبرالية لا تقوم في مجتمع إلا عندما تنتشر بقوتها الذاتية ، و قدرتها على الإقناع و ما تملكه من وسائل و أدوات للأمن الاجتماعي ، و ما تحظى به من أدوات علمية تقدم بها نفسها مدعومة بالبرهان و الدليل مع نضوج الأوضاع الاجتماعية لقيام طبقة صاحبة مصلحة فيها تؤسس لها و تحميها و هو الدور الذي أنجزته في أوروبا الطبقة البورجوازية بعد الثورة الصناعية .
و الفريق العلماني بالطبع لا يرجع الأزمة إلى تأثر المسلمين بثقافات غير إسلامية، بل يرى أنهم أبعد ما يكون عن هذه الثقافات بعداً سحيقاً ، و لا يرى أن مصائبنا تبدأ مع الاستعمار الحديث و سقوط الخلافة ، لأن الخلافة كانت قد مرضت و شاخت و كانت فقط تنتظر من يعلن وفاتها ، بل كانت هي مصيبة هذه المنطقة من العالم ، و أن الاستعمار لم يكن سبب ضعفنا ، باحتلاله بلادنا ، لأنها كانت ضعيفة أصلاً مما سمح للآخرين بالتعدي عليها ، فضعفنا أصيل في بنيتنا الثقافية و كان هو سبب الاستعمار و ليس نتيجته . و من ثم يعيد هذا الفريق أزمة المسلمين إلى تمسكهم بتراثهم الذي تجمد و تجمدوا معه ، و هنا ينقسم هذا الفريق ( العلماني ) إلى موقفين: موقف يرى أن الخروج من الأزمة يتطلب التحرر التام و الانعتاق الكامل من سلطة التراث الإسلامي أو أي دين آخر، الذي يعوقنا عن التقدم و التكيف مع العصر . و موقف آخر يرى أن المأثور الإسلامي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا يستحيل إجراء قطيعة تامة معه ، لأنه هدف غير قابل للتحقيق بالمطلق ، لذلك فالحل يكون بإعادة قراءة هذا المأثور الهائل و إعادة تصنيفه و تبويبه ، و تجديد فهم النصوص بما يتلاءم مع مصالح البلاد و العباد و ظروف العصر و مقتضياته ، و صاحب هذا القلم يعتبر نفسه ضمن أصحاب هذا الموقف الثاني من التيار العلماني ، و يرى وجوب أن يتم هذا التجديد أو القراءة الجديدة بما لا يصدم الإيمان الإسلامي ، و دون الدخول في صراع طائفي مذهبي بين القراءات ، أي تقديم قراءة تصالحية سلامية للمسلمين قادرة على مواكبة المستحدث في عالمنا الدؤوب تغيراً و تبدلاً ، مع الطموح إلى أن تحوز هذه القراءة رضا المسلمين و أيضاً رضا غير المسلمين ، ومهمة بهذا الشكل تبدو عسيرة بل ربما مستحيلة ، لكنا سنحاول تجاوز هذه الاستحالة في هذه المجموعة من الدراسات مستعينين بحب جارف لهذا الوطن و للناس في هذا الوطن ، و إيماناً غير مشوب بقدرة الإسلام و المسلمين على تجاوز كبوتهم التاريخية . لأن أزمة المجتمعات الإسلامية تنهض على واقع مختل، تحزبت فيه المجتمعات الإسلامية لدينها و تراثها، بينما هذا التراث تحديداً ما عاد يتجدد أو يتبدل كما كان في حياة صاحب الدعوة عندما كان الوحي يستجيب للمتغيرات، فكان الله في حياة صاحب الدعوة يتفاعل بوحيه جدلاً أخذاً و عطاء مع حركة الواقع المتغير، فكان يُُنسى آيات و يُبدل أخرى و يرفع و ينسخ و يمحو ويثبت آيات غير آيات، و يتطور مراعياً وقائع الأرض و ظروفها المادية البحت . و بوفاة صاحب الدعوة وتوقف علاقة السماء بالأرض ، تجمد المسلمون عند آخر نص في تطور الأحكام ليعتبروه حكماً نهائياً صالحاً لكل زمان و مكان ، بينما هو في حقيقة الأمر ـ ودون أي تجن ـ خارج المكان و الزمان ، و الرؤية الوحيدة القادرة على جعله صالحاً لكل زمان و مكان ، تنبع من داخل الإسلام و من ميكانيزمات تكون الوحي خلال تلقي النبي له ، فالدرس و الأغراض النهائية فيه ، هو إثبات مبدأ التغير و التطور مع كل جديد ، و ليس الوقوف عند آخر تطور حدث في حياة صاحب الدعوة ، لأن التطور و التغير هو قانون الكون الأوحد الثابت .
و الخطورة اليوم ليست على دين الإسلام، فالدين ، أي دين ، لا يموت و لا يندثر لأنه فكرة ، لأنه ثقافة ، فلازالت الجميلة بين الآلهة الرافدية (عشتروت) تحاط بالرعاية و التكريم في كل ثقافات العالم و في كل متاحف الدنيا ، يحيط بها عشاق من كبار العقول الأركيولوجية و فلاسفة التاريخ و الأديان ، مثلها (إيزيس) المصرية ، مثلها (أدونيس) الفينيقي ، و (البعل) الشامي ، مثلها قصة الخلق المصرية ، و البابلية ، و ملحمة جلجامش ، وحكايات ملقارت ، و ملحمة الطوفان البابلي ، كلها محل احترام لم تفن ولم تزل من التاريخ ، بل وجدت عشاقاً من لون آخر و نوع آخر ، و من انتهى من التاريخ هم البشر من أتباعها و عبادها . الخطورة ليست إذن على دين المسلمين ، فالدين له صاحب كفيل به ، الخطورة الحقيقية هي على المسلمين من الزوال الوجودي من عالم البشرية بالاندثار التام ، بعد أن غابوا عن هذا الوجود كفكرة و فعل و عطاء ، و غرقوا في مستنقعات الجهل والخرافة و التخلف و الجمود و الاستبداد و الانحطاط الخلقي و الإنساني ، رغم أن المسلمين يشكلون حوالي خمس البشرية على الأرض . هنا الذعر الحقيقي أن تطول الأزمة بالمسلمين فيغيبوا وجوداً كما غابوا حضوراً ثقافياً، و هم حسب ما نعتقد المكلفون بالشهادة على الناس، باعتبارهم أمة وسطا حسبما أخبر القرآن الكريم ، بينما هم ما عادوا أمة وسطا و لا طرفاً ، و لا هم أمة أصلاً بحالهم هذا ، و لو قلنا تجاوزاً إنهم أمة ، فهم أمة مريضة تصدر أمراضها كراهية و إرهاباً للعالمين .
و ينعي المسلمون على الغرب الكافر تحلله الأخلاقي و عريه و حرياته اللا محدودة ، و يعتقدون أن الأخلاق قاصرة على الإسلام و المسلمين ، و أنها الشيء الوحيد تقريباً الذي تملكه لذلك تعتز به و تنافح عنه و تباهي به الدنيا ، رغم أن الصحوة الإسلامية أثبتت عدم امتلاكها حتى هذا الجزء المعنوي الذي تتباهى به ، فأسقطت جميع القيم الأخلاقية دفعة واحدة ، فصار الكذب مباحاً بعقيدة ( التقية ) ، و أموال البنوك مستباحة لأنها ربوية، وأموال غير المسلمين غنيمة مستباحة لأنهم محاربون شاؤوا أم أبوا وسواء كان ذلك موافقاً فعلاً لشرع الله أو غير موافق ، هذا ناهيك عن فقه كامل يكرس الاغتصاب بملك اليمين يتم تدريسه حتى اليوم في الفقه على المذاهب الأربعة في مدارسنا الدينية . من الأزهر إلى طالبان، ناهيك عن استمرار الشيعة في العمل بنكاح المتعة ، إضافة لمسيار القرضاوي ، و زواج الفرند عند الشيخ الزنداني، و العرفي ، و مفاخذة الرضيعة كما أفتى خميني . . . إلخ ، و لا تفهم معنى الزنا هنا بالمرة ، و لا أين هي الأخلاق التي يفاخر المسلمون بها العالمين .
المشكلة التي ستواجه الجديد هنا ، هو اعتقاد المسلم بعصمته ، و الكمال التام للتراث الإسلامي بكليته ، رغم أن التراث الإسلامي بوضعه الحالي قد اختلط فيه الإلهي بوجهة النظر الفقهية بالمذهب بالتأويل المناسب لعصر دون عصر ، بتقنين تشريعات على المذاهب المختلفة على ما بينها من اختلافات شديدة التباين و التناقض على أبسط الشؤون ، التي لا تحتمل رأيين أو تفسيرين ، كما في حال الحدود التي تفصل العقوبات البدنية مثلاً ، فقطع يد إنسان ليس شأناً بسيطاً حتى تختلف المذاهب السنية الأربعة حول مستوى القطع : هل هو من الأصابع أم من الكف أم من الكوع أم نخلعها من الكتف خلعاً ؟ و هي آراء المذاهب الأربعة في مستوى القطع ؟ ! ، ناهيك عن القصور الشديد في هذه الشريعة عن مواكبة الزمن ، و هذا قول لا يشين الشريعة و لا يقلل من قيمتها ، بل يعتبرها في كثير منها كانت صالحة لزمنها وحده ، و مما لا يتوافق مع زماننا كمثال واحد ، كانت الشريعة تعاقب بالقطع على السرقة إذا كان المسروق في حرز أي في مكان مغلق ، لكنها لا تعاقب بالقطع على سرقة السائبة ، فهي ليست سرقة تستحق القطع ، كالسوائم الهائمة في الطرقات أو في البراري، و بتطبيقه اليوم ستكون سرقة السيارة غير مستوجبة للقطع لأنها سائبة ، بينما ستكون سرقة الكاسيت الموجود بداخلها هي العقوبة التي تستحق القطع ، لأنه في حرز حسب شريعتنا . المهم أن ذلك إنما يعني استحالة تطبيق العقوبات البدنية بشكل نضمن فيه العدل التام و عدم ارتكاب الإثم في الحكم ، و هو ما يعني أيضاً أن الشريعة كما هي عليه الآن هي وضعية كأي قانون وضعي ، من وضع فقهاء لم يكن يأتيهم جبريل بالوحي .
و هكذا انحرف المسلمون عن الميزة التأسيسية للإسلام التي تخصه بالفرادة بين الأديان ، و هي الاعتقاد في مقدس واحد هو إله مطلق فوق الزمان و المكان ، فاعتقدوا في عصمة رجال مثلنا يصل عددهم إلى الآلاف ، فقدسوا الصحابة استناداً إلى حديث : “أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم” ، و تعريف الصحابي هو من رأى الرسول و لو ساعة ، أي ولو لحظة ، و بهذا يكون تعداد الصحابة المقدسين بالآلاف ، و هكذا استبدل المسلمون جاهلية ما قبل الإسلام ، بجاهلية أكثر نكاية و أشد ضرراً ، تفتك بعقل المسلمين فتكاً ، و عادوا وثنيين ، و أشد ضراوة في وثنيتهم من الوثنيات التقليدية في تاريخ الأديان . بينما الإسلام نفسه كان واضحاً غير ملتبس في قصر القدسية و العصمة على واحد في الوجود هو : الذات الإلهية ، و نعى الوثنيات والشركيات و الراكنين إلى ما وجدوا عليه آباءهم الأولين ، و خاطب مصطفاه بكل صفات العبد التام العبودية ، و أنه مجرد حامل للرسالة ليس أكثر ، فلا هو رب و لا هو ملك ، هو عبد من عباد الرحمن و نبي كريم ، أدى رسالة ربه تامة كاملة صافية بيضاء نقية ، بل خشي النبي ( ص ) من أي قدسية قد تلحقه شخصياً إذا ما حفظ المسلمون كلامه ( حديثه ) إلى جوار القرآن كلمة الله التامة ، لذلك نهى و أكد النهي عن تدوين حديثه و أمر بوضوح : “لا تكتبوا عني سوى القرآن” . و رغم ذلك سمح المسلمون بالتدوين عن نبي نهاهم عن التدوين ( وما نطق عن هوى ) بل و اختلاق الأحاديث المكذوبة ونسبتها إليه، بل وحازت تلك الأحاديث قدسية في المذهب السني ترفعها فوق القرآن كرامة و فعلاً و قدسية، فقالوا إنها تنسخ آيات القرآن ، كما في إصرارهم على وجوب الاستمرار بالعمل بحد رجم الزاني المحصن استناداً للحديث وحده دون وجود نص في القرآن بهذا الحكم ، و إن كان نصاً قرآنياً منسوخاً فالذي نسخه و ألغاه حتى اختفى من القرآن المدون ، هو صاحب القرآن ، رب العزة و الجلالة ، و ليس فقيهاً من الفقهاء ، “قاتلهم الله أنى يؤفكون”.
كل هذا الرتل مضاف إليه الزي المشيخي أصبح محل هيبة ورهبة و تقديس و عصمة و كمال مطلق ، حتى ألحق المسلمون القدسية بمن لا قدسية لهم من بشر كالصحابة مثل أبي بكر و عمر وعثمان وعلي وغيرهم ، أو كالمحدثين مثل البخاري ، أو الإخباريين كابن كثير ، حتى وصل التقديس إلى مشايخ وعاظ كالشعراوي مثلاً . فأصبحت تقام له المقامات و تعقد له الندوات و تصنع لتاريخه مسلسلات تعيد زمن المعجزات والألطاف الربانية، المفتراة على رب العزة.
ترى. . . هل أهان المسلمون ربهم. . . فأهانهم وخسف بهم فصاروا عبرة للأمم عندما تضل بها المسالك إلى المهالك ؟ هذا هو أول الغيث القاسي و بداية التشخيص الموجع ، في خريطة الطريق نحو الإصلاح .




