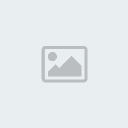
عرض العديد من الأصدقاء والكتّاب الرائعين جملة من الأفكار التي تتعلق بمفهوم المثقف ودوره، هذا الدور الإشكالي الذي مازال وسيبقى عرضة للنقد والتساؤل طالما وجد المثقف، لأن النقد حينذاك يصبح ضروريا لتطور مفهوم المثقف وتغيّر طبيعة دوره، وفق تغيّر الوسط الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يوجد فيه.
وعليه أناقش بعض الأفكار، التي طرحها الزملاء( صبر درويش وحواس محمود ونزيه كوثراني وإدريس شرود ورمضان عيسى) في عدد من النقاط التي نأمل أن تثير مزيدا من النقاش لتصويب الكثير من الرؤى والنقد، علنا نساهم كلنا في استعادة دور المثقف أو تصويبه أو نفي الحاجة له إن رأى البعض ذلك، وذلك في جدل مفتوح، ينطلق من معطيات الواقع أكثر مما ينطلق من يقينيات جامدة.
يقول صبر درويش في تعليقه على مقالي المعنون بـ لماذا فشل المثقف في التنبؤ بالثورات العربية“، المنشور في الأوان بتاريخ 29/9/2011:”تقول “في سوريا لو استلم أي حزب مكان حزب البعث..إلخ” أزعم أنه لا يصح الافتراض بالتاريخ، فهذه الحركة -الافتراض- تصبح أقرب إلى اللهو المعرفي وهو شيء لا يضفي معرفة بقدر ما يشوش عليها".
المسألة ليست مسألة لهو معرفي أبدا، أعرف أنه لا يجوز الافتراض على الواقع في شيء لم يحصل، ولكن هناك مقاربات نضعها أحيانا لنفهم أو لتدلنا على شيء لا نستطيع فهمه دون مثال. وأنا هنا سقت مثالي السابق لأؤكد على أن الاستبداد هو نتاج بنى ثقافية وفكرية مترسخة ساعدته على فرض هيمنته وعبدت الدرب أمامه، أي ما نسميه بلغة الفكر “آليات منتجة للاستبداد”، وقد ساهمت بها تلك الإيديولوجيات التي تحمل شيئا من هذا، حين تحتكر الحقيقة المطلقة، فهذه الأحزاب/ الأيديولوجيات تربت في ظلها جماهير كثيرة تؤمن بما لقنتها إياه، لأنها خلقت فضاءا ثقافيا أحاديا سينتج فضاءا اجتماعيا وثقافيا قابلا للاستبداد، أو ممهدا له.
بالعودة إلى تلك الفترة، لن تجد في منشور عربي واحد أو كتاب أو مجلة مرموقة، شيئا يتحدث عن الديمقراطية أو المواطنة أو حقوق الإنسان، ستجد مفهوم أهل الشورى عند الإسلاميين والنخبة أو الانتلجنسيا عند الشيوعيين والطبقة الثورية أو الطليعة الثورية عند الأحزاب القومية وهلم جرا، وستجد مفاهيم “الانقلاب الثوري” والعنف الثوري" والكفاح المسلح وو.. وهذا خلق فضاءا ثقافيا ممهدا للقبول بالانقلابات، فهذه الانقلابات هي ابنة ثقافة الانقلاب والعنف الثوري والكفاح، لذا كانت تحظى بقبول ما في الوعي السائد آنذاك.
انطلاقا مما سبق، افترضت أنه لو وصل أي حزب من تلك الأحزاب التي تحمل عقائد شمولية متمركزة حول ذاتها، وتطرح فكرة أنها تمثل الخلاص الوحيد، ستكون النتيجة ذاتها. هل يمكن أن ننكر أن كل البلدان التي حكمت بهذا النمط من الأحزاب، تحولت إلى أنظمة استبداد( الاتحاد السوفياتي – رومانيا – التشيك – بلغاريا- سوريا- مصر- تونس) أو التي حكمت بأنظمة إسلامية في ظل مناخ شمولي ( السودان – حماس في غزة- أفغانستان)( هنا أقول أحزاب إسلامية حكمت في ظل نظام شمولي للتفريق بينها وبين أحزاب إسلامية حكمت في ظل نظام ديمقراطي، السودان وحماس وطالبان نموذجا للمثال الأول، وتركيا نموذج للمثال الثاني).
لماذا حدث ذلك؟ لأن ثمة بنى فكرية/ ثقافية، إضافة إلى العديد من العوامل، وبالتأكيد لا يمكن لهذا البعد وحده أن يفسر ظاهرة الاستبداد، ولكنه باعتقادي يمثل واحدا من أهم الآليات المنتجة للاستبداد.
وانطلاقا من ذلك سأفترض حاليا، أنه بعد ربيع الثورات العربية، لن يتمكن حزب واحد مهما بلغت شعبيته، من احتكار السلطة واغتصابها بالقوة، كائنا من كان هذا الحزب الذي استلم السلطة. لماذا؟ لأن الثقافة السائدة الآن في الواقع والشارع العربي، هي ثقافة مختلفة كليا، هي ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والمجتمع المدني، فيما كانت سابقا ثقافة الثورة والانقلاب والحقيقة المطلقة هي السائدة.
و يتساءل صبر قائلا: “محاولة الكاتب تفسير الظاهرة -دور المثقف- بالاستناد إلى المستوى الثقافي الذي هو نتيجة وليس سبب”. حقيقة لم أفهم ما المقصود تماما. لذا أتمنى إيضاح كيف فسرتُ الظاهرة استنادا إلى المستوى الثقافي فقط، وكيف يتحدد تفسير الظاهرة؟ ومن حدد ذلك؟ وكيف هي نتيجة وليس سببا؟
وأتساءل: كيف يكون تحليلي استنادا للمستوى الثقافي فقط، إذ كانت كل أطروحتي تتركز حول إهمال المثقف للواقع، وتمترسه خلف اليقين الثقافي المنعزل، بدل الانفتاح على الواقع؟
لكن هنا يهمني إيضاح نقطة، أنا في كل كتاباتي حاليا، أنطلق من الواقع وحده، أحاول استعادة ما أهمله المثقف، تاركا خلفي كل النظريات التي قرأتها واستفدت منها، أي جاعلا المقام الأول للواقع، متجاهلا كل البديهيات التي أرى أنها بدأت تضع سدا، أكثر مما تنير؟ ولهذا سيخطئ كل من يقرأ مقالاتي استنادا إلى ما يجوز وما لا يجوز؟
وهنا لي ملاحظة، أنه بالعودة إلى كل ما كتب عن مفهوم المثقف عربيا، سنجد دوما تلك الإحالات المرجعية إلى غرامشي وآلان تورين والمدرسة الماركسية..و..هي كلها أنتجها المثقف الغربي، بعد أن حاجج واقعه ومحيطه، فولد ما ولد من نظرية مضمخة بماء الواقع الغربي، لننقلها نحن إلى واقع شرقي مختلف، وهذا ما حدث مع كل منتجات الحضارة الغربية الصناعية والفكرية، حيث كان النقل، نسخا لا إبداعا، ليصبح “الناقل ناسخا”، بدل أن يكون “الناقل مبدعا”.
وهنا يبرز سؤال: أين نظرية المثقف العربي عن ذاته، وعن طبيعة دوره، لماذا لم يتمكن من إنتاج نظرية أو رؤية ثقافية؟
سؤال كلنا مدعوون للبحث فيه، وربما ابتعاد المثقف عن الواقع واكتفاؤه بالنظرية، يمثل مدخلا للبحث عن إجابة.
العلاقة بين الثقافة والسياسة:
يكتب وجيه كوثراني في انتقاده لي:“يرى الكاتب استسلام وانتهازية تلك الأحزاب والقوى التي تسمي نفسها معارضة كتعبير عن انهيار المثقف والمشاريع الثقافية التي يمكن أن تجابه وتفكك الاستبداد فهو يطلب بالاستقلال النقدي للمثقف دون أن يسعى إليه في تحليله لجدل الثقافي في ارتباطه بالسياسي في إطار من الاستقلال النسبي الذي لا يعني الحقد والعداء للسياسة كما تبلور عبر التاريخ العربي المعاصر وسط مجموعة من المثقفين الذين استقالوا من السياسة، وصار كل همهم كاستلاب ثقافي سياسي تسلطي نشر الجفاف والفقر السياسي داخل المجتمع، وإبعاده من دائرة الحركة التاريخية في التطور والصيرورة وحسموا بذلك أمرهم في التفكير بالشعب والجماهير كقوى فاعلة ودينامية لإحداث التغيير وتقرير وصناعة المصير. فقدم هؤلاء بممارساتهم تلك خدمة جليلة لبنية المستبد العربي”.
لن أقول إلا أنني أوافقك تماما فيما ذهبت إليه، ولا أعرف كيف سقت الأمر كانتقاد، رغم اتفاقي معك بالكامل، إلا إن كنت فهمت أن دعوتي للفصل بين السياسي والثقافي، تعني استقالة المثقف من اهتماه بالشأن العام ونقده السياسة بشكل يومي.
وهنا أضيف، أن المثقف بعد أن كرس الاستبداد هيمنته ابتعد كليا عن الاهتمام بالشأن العام و السياسة حتى من بابها الضيق، مما سهل للاستبداد هيمنته، عبر ترك كل المساحات التي كان يشغلها لمثقفي الاستبداد الذين يعملون كلاب حراسة، تحت ذريعة القطيعة المطلقة بين السياسي والثقافي، تحت حجة حفاظ المثقف على استقلاله ونزاهته.
نعم على المثقف الابتعاد عن السياسي بمعناه المباشر، ولكن ليس عن الاهتمام بالشأن العام ونقد السياسة، وهكذا أصبح ذلك ذريعة للمثقف للابتعاد عن الشأن العام، آثراً الوقوف في منتصف الدائرة، بدل الوقوف على طرف الدائرة، محاولا توسيعها قدر الإمكان، وهذا ماساهم في إبعاد المثقف عن القاع، لأنه تخلى أساسا، عن صلة الوصل بينهما، تاركا إياها للسلطة، بدل المقاومة قدر الإمكان للحفاظ عليها.
هكذا سنجد مثقفا سوريا لامعا كأدونيس، لم يكرس شيئا من وقته للكتابة حول الشأن السوري بشكل تفصيلي، بل يكتفي بإشارات رمزية عابرة، وفق مواسم السياسة التي تتيح له ذلك، منعزلا للعمل في غيتو ثقافته التي تعزله أكثر مما تفتح فضاءاته للرأي العام. ولعل أبلغ جواب يمكن أن يرد على رفضه الخروج في مظاهرة تخرج من الجامع، هو: تعال وأنت المثقف اللامع والمعروف، ادع لمظاهرة تخرج من أي مركز ثقافي لنتبعك، وهكذا يشكل اسمك العالمي مظلة لنا، وتساهم في إزالة وشم السلفية الذي عملت السلطة على وسم الانتفاضة به؟
ولنا هنا أن نقارن بين موقف أدونيس المنكفئ، وبين موقف سارتر الذي كان في قلب ثورة الطلاب التي اندلعت في فرنسا؟
آفاق مفتوحة:
ما يحصل الآن عربيا، ساهم ويساهم في كسر ( إن لم نقل إلغاء) كل الحواجز التي كانت تقف في طريق المثقف، فها هو الاستبداد وثقافة السجن والإقصاء تلغى بفعل تآكل السلطات المستبدة وانتشار ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى انفتاح الفضاء الأنترنتيي بحيث يستطيع المثقف إيصال فكرته بعيدا عن رقابة السلطة، إضافة إلى عدم قدرة السلطات على محاصرة المثقف بلقمة عيشه، إذ بات بإمكانه أن يعمل وهو في منزله، ويصله ثمن أتعابه إلى حسابه البنكي أينما سكن، وحتى لو كانت السلطات مستبدة، بقليل من التحايل على السلطة يمكن حل الأمر.
والأهم أن وسائل الاتصال، سهلت عليه التواصل مع قرائه، ومع القاع الاجتماعي، ولم يعد أحد قادرا على عزله، بعد أن كانت السلطات قادرة على عزله ومنع أفكاره من الوصول إلى الجماهير.
لذا نحن أمام فرصة حقيقية، لاستعادة دور المثقف الحقيقي، ولكن علينا أولا أن نحدد من هو المثقف حقا؟ وما طبيعة دوره؟ خاصة بعد انتشار الديمقراطية وتهافت الدكتاتوريات العربية؟
و ما الذي سيتغير بهذا الدور؟
وهنا، يمكن القول أنه أمام المثقف العربي، الكثير من الإيديولوجيات الشمولية التي عليه تفكيكها بعد أن ينتهي من تفكيك بنى الاستبداد، ألا وهو العمل على الثقافة العربية ومناهج التدريس والبنى الدينية المغلقة التي ستحاول استثمار الثورات العربية و مصادرة كل شيء، وهي بدأت بالفعل، مدعومة بقوى نفطية هائلة وجيش إعلامي جرار، وقوى غربية تسعى لاستبدال السلطات المستبدة بنموذج إسلامي، ليس بالضرورة أن يكون ديمقراطيا.
ويضاف لذلك، مراقبة تلك السلطات التي تتشكل من جديد، ونقدها بلا هوادة، والبحث في أسباب تعثر الثورات التي لم تنجح حتى الآن، ليعلن رأيه بصراحة بعيدا عن الخوف من “استبدادي الثورات” الذين يحاولون، كم الأفواه، ( سواء عن حسن نية أو سوئها)، وذلك باسم الثورة! بعد أن كانت الانقلابات العربية تحكمنا باسم الشعب!
وربما من هنا، يبدأ عمله الراهن.




