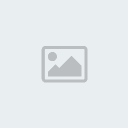
( 1 )
لهذه المحاولة رسالة هي إعادة الاعتبار إلى اللحظة الصوفية في الإسلام. وأنا أعلن سلفا أن هذه الإضاءة للتصوّف لم تكن غير انتقائية، بل لقد أهملت عامدة متعمّدة الجزء الأكثر بهرجة منه، أقصد أكثر ممارسات الفرق الصوفية بكرامات أوليائها وخزعبلات مشعوذيها...الخ، لتركّز على الجانب المعرفي من التصوّف، انطلاقا من الاعتقاد بأن هذا الجانب هو الجوهر الباقي منه بعد أن يتجاوز الزمن تلك الجوانب الممارساتية التي تنتمي كليّا إلى تقاليد ماض لم يعد يمتلك أية قدرة على مقاومة الحداثة، ويطوّر بعضها الآخر لتناسب عقلية أهل هذا العصر.
ولعل إضاءة هذه اللحظة الصوفية في الإسلام لا باعتبارها إحدى لحظاته فحسب، بل محطّته الروحية الكبرى، هو مهمّة لم يعد يمكن القعود عنها. لقد انقضى الزمان الذي كان يتجاور فيه التصوّف مع العلوم النقلية في أروقة الأزهر، بحيث يجد طالب العلم لا ما يحشو به عقله فحسب، بل ما يدفئ به روحه، ويملأ قلبه بالحب أيضا. فالآن يهيمن النقل على كل من العقل والقلب معا، بعد أن عاش ثلاثتهم صداقة بدأت منذ عهد الغزالي على الأقل.
إننا نعيش أياما اختصر فيها الدين إلى محاكم وقضاة، خارج نفوسنا وداخلها. وتحوّل رجاله إلى شرطة تقرر للناس كيف تأكل وتشرب، تنام وتقوم، تحب وتكره، تحكم وتُحْكَم...الخ. وما كان كذلك، لكننا قوم سريعو النسيان.
إنني أدعي أن التصوّف يتضمّن الأساس النظري لكل ما هو جوهري في أي دين على ظهر البسيطة. فمثلا الجوهري في الدين الذي يفرّقه عن الفلسفة هو أنه يركّز على عاطفية الإيمان والمعرفة الإيمانية، في حين تفهم الفلسفة نفسها على أنها عمل العقل المجرّد عن أي عاطفة. بل والذي يجعل العاطفة التي قد يحس بها هي نفسها موضوعا للرصد والتحليل، إن لم تكن عاملا من عوامل “خطأ القياس” بسبب تأثيرها على موضوعية البحث. والجوهري في الدين الذي يفرّقه عن السياسة هو التركيز على فردانية التجربة الدينية. في حين لا تهتم السياسة إلا بشؤون المجموعة وأشكال سلطتها وتنظيمها ...وعلى هذا المنوال يمكن لنا نفرّق الدين عن الفن بأن الأول يدفع الروح إلى علاقة بآخر (المقدّس)، بينما الثاني يجعل الروح تخرج هي بنفسها إلى العلن، وإن كانت تتلبّس أشكالا أو ألوانا أو حركات أو أصواتا ونغمات. فإذا كان المطلق في الدين يستتر في الإنسان، فإنه في الفن ينبثق -بتعبير هيغل- من خلال أقنعة الحسي، وهكذا..إن هذا النسق من التفكير يصل بنا إلى أن جوهر الدين هو “حركة الروح في نزوعها إلى التواصل مع المقدس”، وليس ذلك شيئا آخر غير ما قاله وفعله المتصوّفة الحقيقيّون، بتركيزهم على أن هدف المتصوّف هو الاتصال والوصول والوصال..الخ. غير أن هذا يعني أيضا أن التصوف يحتوي ـ في جوهره ـ الجوهري في الدين بما أنه كذلك. وستكون النتيجة المباشرة لهذا الاستنتاج هي أنه سيحتوي أيضا –واعيا لذلك أم غير واع- الجوهري في كافة الأديان، لا في الإسلام فحسب.
لكن هذا لا يمكن أن يبرز واضحا ما لم نقم بعملية “تنقية” للتصوّف من “شوائب” لا تنتمي لعالم الروح من قريب أو بعيد. إنها انتقائية قصدية، وهي عيب علمي لا شك فيه، ولعل عذره الوحيد هو الرجاء بأن يكون “الراسب” بعد هذه التنقية المضنية ذهبا صافيا لا خلائط جديدة-قديمة.
ولكن لعل الباحث في التصوّف لا يمكن إلا أن يكون انتقائيا ، ليس فقط لأنه بشر وما كان للبشر إلا أن يكونوا انتقائيين، ولكن لأن المتصوفة أنفسهم كانوا يحيّرون بانتقائيتهم ربما بسبب مبدأ التقية الشهير، أو لأسباب أخرى خاصة بتجربتهم ذاتها. وبالمناسبة فمبدأ التقية المذكور لم يقتصر تطبيقه في يوم من الأيام على صائغيه أقصد منظّري الشيعة. فيكاد يكون كل من يسكن ديار الاستبداد “تقويّا”. غير أن انتقائية المتصوّفة تستند إلى سبب آخر غير الخوف الذي يكمن في أساس التقية. إنه “مخاطبة الناس على قدر عقولهم”، مما يستدعي “انتقاء” ما يناسب “العامة” وترك ما لا تستطيع فهمه للخاصّة. أخيرا فإن انتقائية الباحث -التي هي بحد ذاتها خطأ علمي لا شك فيه كما اعترفنا أعلاه- ليست بلا مبررات منطقية يمكن تلخيصها بحجتين. الحجة الأولى ترتكز على حقيقة وجود خطابين صوفيين أحدهما للخاصة والآخر للعامة، وهو ما ورد آنفا وما صرّح به أكثرهم. إن حقيقة وجود خطابين لتيّار فكري واحد تجعل من البحث في المشترك بينهما مهمّة شبه مستحيلة، ما لم ينطلق الباحث من فكرة موجّهة تفيد بأن جزءا من مادّة بحثه (أقوال المتصوّفة وأعمالهم) ليس إلا تشويشا على الجزء الآخر الذي يشكّل “الدال” الأكثر أصالة على جوهر الخطاب. أما الحجة الثانية فتستند إلى حقيقة الخلط الكبير في أقوال “الخاصة” نفسها، التي لا يمكن إلا أن تعني أن الثيولوجيا الصوفية تطوّرت مع الزمن وخلال مراحل تطوّرها تلك كانت تتبلور تارة في جوهر خالص لتعود تارة أخرى إلى “سبائك” فكرية يختلط فيها الباطن بالظاهر والحقيقة بالشريعة. ولهذا فلابد على من يهمّه استجلاء ذلك الجوهر أن يحاول تنقية “العناصر الدخيلة” في السبيكة الفكرية، وهو نوع من الانتقاء الإجباري. على من يقوم به أن يعتبره “خطأ قياس” في التجربة البحثية، وهي استعارة مأخوذة من طرق البحث في العلوم الطبيعية كما هو معروف.
( 2 )
ولقد نسي الكثيرون أن تاريخ الإسلام الواقعي هو تاريخ التصوف أكثر مما هو تاريخ الشريعة، إذا اعتمدنا المقياس الكمي على الأقل. فالمتصوفة بنوعيهم (الصوفية الخالصة المتنسكّة التي اعتزل أهلها الحياة وهاموا بحب من يهوون، و“الصوفية الواقعية” التي كان أهلها أعمدة الحرف في المدن الكبرى) سادوا المشهد الديني في العالم الإسلامي طوال معظم تاريخه، جنبا إلى جنب مع الفقهاء، بل كان بعضهم في كثير من الأحيان فقيها ومتصوفا في الآن ذاته[2]. بل إنه يبدو لي أن التصوف كاد أن يشكّل طوال قرون أحد المذهبين الأساسيين لعامة المسلمين، أي إن أحدهم كان شاذليا ومالكيا، والآخر كان نقشبنديا وحنبليا مثلا، ناهيك عن الشيعة الذين كادوا أن يدخلوا التصوّف في أصل مذهبهم نفسه. بل إن ذوي النفوس الطموحة منهم لم يكتف بأخذ طريقة واحدة. فقد جاء في ترجمة للأمير عبد القادر الجزائري مثلا إنه أخذ الطريقة النقشبندية في دمشق عن الشيخ خالد المجدوي، ثم الطريقة القادرية على السيد محمود الكيلاني. كما إنه أخذ فيما بعد الطريقة الشاذلية عن الشيخ محمد الفاسي وكان ذلك في مكة، وأخيرا أخذ الطريقة المولوية على الدرويش صبري شيخ الطريقة في الشام. وكان الأمير مالكي المذهب[3]، كأغلب أهل المغرب. وجاء في ترجمة الإمام محمد عبده إنه اتصل بالشيخ درويش خضر، الشاذلي الطريقة، الذي ترك في نفسه أثرا وصفه كما يلي: “رأيتني أطير بنفسي في عالم آخر غير العالم الذي كنت أعهده، واتسع لي ما كان ضيقا، وعظم عندي من أمر العرفان والنوع بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيرا..الخ”[4]. بل حتى إن ذهاب الشاب محمد عبده إلى الأزهر لطلب العلم جاء بإلهام من أحد مجاذيب طنطا! كما يحدث هو نفسه. في رواية أحمد تيمور التي نقلنا منها الاستشهاد السابق. ولعلّ من المفيد أن يطّلع القارئ على الطريقة التي تجاور فيها علم الشريعة بعلم التصوف في أزهر تلك الأيام. يقول الكاتب: “هذا وكان في الأزهر نفسه تدافع بين الشرعيين والصوفيّة، فأولئك كانوا يرون في الخروج عن العلوم النقلية المتداولة في الأزهر تمردا على الدين، وهؤلاء كانوا يطمحون إلى أنواع من المعارف التي لها مساس بالتصوّف. ودليل هذا التدافع ما ذكره الصوفي الأزهري الشيخ حسن رضوان المتوفى سنة 1310هـ، 1892 م في منظومته المسماة”روض القلوب المستطاب“. وقد كان للشيخ المذكور مريدون بين علماء الأزهر وطلابه، منهم الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد البسيوني وهما من أساتذة الشيخ محمد عبده نفسه، وجماعة من إخوانه. وبذلك يظهر أن الشيخ حينما جاء إلى الأزهر انضم إلى حزب التصوّف، وهو أقل الحزبين جمودا، وأقلهما نفرة من الجديد”[5]
( 3 )
هذا الدور الكبير للتصوّف في الحياة الاجتماعية والعلمية لذلك الزمان أعطاه سلطة جعلت القضاء عليه مستحيلا دون عنف السلطة السياسية. وهكذا كان. فقد ووجه التصوّف في القرن المنصرم بحملات ممن هب ودب. لقد شاركت في محاولة القضاء عليه سلطتان لم يكن يجمع بينهما أي شيء على الإطلاق، إذا استثنينا معاداة الصوفية. هاتان الفرقتان-السلطتان هما الوهابية والأتاتوركية. وكلاهما بحجة الإصلاح. الوهابيون أرادوا إصلاح الدين بغربلته من البدع، وكمال أتاتورك[6] أراد إصلاح المجتمع بالتحديث على الطريقة الأوربية. كانت النتيجة نوعا من “الإصلاح الديني المعكوس” الذي ما زلنا نرى أثره في الأشكال المشوّهة من الدين والتي هي شيء شاذ بكل المعاني.
ورغم أن الفرق الصوفية كانت بممارساتها تعطي هؤلاء “المجدّدين” حججا قوية للهجوم عليها. فمما لا شك فيه أن التصوّف تحوّل في كثير من الحالات إلى فرق مشعوذة أصبح التخلّص منها ضرورة تاريخية، لكن هذا التبرير المعقول لم يكن للأسف هو الدافع الأساسي وراء الحرب الوهّابية على التصوّف ولا وراء تلك الأتاتوركية. الأولى استندت كالعادة إلى حرفية النصوص (وليس التصوف هو ضحيتها الوحيدة في ذلك)، والثانية إلى اتجاه عام ناجم عن ضغط تحديات التغيير التي كادت تلغي شرعية أي شكل ديني موروث عن الحقبة العثمانية وخاصة إذا كان يشجع على ترك أمور الدنيا أو حتى يتسامح مع ذلك. هذا إن لم نتحدّث عن الاستلابات التغريبية لدى أتاتورك[7].
( 4 )
إن حيثيات الهجوم الوهّابي والأتاتوركي على الصوفية يشيران بطريقة ما إلى نوع من الديالكتيك التاريخي للتصوّف الذي حتّم انقشاع سيادته عن الشارع الإسلامي والذي في الوقت نفسه يعطيه كل المشروعية ليعود إلى طبع الدين بصبغته الخاصة. فالجانب الاجتماعي الحياتي المادي الملموس للتصوّف كما عاشه المجتمع الإسلامي حتى القرن التاسع عشر لم يعد بأكثره قابلا على مقاومة التطوّر. إنه الجزء الميّت من التصوف[8]. لكن تلك النزعة التي تركّز على التجربة الشخصية في الممارسة الروحية وتعطيها أولوية على الالتزام الحرفي بالنص المقدّس، هذه الروحية هي الجزء الحيّ من التصوّف ورسالته الباقية.
قلنا إن قضية التصوّف الأساسية هي قضية الروح. وهو بهذا يعيد الدين إلى حقل عمله الأساسي. ولئن اضطرّ الدين خلال تاريخه الطويل إلى الانشغال بمسائل الحياة المادّية لأن الناس كانوا يلجؤون إلى مقدّسيهم في كل ما يستجد عليهم من مشكلات ماديّة وعقليّة تتطلّب حلا، فإن ذلك لا يعني أن هذه هي وظيفة الدين الأزلية. والدارس لتاريخ الأديان يلاحظ ميلها (بقصد أو بغير قصد، راغبة أو راغمة) إلى التخلّي المضطرد عن وظيفة القيادة في شؤون الحياة. بل إن الرسول قد قال في حديث شهير: “انتم أعلم بأمور دنياكم”، وهذا يعني شيئا واحدا هو توزيع الاختصاصات، للدين شؤون الروح وللناس شؤون الحياة. وفي هذه الدراسة أسمّي الدور الذي لعبه التصوّف في هذا الصدد: القطيعة الروحية. ويقصد باستخدام كلمة قطيعة عادة الإشارة إلى أن استمرارية ما تم قطعها. مما لا يعني بالضرورة أنه قد تم القطع مع كل ما كانت تلك الاستمرارية تشمله من مضامين، فأنا أعلم أن الواقع التاريخي مخالف لذلك تماما، ولكن موضوع الخطاب قد تبدّل جذريا. أترجم هذا في الحالة الإسلامية بانتقال موضوع الخطاب الديني من ممارسة الكائن الإنساني الشامل إلى ممارسة الروح.
( 5 )
لعل في بحث الناس عن أصل غير إسلامي لأجزاء من الثيولوجيا الصوفية أو للمشترك بين تلك الثيولوجيا وغيرها من أديان الأرض ـ وهو بحث مبرر ومثمر بل وما زال ناقصا، إذ مازالت كنوز البوذية شبه مجهولة للباحث العربي ولغيره إلى حد كبيرـ وفيما توصّل إليه أولئك الباحثون دليل على عالمية الفكرة التي تكمن في جوهر التصوّف وقابليّتها للدخول في قلب كل من يحتاج إلى التديّن. وهذا يمكن إيجاد مئات الأمثلة عليه، بل إنني لمسته شخصيا لدى كثير من الأوربيين الباحثين عن حياة روحية تغني نزعاتهم الماورائية. غير إنه ربما ليس من نافل القول الإشارة هنا إلى شيء من “التوصية” أو حتى النصيحة لأولئك الذين تهمّهم عالمية الإسلام أن يتوقفوا عند هذه الفكرة قليلا، فقد تكون فعلا الفرصة الثمينة لإعادة الوجه الحضاري العالمي لهذا الدين.
غير أن الجذور النظرية والممارساتية المشتركة بين التصوّف والنزعات الروحية في أديان أخرى كثيرة لا تعني على الإطلاق أن التصوّف هو شيء وافد وغريب على الإسلام. لا يمكن لباحث واحد أن يشك بحقيقة أن المتصوّفة كانوا يستندون في كل ما يقولون تقريبا إما إلى آية قرآنية أو إلى حديث نبوي. صحيح إنهم استندوا في فهمهم للآيات والأحاديث إلى نظام تأويلي مختلف عن نظام الفقهاء الرسميين، وصحيح أيضا إن كثيرا من الأحاديث التي استندوا إليها قد تكون موضوعة أو ضعيفة الإسناد، و هذا لا يخرجهم من دائرة الإسلام. لنقل إنها مدرسة مجتهدة! ديدنها في ذلك ديدن فرق اجتهاد أخرى لا تعد ولا تحصى في التاريخ الإسلامي. ولا أجد سببا يمنع من اعتبار هذه الفرق كلّها التي نجمت عن الخلاف بين الفقهاء والمفسّرين والذي يخفي خلفه خلافا بين السياسيين وذوي المصالح نوعا من “ألف زهرة متفتّحة” –حسب التعبير الصيني- تمنح حدائق الإسلام غنى في اللون والرائحة والشكل الجمالي كان سيفتقر إليه لو لجأنا إلى اعتبار كل من لم يلتزم بالتفسير الرسمي الوحيد (هذا إذا وجد تفسير رسمي وحيد) مارقا مكانه الطبيعي بين السيف والنطع أو في غياهب السجون.
وهكذا يمكن للباحث أن يجد في التصوف كلا الأمرين، العالمية والإسلامية، عالمية الروح وإسلامية المرجعية.
( 6 )
وكما ألمحت أعلاه، فإن إحدى الميزات الأساسية للممارسة الدينية لدى المتصوّفة هي ميّزة الاتصال المباشر بالمقدس، وذلك بالتفريق عن تلك التيّارات الدينية التي “توسّط” في هذه العلاقة. غير أن هذه الميّزة ظلّت للأسف ممارسة تكاد تكون استثنائية تقتصر على “الواصلين”. فأكثرية “السالكين” وسّطت “شيوخها” في اتصالها بالمقدس[9]. غير أن وجود ممارسة الاتصال المباشر وتنظيرها بل وتحوّلها إلى ممارسة أنموذجية وهدف لكل ممارسة صوفية يكفي لاعتبارها فتحا حقيقيا جديرا لا فقط بالدراسة، ولكن بان يحتل مكانا دالا في النظرية الصوفيّة. ولعل من أهم نتائج هذه العلاقة المباشرة بالمقدّس فتح الطريق من أوسع أبوابها لأن يصبح الدين شأنا فرديا بالكامل. إذ أن الروح تتصل وحيدة مفردة بمعشوقها المقدّس لا تشرك في حبّها هذا ولا في أسرار اتصالها أحدا. تماما كما لا يرضى أي عاشق ان يشرك في أسرار اتصاله بمحبوبه أحدا، ناهيك عن أن يسمح لأحد بأن يقرر طرق اتصاله بالحبيب.
وفردانية الدين هي -على ما يبدو من استعراض تطوّر البشرية- المحطّة الأخيرة لتطوّره في تلاؤمه مع تطوّر المجتمعات التي يرعى شؤونها الروحية. والحالة الإسلامية مازال أمامها الكثير لتنجز هذه المرحلة. وأنا أكتب الآن في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، حيث تكاد تطغى على العقول في العالم الإسلامي نزعة تبدو قهرية إلى خلط الدين بكل شيء وفرضه على كل أشكال التجمّع. بل إلى درجة أن المتعصّبين من أتباع الديانات الأخرى بدؤوا – سواء بسبب العدوى أو المنافسة أو انتهاز فرصة الذعر العام الذي ينتج عادة نوعا من الغباء العام- يحاولون إعادة عجلة التطوّر في بلادهم إلى الوراء ليعيد الدين احتلال مواقع في النظام الاجتماعي كان قد فقدها منذ زمن طويل. فكون الدين شأنا فرديا وفصله عن السياسة وشؤون الدولة هو أمر أنجزته الكثير من شعوب الأرض منذ قرون. أي إن المتعصّبين من المسلمين بجرهم الشعوب الأخرى إلى تبنّي الدين كهوية اجتماعية وسياسية يلعبون بهذا دورا رجعيا على الصعيد العالمي.
( 7 )
وباعتبار أن طبيعة هذه العلاقة المباشرة بين المتدين والمقدس عند المتصوّفة هي الحب فلا بد أن نتصدّى لشرح هذه العاطفة وتحديد لا فقط مكانتها في الثيولوجيا الصوفية، بل وما تؤدي إليه هذه المكانة من توصيف ابستمولوجي جديد لطريق المعرفة الصوفي، حيث لا الإيمان ولا العقل هو الأساس الابستمولوجي للدين، بل العاطفة. ومن شأن هذه الأطروحة -إن ثبتت صحّتها- أن تعيد موضعة الدين في الخريطة الكوغنوطيقية (وليسمح لي القارئ باستعمال هذا المصطلح الذي يعني كل ما يتعلّق بالعمليات العقلية للجنس البشري) للبشر. قارن مثلا تلك الموضعة لدى كل من أوغست كومت وسيغموند فرويد. فمن المعروف أن الدين لدى الأول هو المرحلة الأقدم على الطريق الذي اتبعه البشر للوصول إلى حقائق، وهو طريق كانت مرحلته الأخيرة العلم الوضعي. كومت ينطلق من مسلمة ثبت في رأيي المتواضع خطؤها وهي أن التديّن يتبع طريقا ابستملوجيا عقليا محضا. ولو كان الأمر كذلك لاختفى الدين مع اقتناع الناس باكتشافات غاليليه ومن جاء بعده. أما بالنسبة لفرويد فتاريخ الدين لديه هو تاريخ عقدة أوديب الجمعية بما يرتبط بها من قتل الأب ثم تقديسه. وكان من شأن ذلك أن ينتهي بالمحللين النفسيين إلى نفي وجود الدين في المرحلة الما قبل أوديبية للجنس البشري (تكمن في قاعدة هذه الفرضية فكرة ان تطور المجتمعات يشبه تطور الأفراد)، وزواله لدى وعي العقدة الأوديبية وحلها.
ولعل مفهوم العاطفة نفسه يحتاج إلى توضيح ، وخاصة تلك التخوم التي تحدد الفرق بينه وبين “الشيء العاطفي” الذي يكمن في أساس الحياة الانفعالية الدافعية التي هي بنفسها ينبغي أن تكون مادة العمليات النفسية المؤدية في نهاية المطاف إلى قتل الأب ثم تقديسه وطقوس الطوطم وفرض التابوات المختلفة وكل هذا ينبغي أن يكون في أساس ظهور الأديان.
في بعض الفقرات من كتب فرويد يؤكد الرجل أن الحب لا يعرف حدودا وأن تلك الطاقة “أي اللبيدو” هي هي ما نرى آثار عملها في الحب الغريزي وحب الأم بل وحتى حب الأفكار المجرّدة..الخ. غير إنه لا يلبث ان يؤكد الصفة الجنسية لذلك “اللبيدو” العام وبكل أشكاله، وهنا بالذات يكمن الفرق الكبير بين ما نعنيه هنا بالعاطفة بشكلها الأكثر أهمية لموضوعنا أي الحب وما يعنيه التحليل الفرويدي. ومن المعروف من كثير من الدراسات أن فرويد كان من أشد اهتماماته العلمية إيجاد أساس فيزيولوجي للعمليات النفسية، ولا ننس إنه كان طبيبا في الأصل، أي إنه جاء إلى علم النفس من الباب الطبي والأطباء ينزعون بحكم المهنة إلى البحث في الجسد المادي عن أسباب كل ظواهر الحياة. كان ذلك على الأقل هو القاعدة في نهاية القرن التاسع العشر في أوربا، وهو الزمن الذي بدأ فيه فرويد أبحاثه النفسية.
ولكن ما هو الفرق الدقيق بين هاتين المقاربتين لعاطفة الحب؟ ولماذا لا يكون لكل أشكالها أساس واحد هو الأساس الغريزي؟
لا شك أن المقاربة الفرويدية شديدة الجاذبية بسبب بساطتها الشديدة والتي يبدو إنها كافية لتفسير كل شيء برزمة صغيرة من الفرضيات. لكن لعل هذا بالذات هو سبب عدم إقناعها ربما لأنها ترتدي بذلك ثوب الأيديولوجيا التي تصر على أنها صحيحة وقادرة، أو لأنها قادرة، على تفسير ظواهر الحياة كلها. ولكن هل سبب رفضي لها هو التجربة السيئة التي خاضتها البشرية منذ ذلك الزمن وحتى اليوم مع مختلف الأيديولوجيات؟ أم إن الأمر أبعد من ذلك؟
أعتقد أن تعقيد المسألة لا يتعلق بمفهوم اللبيدو فحسب، والذي هو مجرد فرضية طبعا لا يوجد عليها أي دليل مخبري أو تجريبي من أي نوع. إن المشكلة تكمن في طبيعة عاطفة الحب وخاصة بشكلها الديني والذي يجد ذروته في الحب الصوفي. إنه ظاهرة “انثروبولوجية” وهي بهذا المعنى ليست ظاهرة صراع نفسي فردي يجري على أرضية تعلّق إيروسي. الأمر يتعلق بفرد يريد أن يخرج من محدوديته المخيفة وذلك بالاتصال باللامحدود، وهذا بتعابير سلبية. إيجابيا يمكن للمرء ان يعبر عن تلك “العاطفة الانثرولوجية” بأننا أمام فرد يحس بعلاقة ما كعلاقة الاندماج مثلا أو الهجران أو إنه جزء من هذا الكل الكوني، وهو يؤنسن هذا الكل الكوني كما كان وما زال يجسّد أو يؤنسن أي شيء آخر، فيسمع صوته ويرى وجهه ويحس بعاطفته وإرادته..إنها إذن “الدافع الى الاتصال” وليس الحب ظاهراتيا إلا هذا الدافع السلوكي. لا شك أن لهذا الدافع العاطفي فوائد عملية كدفع الخوف مثلا، لأن الاتصال بالآخرين والإحساس بالوجود مع الجماعة الناجم عنه يؤدي إلى الشعور بالأمان. بل إن له وظائف اجتماعية نعرفها من خلال الدور الاجتماعي وحتى الاقتصادي للطقوس الدينية..الخ، وهذا كله معهود تماما في كل ما يدرسه الانثروبولوجيون من ظواهر السلوك البشري منذ ما قبل التاريخ.
ولكن ما هو الابستمولوجي في العاطفة؟ أي كيف تصبح العاطفة طريقا للمعرفة؟
هناك طرق مختلفة للإجابة عن هذا السؤال. واحدة منها تستحق برأيي المتواضع الصفة العلمية وهي الطريقة التجريبية. أي بالسؤال عن الكيفية التي تتلاحق بها مجريات العملية العاطفية لدى الكائن البشري تجريبيا؟ ويمكن فهم المسألة بمقارنة تلك الطريقة بالطريق العلمي التجريبي، سواء أكان علما ماديا تطبيقيا أم تاريخيا، وهو الطريق الذي يؤدي بالانسان إلى الإحساس بأنه “يعرف” حقيقة شيء ما بعد أن يحلل مكوناته وتأثيراته المختلفة في مخبر، ويشبهه في حقل التاريخ عمل العالم الذي يحس أنه “يعرف” حقيقة تاريخية ما بتحليل الوثائق والآثار المتعلقة بموضوع ما، ثم إعادة تركيبها بشكل قابل للفهم ومتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية المدروسة.. إذن في الطريق العلمي التجريبي تبدأ المعرفة من “مادة ما” تطبّق عليها طرق للتحليل والدراسة لينتهي الباحث إلى “الإحساس بأنه عرف” أو قارب المعرفة بدرجة ما من درجات الخطأ قابلة بذاتها للقياس. أما “المعرفة العاطفية” فتبدأ بالضبط من ذلك الإحساس، ولكنه ليس إحساسا بالمعرفة ولكنّه إحساس بدافع معين هو بتحليله الأخير “دافع اجتماعي” يجعل المرء محبا أو كارها أو خائفا لموضوع ما لعاطفته. وهذا يترجم معرفيا بمجموعة من الصفات لهذه المواضيع وسلوكيا بمحاولات الوصول إليها أو الهرب منها أو القرف، ...الخ. إن المرء يحس بأنه “يعرف” أن موضوع عاطفته موجود هناك، وله مواصفات معيّنه تتأثر عادة بطبيعة العاطفة إياها.
وهذا بالذات ما يحدث في العملية الإيمانية التي يبدأ بها كل تديّن. حيث موضوع العملية العاطفية هو المقدس. وهنا نميّز بين عاطفتين أساسيّتين: الأولى هي الحب وهي العاطفة الأساسية في التصوف والثانية هي الخوف وهي العاطفة الأساسية في التديّن العادي. فالمتدين من غير المتصوفة لا يدفعه إلى الممارسة الدينية إلا الخوف من الحساب.ولذلك فهو يقوم بشكل عام بأداء الفرائض، أي ما لا بد من القيام به للنجاة من العقوبة يوم الحساب. فإذا زاد على ذلك فبدافع ليس أكثر نبلا، أقصد دافع الطمع بالأجر، أو بنيل حسنات “يذهبن السيئات”. إنه المبدأ نفسه، مبدأ الثواب والعقاب الذي تكمن في أساسه عاطفة واحدة هي عاطفة الخوف. أما ما يدفع المتصوف إلى التديّن فهو “الرغبة في اعتناق العروة الوثقى. فيتحرّك سيره إلى القدس، لينال من روح الاتصال” بكلمات ابن سينا. أي إنه يبدأ من الرغبة لا من الرهبة. من الحب لا من الخوف. إنه يريد الوصول إلى حبيب لا الهروب من عقاب ما.
إن انطلاق الدافع الديني من عاطفة الحب بدلا عن عاطفة الخوف من شانه أن يفتح الباب إلى دين خال من العنف. إذ أن الخوف يكمن في أصل كل عنف. ليست هذه نتيجة الأبحاث النفسية فحسب، بل نتيجة استقراء التاريخ أيضا.




