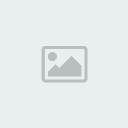
كانت مشاهد حفلة العرس في إحدى القرى السّاحليّة التّونسيّة مملّة إلى حدّ القرف. رجال هجرتهم المتعة منذ زمن بعيد يجلسون مصطفّين على كراسي من البلاستيك وعلى وجوههم وجوم مواكب العزاء. نساء اجتهدن بمكر المساحيق والثّياب لإخفاء ألم أجساد مترهّلة بفعل عذابات عبوديّة الواجب اليوميّ. بعض فتيات يتمايلن باحتشام كاذب على ايقاعات موسيقى مرعبة، وفتيان هرموا قبل الأوان يحلمون بثمار جنّات ما فتئت تنأى عنهم. الكلّ في انتظار عريس وعروس ما زالا يتخبّطان في الخارج بين براثن إجراءات الزفّة الطّويلة والمكلفة والمرهقة. إجراءات رتيبة تمتصّ الرّغبة في التّمتّع بالآخر ومع الآخر وتحوّل الاقتران بين إنسانين إلى منظومة إخصاء رهيبة، بعد أن تزجّ بالجميع في مصنع بيروقراطيّة العادات.
ولكن ثمّة شيء وحيد كان يبدّد مللي وعزلتي. أصوات مرحة لأطفال يلعبون لعبة التّخفّي والظّهور أو “الغميضة” في فناء المنزل. كانوا مثل جوقة ملائكة مرحة يختفون فيسود صمت مثقل بلهفة التّرقّب، ثمّ يظهرون فجأة فتلعلع في الفضاء ضحكات فيها نزق اللّقاء ومتعة هتك كلّ الأسرار. هذه اللّعبة التي يعشقها كلّ الأطفال هي ذاتها التي تحرّك مغامرتنا مع اللّغة وعلاقتنا مع الآخر. إنّها المراوحة الدّائمة بين الإخفاء والإظهار وبين الحجب والتّعرية وبين المنح والمنع. هذه اللّعبة الإنسانيّة الكبرى هي التي صانت ما تبقّى من طفولة الإنسان ومنحت فضاءات للكتابة والإبداع الفنيّ والفكر النّقديّ والعلم والسّياسة القائمة على حرّية المشترك. ولكن لم يكن لهذه اللّعبة أن تبدع تجاربها التي ما زلنا نتغذّى من ثمارها لولم تصارع قوى الهيمنة على المتعة، أي قوى الهيمنة على السّلطة، ولو لم تذهب بعيدا في استكشاف معاني الحرّية والمساواة بإكراهاتها والتباساتها.
كانت لعبة “الغميضة” المعنى الوحيد الذي وهبني إيّاه الأطفال لإشاحة البصر عن حفلة فظاظة هجرتها معاني الأسرار. حفلة عرس كلّ شيء فيها كان مضخّما وممنوحا بفجاجة.
ولكن هذا المعنى لم يدم طويلا. هوّة من الفراغ سرعان ما انفتحت وابتلعت المرح.
فجأة خرجت طفلة صغيرة من مخبئها لتلاحق بقيّة الأطفال في لعبهم. لقد أحدث ظهورها في كلّ الحضور على اختلاف حكاياتهم أو لا حكاياتهم صدمة يحدثها عادة اكتشاف اللاّمألوف. كانت الطّفلة مثل بقيّة الأطفال تماما ومختلفة عنهم تماما في الوقت نفسه. لقد ألبست الطّفلة الحجاب. كانت تجري وراء الأطفال وتقف بين الفينة والأخرى لتمسح عرقا غزيرا يتصبّب على وجهها من وراء حجاب رأسها الأسود، أو تعدّل فتحات سروالها الأسود الطّويل والفضفاض لتحافظ على إيقاعات خطواتها الصّغيرة وتتجنّب التّعثّر والسّقوط. كانت الطّفلة تجرجر حجابها في تلك اللّيلة الحارّة مثل المحكوم عليهم بالأشغال الشّاقّة المؤبّدة، وقد كانت السّلطات العقابيّة في بلدان عديدة تضع لهم كرة حديديّة ثقيلة تلازمهم في حركتهم إلى يوم مماتهم. ففي كلتا الحالتين يكون لهذه الأثقال التي تضاف إلى الجسد الحرّ مهمّة مرعبة وهي تذكير الكائن بالذّنب، بل جعل الذّنب أمرا ملازما لجسد الكائن يعيش به ويتآلف معه. إنّها الألفة التي تتحوّل تدريجيّا إلى استسلام واعتراف بالقدر المحتوم، بل تتحوّل في بعض الأحيان إلى إيمان بأنّ ما فرض على الكائن غصبا ومن خلال الهيمنة على إرادته كان نابعا من طبيعته الإنسانيّة المختلفة والدّونيّة. إنّها حرّية اختيار أن لا يكون الكائن حرّا.
الذّنب الذي ستحمله الطّفلة كامل حياتها كقدر واختيار هو كونها مشروع جسد أنثى مختلف لا يمكن أن يتحرّك خارج سلطة ذكوريّة تتحكّم في المتعة من خلال سلطة الانتصاب. انتصاب الذّكر المهيمن على الفضاء العامّ والخاصّ. الانتصاب الذي يتغذّى مثل وحوش الأساطير من التهام متعة الغير واحتوائها إلى حدّ الفناء وإفناء المجتمع. كلّ علاقاتنا بالسّلطة في بلداننا التي بلا تاريخ للمتعة القائمة على الحرّية والمساواة هي محاولات دائمة للحجب العنيف للمختلف ومتعته.
كانت الطّفلة التي لا تتجاوز خمس سنوات تسحب حجابها مثل كفن. كانت تسحبه إلى حيث تحاول سلطات الانفراد بمتعة الحياة إقناعها بضرورة الاختيار الحرّ لكره الحياة. منذ نعومة أظفارها، كما يحلو للغتنا القول، يفرض عليها أن تغادر حكاية جسدها ومغامراته وارتباكاته. إنّه الكفن الماديّ والرّمزيّ الذي يذكّرها دائما بضرورة قتل الجسد وكرهه واعتباره دمّلا يجب حجبه عن نفسها والآخرين لتقديمه هبة مطلقة للذّكر محتكر المتعة حسب طقوس معيّنة لا تملك لها ردّا في غالب الأحيان. إنّها طقوس تبادل الأنثى بين الذّكور تحت مسمّيات عدّة كالعفّة والشّرف والأمومة المقدّسة التي تتحوّل إلى قوانين وأعراف يضعها الذّكر المهيمن على السّلطة في المجتمع. إنّ الكفن في الحقيقة هو الذي يسحب الطّفلة ومن ثمّ المرأة نحو صياغة تبدو في الظّاهر حرّة وواعية، ولكنّها تخرجها طوعا من المنافسة على السّلطة في المجتمع.
إنّ مجموعة الحجب التي أبدعتها مجتمعاتنا للهيمنة على المرأة تتجاوز خرقة القماش لتتجسّد أيضا في مظاهر أخرى مثل التّهميش من الحياة السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة والتّجهيل والعنف والختان وجرائم الشّرف. هذه الحجب أسلحة في الحرب الدّائرة منذ دهور بين الذّكر والأنثى من أجل السّيطرة على السّلطة وإدارتها. والذّكر في مجتمعاتنا ميّال إلى التّعبير الفجّ والمباشر عن هيمنته. أمّا الأنثى فقد استطاعت رغم كلّ الإكراهات أن تخاتل المنع والاستبداد وأن تجد لها على مرّ تاريخنا منافذ لمساءلة سلطة الذّكر المطلقة وإرباكها وبناء هوامش سلطة موازية. ولكنّ هذه الهوامش لم تتحوّل في يوم من الأيّام إلى مراجعة جذريّة لمفهوم السّلطة في مجتمعاتنا، لأنّ الذّكر عندنا لا يقبل المنافسة في الانتصاب ويحتكر المتعة التي تتحوّل إلى احتكار لمتعة السّلطة. لذلك لا تسعى الحجب إلى القمع المطلق للمرأة ومحوها من الوجود، فالمرأة قادرة على المغامرة مهما كانت ظروف حبسها وتهميشها، بل تسعى إلى أن ترتسم في ذاكرة جسد المرأة كعلامات طريق تذكّرها دائما وأبدا بخطوط حمر لا يمكن أن تخترقها لتقوّض أركان السّلطة المطلقة. هذا هو أساس الاستبداد عندنا إذ يُستنسخ على الدّوام في حالات لامتناهية ويمتدّ ليشمل المجتمع ككلّ. إنّ مجتمعاتنا لا تربّي على الحرّية وحقوق الإنسان بل تربّي على ثقافة استبطان المنع والإكراه وتبرير استعباد المرأة الذي تحوّل في نهاية الأمر إلى عبوديّة للّرجل.
إنّنا أمام مشهد فاجعة حضاريّة تهذي فيه المرأة من عنف حجبها ويهذي الرّجل من ثقل أوزار سلطته التي تدمّر كلّ رغبة حرّية. عبدان هما المرأة والرّجل تتشابك أصفادهما وتفترق أحيانا ولكنّ النّتيجة واحدة وهي تأجيل كتابة تاريخ حرّية المجتمع.
لقد عاشت المرأة في العقود الأخيرة مغامرة فذّة على درب المطالبة بحقوقها في المساواة والعمل والتعليم والصّحة الإنجابيّة وتطوير قوانين الأحوال الشّخصيّة والمشاركة في الحياة السّياسيّة والثّقافيّة. هذه المغامرة، وإن حقّقت نتائج متفاوتة من بلد عربيّ إلى آخر، فإنّ ثمرتها الأساسيّة تمثّلت في زعزعة الهويّة المغلقة للمرأة وفتح مصيرها على هويّات متعدّدة. لقد تحوّلت رغبة الحرّية لدى المرأة إلى مطالبة بالحقوق وسعي إلى التّمتّع بها وتحويلها إلى قاعدة ملزمة. وبما أنّ كلّ مطالبة بالحقوق تنتج عنها بالضّرورة مطالبة بإعادة توزيع السّلطة على أساس المساواة والحرّية والعدالة والكرامة، فإنّ ردّة الفعل على بحث المرأة عن تأسيس هويّات جديدة انطلاقا من حقوق الإنسان للنّساء كان بالرّفض العنيف أحيانا وبمحاولة الاحتواء أحيانا أخرى. لقد انبرت سلطة السّياسة المغلّفة بالدّين والعادات والتّقاليد للتّشكيك في مفهوم المساواة وتنسيبه والسّخرية منه وحجبت رؤية المرأة الوليدة والهشّة بحجب ماديّة وأخرى رمزيّة وضعتها أمام خيار صعب: مواصلة مغامرة تأسيس هويّاتها الجديدة وبالتّالي تحمّل العراء الوجوديّ والمجتمعيّ والضّياع، أو العودة إلى حضيرة السّلطة المهيمنة وعيش حرّية الخضوع. هذا هو الخيار المقترح اليوم على المرأة. فعلى المرأة أن تفكّر اليوم مليّا قبل أن تختار حقّها في التّصرّف الحرّ في جسدها وعقلها أو أن تواصل أحلامها المعرفيّة أو أن تؤخّر سنّ زواجها لتختار من يهفو إليه قلبها. ففي مصنع الاستبداد، حوّلت مجتمعاتنا الاستبداد العبوديّة، إلى حرّية، وحوّلت المطالبة بالحقّ إلى شذوذ يجلب على صاحبه الضّياع وبؤس العزلة.
ولم تكتف مجتمعاتنا بالحجب التّقليديّة والعنيفة لمحاصرة المرأة، بل أضافت إليها حجبا من منتجات عصر ما بعد الحداثة. لقد تحوّلت الفتيات الصّغيرات والنّساء إلى سلعة تعرض بفجاجة في برامج الإشهار السّلعيّ والكليبات والسّتار أكاديمي. هذه المجتمعات التي تحضّ على ضرورة وضع الحجاب والنّقاب هي نفسها التي حوّلت جسد المرأة إلى سلعة مبتذلة للعرض وإثارة الغرائز. فمالكو قنوات العفّة والأخلاق هم أنفسهم الذين يستبيحون جسد البنات والنّساء كسلعة. لا يوجد تناقض بين الأمرين إلاّ في ظاهر الأشياء بينما اللّعبة العميقة والفاجرة هي لعبة السلطة. إنّها محاولة جديدة ومتجدّدة لسجن المرأة في قدرها كأداة متعة سلبيّة. نساء وبنات يمكّنّ الذّكر المهيمن من عيش تهيّآته حول العفّة ومكارم الأخلاق من جهة، ونساء وبنات يمكّنّه من عيش متعته الغريزيّة في وحدته من جهة أخرى. كلّ النّاس أدوات متعة للمتسلّط الذي يوزّع عليهم الأدوار حسب حاجاته.
إنّه مطلق الحضيض الذي يسحب طفلاتنا وأطفالنا نحو حضيض المأساة. حضيض لا يمكن أن تسائله سوى إرادة رجال ونساء يستشرفون أفقا للكرامة البشريّة والمساواة.




