مريم
فريــق العــمـل


الجنس : 
عدد المساهمات : 364
معدل التفوق : 978
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
 | |  صناع الخبر: الميديا والسلطة والحقيقة (2/2 صناع الخبر: الميديا والسلطة والحقيقة (2/2 | |
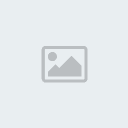 الميديا والمال: الميديا والمال:
ترى النظرية الليبرالية التقليدية أنّ الملكية الخاصة للميديا تحافظ على استقلاليتها من السيطرة الحكومية ممّا يساعدها على لعب دور السلطة الرابعة بشكل فعّال، كما أنّ الطبيعة التنافسية للسوق تسهم دائما في ظهور مقاربات جديدة عبر منابر إعلامية بديلة تتنافس مع بعضها بطريقة تمنح المتلقي-المواطن خيارات متعددة ووجهات نظر مختلفة تتقارع بمنطق جدليّ هدفه الإقناع الايجابي. بهذه الطريقة تكون الميديا قد لعبت دورها المفترض كحيز للحوار العامّ، أمر قد نرى نماذجه في العديد من البلدان الديمقراطية لكن بحدود معينة تقيّد هذه الرؤية الليبرالية المثالية، وإذا لم يكن الجميع قادرا على إدراك هذه الحدود أو التجاوز بفكره ما يتداول في الحيز الإعلامي، فإنّ آخرين يدركون بأنّ الميديا الجماهيرية غالبا ما تلعب دور منتدبا كوكيل لسلطة أو لقراءة فكرية معيّنة (آلتوتشل 1995)، دون أن يعني ذلك إغفال حقيقة أنّ نمط “الوكالة” هذا هو أكثر تعقيدا في المجتمعات المتقدمة عنه في البلدان النامية لاسيما تلك المحكومة بأنظمة شمولية أو سلطوية عادة ما تستغلّ الإعلام في عملية التنشئة الايديولوجية أو لغرس قيم الطاعة والرضوخ أو في أبسط الأحوال لتكريس اللامبالاة السياسية لدى المتلقي، وقد رأينا نماذج لهذا النمط في الديكتاتوريات العربية التي غالبا ما استخدمت وبعضها لا يزال يستخدم عبر إعلامه الرسمي أنماطا ساذجة من الرسائل الإعلامية التي يغدو فيها الدور التمثيلي الذي يلعبه الإعلام لصالح السلطة جليا وغير قابل للمساءلة، لكننا شهدنا منذ ثورة الستالايت تحولا نوعيا تمثل بظهور القنوات الفضائية الجماهيرية ذات الصفة غير الرسمية، والتي يمارس فيها دور الوكالة بطريقة أكثر تعقيدا تحاكي ما يجري في الميديا الغربية، ولذلك فإنها عادة ما نجحت في جذب انتباه الجمهور بعيدا عن قنواته الرسمية المحلية، لاسيما عند تعلق الأمر بالقضايا الخارجية والصراعات الإقليمية. هنا لا أودّ الذهاب بعيدا إلى حد مشاركة مارك لينج (2005) تفاؤله “البريء” عن نجاح تلك القنوات في أن تصبح “صوتا للجمهور العربي” إلا بقدر ما يعني ذلك أنها أسهمت في الحد من خضوعه لسطوة الرسائل الإعلامية الرسمية، لكن فقط ليخضع لسطوة نمط آخر من الرسائل التي تمثل (عبر طرق التمثيل الأكثر تعقيدا واحترافية) مصالح إقليمية أوسع، ولذلك نرى الممولين والمساندين الحقيقيين لتلك القنوات وهم أثرياء رسميون أو شبه رسميين يتفاوضون عبر الحكومات حول نمط التغطية الإعلامية (كما في حال مباحثات الحكومتين القطرية والسعودية حول تغطية الجزيرة للمواقف السعودية ومؤخرا للاحتجاجات الشعبية في بعض البلدان العربية).
البعض يرى أن علاقة الميديا بالملكية الاقتصادية لا يمكن أن تفهم إلا عبر نموذج الاقتصاد السياسي، وهؤلاء يجادلون بأن الملكية الخاصة ستنتهي إلى تراكم السيطرة الإعلامية في أيدي فئة قليلة من المالكين مما سينتج نوعا من الاحتكار المالي-الإعلامي، وبالتالي سيصبح حيز الحوار العام ضيقا ومقتصرا على أجناس محددة من المواقف ووجهات النظر، أما الرؤى المهمشة أو البديلة فلن تكون قادرة على إسماع صوتها بسبب الافتقار إلى الموارد والتوزيع غير المتساوي للسلطة داخل المجتمع (وينتر 2007). إن الميديا خضعت للكثير من عمليات الاستقطاب والاندماج والتفكك نتيجة العولمة الاقتصادية المتزايدة، ورصد البعض اتجاها واضحا نحو تركيز الملكية بطريقة منحت بعض كبار المستثمرين في اقتصاد الميديا قدرة احتكارية عالية، وبحسب بينيت (2005 ) فإنّ أول تأثير لهذا السلوك الاحتكاري سيتمثل في إخراج الميديا الصغيرة التي تمثل قيما غير تجارية من ساحة التنافس، بل إن المالكين سيتمكنون من استبعاد أو السيطرة على أي نوع من الأخبار التي قد تؤثر سلبا على مصالحهم التجارية أو تلك التي تسائل النظام الاجتماعي – السياسي الذي منه استمدوا نفوذهم وقوتهم ( تشومسكي وهيرمان 1994 ، وينتر 2007 ). لنتذكر هنا الدور الذي لعبه ويلعبه روبرت موردوك عبر سيطرته على طيف واسع جدا من وسائل الإعلام عالميا إلى درجة اضطرت توني بلير إلى عقد اجتماع معه لكسب وده عندما كان يسيطر على صحيفة الصن وعندما كان بلير يشرع بإعادة تأهيل حزب العمال لخوض الانتخابات في منتصف التسعينيات (كوهن 2007 )، وهنالك أيضا سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الحالي في ايطاليا، والذي نجح بفضل إمبراطوريته الإعلامية من إنتاج تأثير غير مسبوق في السياسات الايطالية ومن تأمين الفوز الانتخابي لحزبه مرتين، بل وفي حجب العديد من الفضائح الشخصية التي طالته والتي لا تجدها سوى في الإعلام المعارض له والذي لا يحظى بنفس النفوذ، والذي اعتاد بيرلسكوني على التشكيك بمصداقيته عبر وصفه بـالشيوعي !! وقد كان الصحفي الأمريكي أليترمان واضحا عندما كتب “إن من يقرر نوعية الأخبار ليس المراسلين ولا المحررين بل مالكي وسائل الإعلام” (2003 :ص 27 ). من هنا كانت البي بي سي ظاهرة استثنائية ولافتة على الأقلّ في العالم الانكلوسكسوني من حيث كونها مؤسسة إعلامية ممولة من المال العام وغير خاضعة لسيطرة الحكومة مما مكنها من أن تقدم في الكثير من الأحيان نسخة رصينة من القراءة الإخبارية والمتابعة الإعلامية المتحررة من ضغط مصالح المالكين والمعلنين والسياسيين البريطانيين ، لكن مثل هذا النموذج قد لا يكتب له النجاح إلا في ظل نظام ديمقراطي راسخ . كما أن قدرة البي بي سي على تجاوز الحدود الايديولوجية للنظام تظل دائما في محل شك لاسيما مع حقيقة أن خدمتها الخارجية انطلقت أصلا كأداة ترويجية للسياسة البريطانية .
إن الميديا الخاصة تحاول تجنب أيّ نوع من التغطية التي قد تزعج المعلنين فيها وتدفعهم للنفور منها، فلكونها مؤسسات ربحية تحتاج تلك الميديا أن تحافظ على جذبها الإعلاني وقدرتها التنافسية كهدفين يعززان بعضهما. وفي الحقيقة ان تأثير العامل الاقتصادي يمكن الإحساس به حتى عند التعامل مع الجوانب التقنية لعملية إنتاج الخبر فمؤسسات الميديا العملاقة اليوم بحاجة إلى الحفاظ على سمعتها عبر جذب اكبر عدد من المتلقين وما يعنيه ذلك من جذب المعلنين والمستثمرين، الأمر الذي يتطلب، من بين أشياء عديدة، إنتاج سلعة خبرية تحظى بمعدل استهلاك عال. فالقنوات التلفزيونية والصحف واسعة الانتشار تبيع الوقت والحيز للمعلنين الذين يحاولون في الوقت عينه شراء اهتمام المتلقي، بل إن الميديا كما يرى وينتر (2007 ) تقوم في الحقيقة ببيع المتلقي إلى المعلنين. التنافس المتزايد يؤدي بدوره إلى أن تندفع الميديا الإخبارية نحو تقنيات ومناهج تستهدف الربحية والجذب التجاري والتي تربط جدارة الموضوع الخبري بالقابلية على الجذب، فالأخبار تؤطر وتقدم كأي سلعة معروضة للبيع، ومن هنا تلتقي الاعتبارات التقنية المتعلقة بالوقت والحيز والتكنولوجيا مع الاعتبارات التجارية في مزاوجة تمنح الأفضلية لنمط أخباري يقوم على السطحية، والشخصنة، والتفكك، والسرد الدرامي ( بينيت 2005) .
البنى الايديولوجية وصناعة الخبر:
يمكن فهم دور الميديا السياسي كأداة للهيمنة الايديولوجية عبر تمثل التحليل الغرامشي الذي يرى أن هيمنة الطبقة الحاكمة تعتمد على الاختراق والتثقيف الايديولوجي للطبقات الخاضعة من خلال الهندسة الذهنية لضمان هيمنتها. الهيمنة بالنسبة لغرامشي تتحقق عندما تقوم قطاعات واسعة من السكان ليس فقط بالقبول بالمفاهيم والأفكار التي تتبناها الطبقة الاجتماعية المهيمنة، بل وبالتسليم بهذه المفاهيم والأفكار باعتبارها نتاج لإجماع المجتمع. يقود ذلك إلى إقصاء الأفكار والمفاهيم المضادة ونزع الشرعية عنها وتهميش أيّ اطر ايديولوجية بديلة عبر جعل الإطار الايديولوجي المهيمن هو الوحيد القابل للتفكير به. الصناعة الخبرية تقوم بعملية مماثلة عبر ما تستهدفه من تقوية (او المحافظة على) نمط من التصورات والمدركات، وهندسة للإجماع، وتكرار يسعى لخلق حالة من التعود والاعتياد على تلك التصورات بما يجعلها تبدو وكأنها مسلم بها ومستندة على مقبولية اجتماعية جامعة. إلى ما يقترب من ذلك ذهبت نظريات تحليل الخطاب لاسيما تلك التي تضئ البعد الاجتماعي-السياسي ودوره في إعادة إنتاج علاقات القوة عبر النص. هنا تتأكد أهمية عملية إنتاج الاتجاه السائد بما تعنيه من إنتاج للمعنى المتعارف عليه والافتراضات المشروعة التي يستخدمها الناس لتفسير عالمهم، وهنا تتجسد أيضا خطورة قبول المتلقي بما يقدمه الإعلام من أخبار بوصفها وقائع مسلم بها (دور هام 2005 ، جونسون-كارتيه 2005).
ينبغي الحذر من الفهم المبسط لمفهوم الطبقة المهيمنة، ولا بدّ من إدراك أن هذه الطبقة لا تعني الحكومة بالضرورة رغم أن الشخوص المشكلين للأخيرة قد يكونون جزءا منها. ووجود طبقة مهيمنة لا يعني بالضرورة أنها طبقة منفرزة وواعية بذاتها بقدر ما يعني التعبير عن أنماط من التحالفات الاجتماعية المبنية على علاقات القوة وما يغذيها وتغذيه من أطر فكرية ومعيارية. وربما كان نموذج البروباغندا الذي اقترحه تشومسكي وهيرمان (1994) يقدم تحليلا مهما لدور الإعلام المهيمن في الولايات المتحدة ويعرف علاقته المعقدة بالتحالفات الاجتماعية المسيطرة. يشير الاثنان إلى أن الوظيفة الاجتماعية للميديا في الولايات المتحدة تقوم على غرس والدفاع عن الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجموعات التي تحظى بمنزلة أعلى في سلم القوة والتي تهيمن على المجتمع والدولة. والميديا تخدم مصالح هؤلاء بعدة طرق مثل اختيار المواضيع وتحديد الاهتمامات ومصادر القلق وتأطير القضايا وفلترة المعلومات، وعبر صيغ التشديد والنغمة التعبيرية، وعبر الحفاظ على النقاش ضمن حدود المسلمات المقبولة. لذلك فإن تهميش هؤلاء الذين لا يحظون بالأفضلية في البنية الاجتماعية – السياسية يحصل بصورة طبيعية جدا بحيث أن صانعي الأخبار لا يستطيعون إدراك ذلك وهم يقدمون أخبارهم عبر ما يعتقدون انه عرض موضوعي. يحدث كل ذلك بطريقة تلقائية وطبيعية جدا بحيث أن المؤثرات والآليات المذكورة تغدو غير مرئية حتى بالنسبة للمنخرطين المباشرين بهذا العمل.
إن فهم حدث معين يتطلب موضعته ضمن خارطة ذهنية تساعدنا على فهم العالم ومنه نستمد مصادرنا لتصنيف وتأويل هذا العالم. الميديا تسهم في تيسير هذه العملية عندما تقدم “العالم” للجمهور وبطريقة تتفاهم مع مكوناتنا الإدراكية والثقافية، أي إنها تنقل الحدث من حيزه “الأجنبي” ليس بوصف أجنبيته جغرافية فقط بل وذهنية أيضا، إلى حيزنا الذي نتشاطر فيه المعاني والتصورات والقيم (ألان 1999 ). التأطير الخبري يحقق هنا غايات ايديولوجية من خلال ما يلعبه من دور استراتيجي في جذب متلقين أكثر وفي تعبئة الجمهور باتجاه موقف ومن ثم فعل معين. إنه يغدو عملية ذات عناصر إدراكية وثقافية تحكمها انحيازاتنا النفسية والبنى الثقافية القائمة على مركزة مفاهيم معينة وتهميش أخرى. وهو أحيانا يعيد إنتاج التضامن الاجتماعي والثقافي الميكانيكي عبر إنتاج “معان مركزية” توحد المجتمع وتمنعه من الانقسام. ومن المهم ملاحظة أن للخبر بعدا سرديا يمنح كاتبه أو صانعه سلطة السرد وبالتالي التأويل، ويتفق الباحثون على أن القصص الخبرية تحكمها قيود لغوية بالإضافة إلى القيود الايديولوجية، فاللغة هي منتوج ثقافي وبالتالي فإنها لا تستطيع الإفلات بسهولة من خيارات وسلطة النظام الثقافي الشامل.
تمارس اللغة بدورها سلطة على النص الخبري، فتسهم إلى حد كبير بتقرير ما يمكن معرفته، كما أن مزيج الكلمات في الجملة الخبرية وطريقة تشكيل هذه الجملة يقترحان بالضرورة قراءة معينة للحدث وتوزيعا معينا للمسؤوليات في إطاره (مثلا عبارات مثل : ويذكر انه، ما يعرف، ادعى، زعم، كشف، الاحتلال، المقاومة، الإرهاب … ) (جينيكين 1998 ، تانكارد 2003 ).
من الصعب على الصحفيين وصناع الخبر التخلي عن انحيازاتهم الايديولوجية والثقافية لأن الكثير من هذه الانحيازات يقبع ما وراء الوعي ولا تبدو ظاهرة لهم، فالإنسان عندما يفهم الأشياء يلجأ إلى خارطة المعاني المكتسبة في جلها لإعطاء معنى لما يدركه، وهو غير قادر على الاستعانة بخارطة بديلة لا يمتلكها، ورغم ان الصحفيين في الكثير من الأحيان يختارون الانحياز بطريقة واعية ومقصودة، إلا أنهم في أحيان كثيرة أيضا لا يفعلون ذلك عن قصد، إنهم ببساطة يعملون وفقا لأنماط تعيد إنتاج الانحياز غير المقصود بوصفه طريقة لفهم الأشياء. يمكننا ان نعثر على الكثير من الأمثلة الإعلامية اليوم حول صياغات خبرية تستهدف تفضيل تأويل معين للحدث، ويمكننا بقدر معقول من المعلومات أن نفهم قصدية الانحياز وأسبابه والطابع المتعمد له، لكن وكما يرى تانكارد (2003 ) فإن التأطير الخبري اعقد من أن يكون مبنيا فقط على عنصر الانحياز، انه يذهب بعيدا عن ثنائية المفضل وغير المفضل، الايجابي والسلبي، فسلطته الايديولوجية الأساسية تكمن في قدرته على تعريف الحدث ووضع شروط تأويلية له لا تكتسب أي معنى خارج سياق هذه السلطة، وفي نفس الوقت تبدو التقنيات التأطيرية في داخله غير مرئية حتى بالنسبة لصانعه أحيانا.
التأثير الايديولوجي يبدأ في مرحلة ماقبل صناعة الخبر، فهذا الأخير ليس منتوجا معروضا بذاته ومستقلا عن خيارات صانعه، فالأخبار لا تقول نفسها كما يدعي بعض التبسيطيين، الأخبار نتاج عملية اختيار تحكمها شروط ومتطلبات، فصناعة خبر تعني إدخال مدخل جديد إلى حيز التلقي، إنها محاولة واعية او غير واعية للتأثير على أنماط التفاعلات داخل هذا الحيز، وإن كان هذا التأثير يتدرج ويتنوع بحسب المباشرة التي تتسم بها علاقة الخبر بالمحيط الاجتماعي المتلقي او بحسب دراماتيكيته، كما سنوضح لاحقا، وبالتالي فإنها عملية استدعاء للحدث من فضائه الاعتباطي إلى فضاء المعنى، وموضعته ضمن خارطة المعاني التي تشكل أساس معرفتنا الثقافية وفهمنا للعلاقات بين الأشياء ولموقع الأشياء من بعضها كما لموقعنا نحن منها. من هنا ينطلق جونسون – كارتيه (2005 ، ص 115) بقوله : “إن من بين ملايين الأحداث التي تقع يوميا في عالمنا، هناك نسبة صغيرة جدا تغدو مرئية بوصفها (قصصا إخبارية محتملة)، ومن بين هذه القصص الإخبارية المحتملة، هنالك نسبة صغيرة قابلة لأن تصبح أخبارا فعلية تقدم عبر الميديا الإخبارية. إننا نتعامل هنا مع (بنية عميقة) تبدو وظيفتها كجهاز انتقائي غير واضحة حتى لدى أولئك الذين يفترض أنهم قائمون عليها”.
السياسة وصناعة الخبر:
إن معظم الميديا الخبرية في الولايات المتحدة والغرب وحتى بعض البلدان العربية تتبنى ما تعرف أنه معالجة موضوعية ومحايدة ومتوازنة للحدث السياسي، لكن التأثير السياسي يجد عادة طريقه إليها، ويرى بينيت (2005 ) أن ذلك يعبر عن حقيقة أن معظم القصص الإخبارية تدور حول طبقة من السياسيين الرسميين الذين يلعبون أدوارا نمطية في الدراما السياسية. أما بريوير (2006 ) فقد أجرى قياسا للتأثير المباشر للمحتوى الإعلامي على مواقف المتلقين مستنتجا انه عندما تقوم الميديا الخبرية بتقديم دولة أجنبية بوصفها مهددة للمصلحة القومية، فإن تلك الدولة تصبح في موضع التشكيك أو الرفض لدى المتلقي، وعندما تنخرط “أمّتنا” في صراع عسكري خارجي فإن هذه الميديا مهما بلغت ادعاءات الموضوعية لديها تبدأ بتغليب خطاب “وطني” وإضفاء الطابع الرسالي على ذلك الصراع مع خصم غالبا ما يبالغ بشيطنته والتركيز على سلبياته. وإذا كان النمط الدعائي سهل الانكشاف في الإعلام التابع لدول غير ديمقراطية ولا يمتلك استقلالية عن القرار السياسي، فإنه أحيانا ليس أقل وضوحا في الإعلام “المستقل” للدول الغربية .
يقول بينيت (2005 ) انه في معظم الصراعات التي كانت الولايات المتحدة أحد أطرافها، تجاهل الإعلام الكثير من الحقائق حول “العدو” وغلب التغطية العاطفية لاسيما تلك التي تحيي “قواتنا” ودورهم الوطني . لكن تأثيرا سياسيا اكبر يتجلى في الدور الذي يلعبه السياسيون كمصادر للمعلومات مما يسهل عليهم صياغة الأجندة وأحيانا السردية الخبرية ذاتها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدولية وحيث لا يمتلك المتلقي تصورا واضحا حولها. من هنا يمكن أن نفهم لماذا تُبّرز ديكتاتورية زعيما ما ويتمّ التغاضي عن ديكتاتورية غيره، فالعالم الخارجي في كثير من الأحيان يقع خارج اهتمام المتلقي العادي والمستهلك للصورة والذي غالبا ما يتسم بقلة الوعي السياسي لاسيما في الشؤون الخارجية وبالتالي بسهولة انقياده للتأويل والتصنيف الذي يقدم له عبر الميديا.
التيرمان (2003 ) يشير إلى أن كثيرين يعتبرون الإعلام الأمريكي ينظر للعالم بعيون الرجل الأبيض متجاهلا في الغالب الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأخرى سالخا الحدث من بيئته الخاصة ومسقطا عليه المعايير الثقافية الذاتية. وبالطبع ليس ذلك حكرا على الإعلام الأمريكي فنماذجه في الإعلام العربي كثيرة . فالخبر الدولي خصوصا يدور حول ما يجري “هناك” وقد تم نقله إلى “هنا” عبر وسيط يستخدم أدوات ومفاهيم وصياغات “تفصل” الحدث عن واقعه لتجعله طيعا لـ“محليتنا”، والأخطر عندما يحصل ذلك مترافقا مع تأكيد التمايز بين الـ“نحن” والـ“هم” عبر تكريس الأولى نموذجا أرقى يتسم بالطبيعية والعادية في الوقت الذي تبدو الثانية أحيانا تعبيرا عن اللاعقلانية او ربما البربرية. وفي ظل العولمة المتزايدة وتصاعد فرص الاحتكاك مع الآخر ومراقبة سلوكه، تخاطر الميديا أحيانا بتبسيط ما يفعله الآخر منتجة حساسيات ثقافية ترتبط أحيانا بسوء تأويل الفعل، ولكن أحيانا يصبح السعي لتوظيف هذه الحساسيات في الجذب الإعلامي وبفعل التعود على فكرة أن المتلقين يميلون إلى مشاهدة الحدث الاستثنائي وغير التقليدي وربما المستفزّ، سببا في إنتاج صراعات خارج عالم الميديا، وقد رأينا ذلك في قضية الرسوم الدنماركية وفي طريقة التعمد في تقديمها للجمهور المسلم بوصفها حدثا مهما ويستدعي الانتباه.
غرفة الأخبار:
إن الأخبار بحسب مانهايم (1998) ليست ظاهرة تلقائية بل هي عملية تشكيل وصياغة تتم بمهارة وفاعلية وبطريقة تأخذ بالاعتبار احتياجات واهتمامات المراسلين والمؤسسات الإخبارية. فالكثير من الأحداث الدولية يتم تجاهلها لأنها لا تحمل عنصر الجذب أو لا تلتقي مع تلك الاهتمامات أو ربما بسبب التكلفة العالية لإنتاجها. إن علاقة الخبر بالمتلقي أو المستهدف وتجاربه وميوله تمثل عنصرا حاسما في تقرير القيمة الخبرية، أضف إلى ذلك ما يحمله الخبر من بعد درامي أو عنصر إثارة، فالميديا تتعامل بحماس شديد مع الأحداث الدولية ذات الطابع التهديدي إلى الحد الذي تتحول فيه إلى أدوات تعبئة من تلقاء نفسها، لكن تعاملها مع تلك الأحداث عادة ما يكون سطحيا ومستعجلا ومنشدا إلى التسلسل القصصي خشية من ملل المتلقي واتجاهه إلى مصدر إعلامي آخر. أما إذا وقع الحدث في مكان بعيد أو لا يحظى بأيّ اهتمام من المتلقي فإنه عادة ما يٌتجاهل أو يقدم بلا حماس أو انفعال (بينيت 2005، اونيل 1992 ) .
أضف إلى ذلك، أن القضايا الاجتماعية أو السياسية العميقة أو المعقدة أو غير الطيعة للمعالجة الدرامية غالبا ما تفلت من العين الإعلامية فتصبح وكأنها لم تكن في عالم باتت قيمة أحداثه تقترن إلى حد كبير بكيفية طرحها وتداولها إعلاميا، بحيث أن خبراء العلاقات العامة صاروا يلعبون الدور الرئيسي أحيانا عند التجهيز لحدث ما لأن النقاش ينصب على كيفية إخراج الحدث بأكثر مما ينصب على محتواه. الأسوأ من ذلك يرتبط بحقيقة أن تغطية الأخبار الدولية مكلفة اقتصاديا وليست شديدة الجذب للمتلقي المحلي مما يدفع المؤسسات الإخبارية، مع استثناءات قليلة، إلى إرسال مراسليها إلى العواصم المهمة، ولا حاجة للقول إن تحديد هذه العواصم هو عملية اختيار تمليها اعتبارات سياسية وثقافية واقتصادية وايديولوجية. إن العالم غير المغطى إعلاميا سيبدو ببساطة وكأنه غير موجود، والمعاناة غير المنقولة عبر كاميرا التلفزيون غالبا ما تكون غير مسموعة للعالم، فحتى الضحايا بحاجة إلى أن يكونوا في المكان والزمان الصحيحين من أجل أن يعرف العالم بوجودهم، أو ربما بموتهم. ليس ذلك إلا جزءا من عملية منتظمة نتاجها حرف الواقع وإنتاج واقع موازي يصبح عبر تسويقه الإعلامي أكثر حقيقية من الواقع الأصلي (ثوسو 2004 ، بولتون 1986، بينيت 2005 ). في حديثهما عن التغطية الإعلامية للحروب أشار سريبيرني وباترسون (2004) إلى أنه ليس هناك شيئا أكثر تضليلا من تغطية الصراعات الكبرى من على سطوح الفنادق الراقية، فالمسافة بين المكان الحقيقي للحدث وموقع المراسل غالبا ما تكون مسافة بعيدة جدا مما يوسع الفجوة بين ذلك الحدث، كما حدث فعلا، وبين قصته المنقولة إعلاميا.
بذات القدر من التضليل وربما أكثر تكون نتيجة الدور الذي يقوم به المراسلون المرافقون للقطعات العسكرية لأنهم يخضعون لرقابة المؤسسة العسكرية وتقيد حركتهم بقيود الاعتبارات الأمنية للجيش، كما أنهم في النهاية لا يغدون إلا مندوبين لطرف واحد ضمن مواجهة فيها طرفان وربما أكثر إذا ما أخذنا بالاعتبار السكان المدنيين.
إن اللغة الغريزية والمثيرة مقرونة بنغمة الصوت المتكيفة مع إيقاع الحدث تحكم غالبا الصيغة الخبرية أكثر من التحليل العميق. الأخبار المهمة عادة ما تكون حول “العاجل جدا” و“السهل جدا” و“الخطير جدا” و“المسلي جدا”، فالجدوى الخبرية عادة ما تتحدد من خلال المعايير الإنتاجية والتسويقية ومن خلال القدرة على التمثيل الصوري للحدث. الوسائل المعتمدة في غرفة الأخبار تقرر صلاحية حدث معين لكي يقدم كخبر، وهذه الصلاحية مقرونة بارتقاء الخبر إلى تلك المعايير. فمثلا عندما تتصاعد أزمة خارجية تميل الميديا الى التركيز بقدر أكبر على الأشخاص المنخرطين وبقدر أقل على الجذور العميقة للمشكلة، فتغدو القضية كأي مسلسل درامي يقوم على الصراع بين الطيبين والأشرار (لنتذكر هنا الحرب الأمريكية على الإرهاب وشخصنتها للأشرار في أسامة بن لادن وتبسيطها المفرط لظاهرة الإرهاب ولطبيعة الصراع مع “الإرهابيين” الذي يقوم على مبدأ : اقتل الأشرار ). ليس مفاجئا عندها أن نرى الميديا منهمكة بمتابعة قضية شخصية لأحد المشاهير في الوقت الذي تقع حرب أهلية دموية في بلد آخر يموت جراءها الملايين، شيء اكتشفنا صدمته مع مذابح رواندة التي قلما كان الغرب يبدي اهتماما بها على الأقلّ قياسا للاهتمام بمقتل الأميرة ديانا أو فضيحة بيل كلنتون الجنسية، أما في العالم العربي فما زلنا غير مطلعين على ما يعتقد أنه مجازر وقعت في دارفور ومازلنا مصممين على إنكار وقوعها لا لسبب إلا لأنها تكشف عن تورط حكومة عربية بها بالضبط كما أن الكثيرين لا يريدون التصديق بأن نظاما عربيا استخدم الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه وأباد قرية كاملة في ساعات قليلة.
إن الميديا وبدلا من أن تخبرنا بما يحصل فعلا تحاول أن تشتت انتباهنا عن الأحداث الخطيرة حقا والمتضمنة معاناة إنسانية كبيرة بمقياس الكمّ والنوع لصالح أخبار خفيفة سهلة الهضم تلائم نفوسنا المرهقة من ساعات العمل الطويلة ومزاجنا الميال للخفة والهزل، كما يقول وينتر (2003) . أو أن نمط الحدث ينطوي على نوع من التعقيد والتداخل يصبح من الصعب معه تقديم قصة متجانسة مع السردية الأوسع المحكية عبر القصص الأخرى، لاسيما عندما يبدو الأشرار طيبين في حالات معينة أو العدو صديقا في حالات أخرى، الأمر الذي نلمسه في سلوك الإعلام العربي الذي عادة ما يخشى من تجاوز التقسيم الصارم للحدود بين الصديق والعدو، وعادة ما يخشى التعاطي مع المساحة الرمادية التي تجري فيها جل مجريات الحياة الواقعية. في حديثه عما أسماه بـ“شيفرة الجدوى الخبرية” يشير ألان (1999) إلى أن الميديا الإخبارية تأخذ بالاعتبار عدة عوامل عند تقدير جدوى القصة الخبرية، من أهمها الطابع الصراعي في الخبر، التوقيت، قابلية الشخصنة، عنصر المفاجأة، الاستمرارية، التركيبة، الطابع النخبوي (سواء كانت نخبوية أممية في الأخبار الدولية أو نخبوية شخصية في الأخبار الداخلية). وهذه الافتعالية في صنع الأخبار تغدو بمرور الوقت طبيعية عبر التكرار ونمط الخطاب المستخدم بشكل يومي.
العديد من الصحفيين والمراسلين والمحررين يزعمون، وأحيانا ببراءة، أنهم يغطون الأحداث بطريقة موضوعية ومحايدة، ويفسرون الموضوعية بأنها تجنب الانحياز لأحد طرفي الصراع، وكأن الأخبار دائما حول صراع بين طرفين، وبالتالي هم يعطون لكل طرف وقتا ومساحة كافية ليعبر عن رأيه، وهذا ما يحصل فعلا في الإعلام الغربي عموما والأمريكي خصوصا ويحاول الإعلام العربي محاكاته بطريقة مصطنعة أكثر.
ولكن هذا التصور يتجاهل حقيقة أن التقرير الإخباري هو عملية اختيار قصة من بين مجموعة قصص محتملة وما يقوم به المراسلون في كثير الأحيان هو جمع الأخبار كوظيفة تخضع لمعايير الجدوى، وعملية التجميع والانتقاء لا يمكن أن تتجرد من الانحيازات الشخصية والمواقف المسبقة أو الرقابة الذاتية التي يمارسها المراسل على نفسه بحسب إدراكه لاهتمامات وخيارات مؤسسته (دورهام 2003 ، مانهايم 19898). إن مفهوم الموضوعية قد تحول تدريجيا من كونه مبدأً أخلاقيا إلى مسلك احترافي في وسائل الإعلام العالمية الكبرى، انه يعني “التوازن” و“عدم التحزب” ولا يعني ما تعنيه كلمة الموضوعية في مضمونها اللغوي والفلسفي، وضرورته تنبع من حاجة وسائل الإعلام الكبرى إلى اكبر قدر من المشاهدين أو القارئين وبالتالي من ضمان قبول منتجهم من قبل طيف واسع من التوجهات السياسية والفكرية والاجتماعية، فضلا عن أن مقتضيات التنافس تفرض الاحتفاظ بقدر عال من المهنية والسمة الاحترافية وأهم مظاهرها في الميديا الإخبارية هي عدم التحول إلى بوق فجّ وساذج لموقف سياسي معين، وبهذا المعنى فإن “الموضوعية” هي عنصر احترافي تسويقي غايته جذب اكبر عدد ممكن من المستهلكين. إن مفتاح نجاح الصحفي يكمن في قدرته على إنتاج قصة تجذب القراء أو المشاهدين، والعلاقات الداخلية في المؤسسات الإعلامية باتت محكومة بهذا المفهوم للاحتراف (ويفر 1994 ، بينيت 2005 ) .
خاتمة:
ليس هذا النقاش سوى محاولة لمعالجة ملاحظاتنا لسلوك الميديا الإخبارية على خلفية الجدل الأكاديمي الراهن الذي تجاوز إلى حد كبير القبول السطحي بمسلمات و ادعاءات المؤسسات الإعلامية والصحفيين عن كونهم رسل للحقيقة، وقد رأينا أن هذه المهنة “الرسالية” تصطدم بثلاثة أنواع من الحواجز التي تحول دون أن يكون واقعها الممارس مطابقا للمثال المزعوم، النوع الأول هو الحواجز المتعلقة بطبيعة تكوين الإدراك البشري وبالقيود الكامنة فيه والمقترنة بحقيقة أن عملية الإدراك هي عملية نقل الأشياء من موضوعيتها إلى ذات المدرك، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تنجو من الإسقاطات الذاتية الناتجة عن حدود وشروط الإدراك لدى الإنسان، وبالتالي فإنّ الرسائل الإخبارية لا يمكن أن تكون مرآة للواقع مهما بلغ مستوى حسن النية لدى منتجيها، أمّا النوع الثاني من الحواجز فهو ذلك الذي تستكمله البنى الثقافية والايديولوجية واللغوية التي تزودنا بخارطة المعاني والمفاهيم التي من خلالها نضفي على الموضوع المدرك تأويله، وهي مرحلة أكثر عمقا في التمثيل الذاتي للموضوعات، أمّا النوع الثالث فهو ذلك المقترن بالبنى المؤسساتية والمعايير الاحترافية والغايات الاقتصادية التي تعبر عنها حقيقة ان عملية إنتاج الخبر هي ممارسة لمهنة ما تحكمها أهداف عقلانية كالنجاح والربح والبقاء وهي عناصر تتطلب، كما في أيّ مهنة أخرى، إمكانيات للتكيف ولقبول المعايير السائدة ولفلترة السلوك بما ينسجم وشروط البيئة المؤسساتية والسوق بكونه حيزاً للتنافس.
قبول هذه الحقائق لا يعني بأي حال من الأحوال الحط من شأن العمل الإعلامي أو القول بلاجدواه، بل ان الحقيقة ربما تكون نقيض ذلك، إذ أن جدوى الصحافة كواحدة من أهم مصادر المعلومات والتنشئة الاجتماعية والسياسية هي التي تحتم علينا مراجعة مفاهيمنا السائدة عنها ومعالجتها نقديا بغية إدراك العيوب الكامنة والتي تتطلب إعادة تأويل لهذا الدور والأهداف الكامنة وراءه. وبهذه الطريقة نكون قد قطعنا شوطا مهما باتجاه الإقرار بأن الميديا لا يمكن أن تعمل إلا ضمن منظومة من علاقات القوة وفي الغالب تكون انعكاسا لتلك العلاقات لأن النظام الاجتماعي – السياسي سواء كان وطنيا أو إقليميا أو دوليا هو تعبير عن صراع دائم بين المستفيدين والمتضررين، صراع لوازمه أدوات الإخضاع أو الاستتباع أو المقاومة المادية، وأدوات الإخضاع او الاستتباع أو المقاومة الذهنية والايديولوجية، وفي هذا الصراع يمكن موضعة الدور الرئيسي للميديا الإخبارية بوصفها وكيلا لنمط معيّن من المصالح المقترن والمشرعن أيضا بقراءة ايديولوجية معينة أو بسردية محددة، ولأن التحالفات المسيطرة والمستفيدة من تراتبية النظام القائم تكون أكثر استحواذا على الموارد المادية وبالتالي أقدر جذبا للمحترفين، فإنها تنجح في إنشاء (أو الهيمنة على) مؤسسات الميديا الكبرى التي تلعب دورا رئيسيا في تسويق نمط من القراءات الايديولوجية والتصورات الذهنية والمفاهيم والتصنيفات التي بفعل تكرارها وجاذبية قوالبها وبراعتها في لفت الانتباه مستفيدة من تقنيات الصورة ومن المعرفة التسويقية المتراكمة، تتمكن من جعل طروحاتها ليس مقبولة فقط بل ممثلة لما هو صحيح وقائم فعلا في ذهن المتلقي، وهي بذلك تقود الذهنية الشعبية إلى تكييف فهمها للأشياء والعالم من حولها وفق تلك الطروحات كمرجعية يبدو وجودها مسلّما به وغير قابل للمساءلة الاجتماعية لأنّ نقيضه يرمى خارج حيز المفكر به. ببساطة لا يمكن لأي علاقات هيمنة أو استتباع أن تقوم دون وجود أدوات للتثقيف أو للتضليل أو للتحييد الفكري والايديولوجي وهذه العملية تحصل بطريقة تلقائية وطبيعية للغاية لأنها أيضا قرينة بالطريقة التي ينشط بها العقل ويتمثل العالم من خلالها.
لقد أصبح واضحا أنه من العسير إنتاج ميديا محايدة لأن العمل الإعلامي هو عمل ذهنيّ، والذهن لا يمكن أن يكون محايدا، فكل ما يخرج عن الإنسان يكون قد عولج عبر أدواته الإدراكية والمعرفية وخزينها اللغوي والثقافي والنفسي، كما أن كلمة الحياد ذاتها تنطوي على تبسيط إن لم نقل تضليلا، لأن الإنسان لا يقف أبدا في مكان محايد من كل الأشياء، إنه دائما قريب لبعضها وبعيد عن غيرها. لذلك أجادل بان الدراسات الهادفة إلى تقويم الميديا من خلال موضوعيتها وحياديتها لا تزوّدنا أبدا بالأدوات المنهجية السليمة لفهم سلوك الميديا، أو أنها في اقل تقدير يمكن أن تصبح دراسات تعامل الموضوعية ليس كقيمة أخلاقية بل كقيمة مهنية واحترافية، وبالتالي فإن أهدافها ستدخل في إطار تطوير السبل الاحترافية للعمل الإعلامي وليس المراجعة الجذرية لدوره داخل المنظومة الاجتماعية – السياسية. إن فهم الميديا في إطار ما ذكرته من دور بوصفها جزءًا من أشكال وعناصر الصراع الاجتماعي – السياسي سيقودنا بالضرورة إلى فهم آليات عملها وطبيعة توجهاتها وتحليل خطابها بما يخدم فهمنا الكلي لطبيعة الصراع الاجتماعي السائد ونمط العلاقات المشكلة له. | |
|




