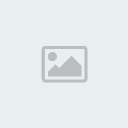
من طرائف العلمانية الرخوة، الاتصال بتاريخ الابستمولوجيا أحيانا، والانفصال عن سيرورة الاستكشاف في العلوم الدقيقة وعن الارتباط الجوهريّ بين العلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية والاجتماعية. لقد قاد التخصص في الإنسانيات، الكثيرين إلى الانفصال عن التقليد الأنواري، القاضي بالربط بين قضايا الطبيعيات والرياضيات والإنسانيات ربطا ضروريا. وممّا لا شكّ فيه، أنّ الحداثة مدينة للعلم الرياضي والطبيعي، في تحقيق كثير من منجزاتها ومكتسباتها، الابستمولوجية والتاريخية والاجتماعية. لم تتمكّن الحداثة من استشكال المواقع التقليدية للفكرانية اليهودية – المسيحية، إلا بعد أن أبانت الفعالية العلمية، عن قدرة كبرى على الاستكشاف وعلى سبر مجاهل الجسد والفضاء والعالم وتقصّيها. لا أنوار بلا تمفصل عميق بين العقلانية والإمبريقية، بلا مداورة إبدالات علمية واجتراح إمكانيات تشابك منهجي بين الطبيعيات والإنسانيات.
إن علمانية مفصولة عن الكون العلمي هي علمانية منبتّة، محكومة بالارتكاس والوقوف عند عتبة التنوير في درجة الصفر في أحسن الأحوال. ليست العلمانية المنفكّة عن مناهج العلم الطبيعي وإنجازاته، إلا نسقا فكرانيا، مفتقرا للخامات العلمية وللصلابة المثودولوجية ولآليات التفكيك واستكشاف سديم النصوص والتمثلات الجمعية. لا مجال لتصوّر العلمانية والحداثة، خارج الإقرار بالاستقلالية الابستمولوجية للعقل، وبتحرّر النص الكونيّ من التأويل اللاهوتي.
وفيما انصرفت العلمانية الرخوة عن العلم الرياضي والطبيعي، أخذت القدامة الصاعدة، في إخراج حقائقها إخراجا فكرانيا، يلتمس السند من العلم الوضعي ظاهرا ويحتويه باطنا. فلئن تمكّنت الحداثة من هزّ أركان القدامة بناء على المفاعيل الانقلابية للعلم الطبيعي، فإنّ القدامة الإسلامية، استعانت بمقتطفات علمية للبرهنة على الحقائق المتعالية لنصوصها المعيارية، في غياب تاريخي للفاعل العلماني المسترخي في رحاب الاغتراب المركب.
وهكذا خسرت العلمانية، أداة أساسية في مسار التعلمن والتعقلن، واتجهت نحو وجهات غير ذات مردود سوسيولوجي أو ابستمولوجي، مثل الإشكالية التراثية، وهي إشكالية دورانية ومعدومة العائدية السوسيولوجية في كل الأحوال. فكيف يمكن تفكيك جزء من حقائق الفكرية الشرعية، من دون إخضاعها لحقائق ومقتضيات العلم الرياضي والطبيعي؟ وهل يمكن تصحيح العلمانية الرخوة في غياب ربط الصلة بالعلم، مناهج ونظريات وحقائق؟ أليس من أوجب واجبات العلمانية الحاذقة، هنا والآن، تفكيك كل أوجه الربط التصالحي بين القدامة والعلم، وإبراز المنحى الانقلابي، ابستمولوجيا ومثودولوجيا، للفعالية العلمية طيلة أزيد من أربعة قرون؟ كيف يستسيغ العلمانيّ الرخو، الاكتفاء بالإنسانيات الرخوة البعيدة عن الإشكاليات الحارقة فيما يتطلب النظر الحداثي الاشتباك مع تلك الإشكاليات، بدءا، والتعامل مع فصولها، علميا حالا، والتدليل على تاريخية الحقيقة التداولية الشرعية والتراثية مآلا؟ أليس الافتقاد إلى المرجعية العلمية، والإكثار من الفكرانيات ومن رخاوة الأفكار الإيديولوجية، ما يفسّر حركة الانتقال المتكرّرة من دائرة العقلانية إلى دائرة اللاعقلانية كما يتضح ذلك من حالات طه حسين ومنصور فهمي وعبد الرحمن بدوي مثلا؟
لا معنى للعلمانية، من دون فكّ الترابط اللاهوتي بين النص المؤسّس والنص الكونيّ، من دون استشكال البناء المعرفي العلمي للنص المعياري. ليس الفصل بين الزمني والديني إلا تجليا لإعادة النظر الجذرية في علائق العلمي بالديني. فكيف يحلّ التجلي أو التمظهر أو الفرع محلّ البؤرة؟ وما معنى علمانية، بلا قوام ابستيمي صلب؟ أليست العلمانية المبيئة أو المتكيفة أو الإجرائية، سلفية مقنّعة، بشهادة أعمال محمد عابد الجابري وحسن حنفي مثلا؟
ففي غياب السند المرجعي العلمي، تغوص الفكرية العلمانية في رخاوة الأفكار المنبتة، وفي تضارب الدعاوى المفتقرة إلى الحيثيات المنهجية والنظرية المتماسكة. وبدلا من أن تكون العلمانية اقتحامية استكشافية مزوّدة بالعتاد الابستمولوجي، المساعد على استكشاف قارة المقدس وعلى تشريح بناءاته المعرفية، فإنّ العلمانية الرخوة تكتفي بتخليق العلمانية وبتسييس مؤدّى النظر النقيض، علما أنّ العلمنة فعل استكشافيّ في المعرفيات، انقلابي في تدبر الإشكاليات، تعقّلي في الأخلاقيات. أليس من باب المفارقة أن نضفي السمة العلمانية على ممارسة خطابية تروم التخليق بدون استشكال، وتستنكف عن تمحيص مؤديات فكرية الآخر بدعوى التسييس؟ والحال أن العلمانية المستجيرة بالتخليق قي مقام الاستشكال، علمانية رخوة أو شكلانية على الأغلب.
كيف يمكن ترسيخ علمانية قوية نظريا وقمينة بالمأسسة، في ظلّ متصوّرات ناطقة بالرخاوة المعرفية أو بإرادة التساكن المعرفي بين ما لا يقبل التساكن مبدئيا، أو باصطناع معازل معرفية متجاورة؟ كيف يمكن إقرار القيم العلمية والعلمانية، في مناخ فكريّ متشبّع بالوجدانيات ولا يسمح في أحسن الحالات إلا بتعيين محاضن معزولة للوجدان والعلم؟
1- الفصل بين العلم والوجدان :
يقول زكي نجيب محمود في محاورة مع عبد الغفار مكاوي ما يلي :
( أقول للشباب ما قلته طوال حياتي المنتجة : أن يعيش حياته في خطين ليشبع بهما جانبي الحياة الإنسانية. عليه أن يتقبل ما هو قائم على التفكير العلمي ثمرة ومنهجا، بمعنى أن يحاول أن يكون ذا منهج علمي بالإضافة إلى تمتعه بثمرات العلم الغربي. ولكن عليه كذلك ألا ينسى لحظة أن هناك جانبا آخر لا ينبغي أن يغفله في أي لحظة، وهو الجانب الذي يتعلق بالذات أو الهوية العربية المتدينة. في هذا الجانب لا مجال لمنهج علمي، ولكن المجال للإيمان كلّ الإيمان بالعقيدة التي نؤمن بها، ويصاحب هذا الاهتمام بجوانب خاصة كاللغة العربية وصور البطولات العربية وأركان الهوية الثقافية التي هي في الحقيقة جوهر العروبة... والحقيقة أن حياتي الوجدانية قد حافظت على الدوام على هذه الهوية بقدر ما تمسكت في حياتي العقلية بالمنهج العلمي فيما لا يمس الهوية. )
(- عبد الغفار مكاوي – تجارب فلسفية – دار شرقيات للنشر والتوزيع – القاهرة – مصر – الطبعة الأولى – 2008-ص. 177-178).
لا تقبل علمانية العزل، المخاطرة الابستيمية ولا مراجعة القواعد المرجعية للمجال التداولي، ولا انتزاع سؤددها المثودولوجي والابستمولوجي في سياق التدافع المعرفي بين الأنظمة المعرفية المتخالفة والمتناقضة. من البيّن إذن، أن التعلمن الوضعيّ، انتهى إلى فصل ابستمولوجي مصطنع بين مجال الاعتقاد الوجداني ومجال المعرفة العلمية والى بناء معازل ماهوية أو جزر مثودولوجية بلا جسور. كما تصدر عن تنميط لا تاريخي للهوية، وتستبعد أي حفر اركيولوجي أو تاريخي انثروبولوجي باحث في تشكل الهويات التاريخية بالشرق الأوسط. فما حسب وجدانا، ليس إلا تواريخ وأزمنة وتحوّلات وأساطير مترحّلة مطموسة التاريخية؛ إنّ للوجدان العروبي، تواريخ وتشكّلات مورفولوجية، من الضروري التنقيب في طبقاتها، للوقوف على نسبيتها وآليات وسياقات تعضيها وأجرأتها عمليا والمنافحة عنها خطابيا.
فالفصل الابستمولوجي والمثودولوجي بين الاعتقاد الوجداني والمعرفة العلمية، يؤشر على محدودية المنهج العلمي، وعلى قصوره النظري عن استكشاف العوالم الملتبسة للاعتقاد وللمعرفة القلبية والهوية الوجدانية. والحال أن المعرفة العلمية، مبنية على إلغاء هذا الفصل وعلى الإقرار المبدئي، باستقلالية العقل وقدرته على استقراء الكون الدلالي للاعتقاد، وعلى تقديم تحليلات نظرية عن طبيعة و أصول الاعتقاد الديني وعن التشكل المعرفي والتاريخي والأنثروبولوجي للمادة المؤسسة للنظر الثيولوجي. ويعزز هذا الاعتبار، اشتباك النصوص المؤسسة نفسها مع الكونيات ومع التاريخيات والاجتماعيات، وهي أحياز فكرية قابلة للتعقل والتدبر المنهجي بلا أدنى شك.
لا يعني رفض استشكال المعرفة الوجدانية، إلا تكريس شيزوفرينيا منهجية، وفصام فكري، واستنقاذ النسق الاعتقادي من عنف الحفر الاستشكالي والتنقيب الجينيالوجي والاستغوار الإناسي في قاراته السفلى المغطاة بسجف اليقينيات التداولية .
2- اختلاف المناهج والمقصديات :
ثمة توجه إصلاحي، يتوخى إبراز الفوارق الدلالية بين النص المؤسس والنظريات العلمية؛ فالنص المؤسس، يقرر اليقينيات الانطولوجية الكبرى ويبث في الانشغالات القصوى للكينونة، فيما تنحصر فعالية العلم الوضعي في استكشاف بنية العالم الفيزيائي أو الكيميائي أو في استقصاء القوانين المتحكمة في بنية الكون. فالدين مخصوص بالمعيارية الأخلاقية والقانونية، فيما يختص العلم بالقوانين الكونية .لا يكمن الاختلاف في المنهجية فقط ، بل في طبيعة المجالين بالدرجة الأولى. وبناءا على هذا، فإن قراءة المعيارية النصية بمنطق القانونية العلمية مرفوضة من هذا المنظور،لأنها قراءة مناقضة لمبادئ الملاءمة والمواءمة ولأنها تفتح النص الضروري على جوازية القانون وتتجاوز موجبات المعهود الثقافي لأمة التأويل. وفي هذا السياق، كثيرا ما يتم استحضار سلطة الشاطبي، لتسويغ هذا الرأي .
يقول أبو إسحاق عن أمية الشريعة ما يلي :
( ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها –وهم العرب – ينبني عليه قواعد :
منها : أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين؛ من علوم الطبيعيات، والتعاليم : والمنطق، وعلم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها . وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصحّ. والى هذا فإنّ السلف الصالح – من الصحابة والتابعين ومن يليهم – كانوا اعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أن تكلم احد منهم في شيء من هذا المدعي، سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يلي ذلك. ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر، لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ؛ إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم. وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا.)
( - أبو إسحاق الشاطبي – الموافقات في أصول الشريعة – شرحه : عبد الله دراز – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – 2001- المجلد الأول – الجزء .2ص60-61) .
وفي نفس سياق العروبة المعرفية للنص المؤسس، يقول محمد سعيد العشماوي ما يلي :
(وبعد استقرار الإسلام، لم يدرك العرب أن نزول القرآن في عبارات ذات صبغة شاعرية و آيات متفاصلة كان لأسباب تخدم أهدافا محددة : هي إعجاز العرب بأسلوبهم، وصب الإيمان صبا في نفوسهم، ومعالجة مواضيع متفرقة، والتنويع في البيان تبعا لظروف الحال. فالقرآن – ككتاب دين يخاطب أناسا ذوي صفة شعرية – لم يكن من الممكن أن يتبع أسلوب البناء التركيبي لأقضية علمية، خاصة مع اختلاف الأمور التي عالجها من قصص ودين وتشريع )
(- محمد سعيد العشماوي- حصاد العقل- دار الانتشار العربي – بيروت – لبنان – الطبعة الثالثة : 2004-ص.108).
ولئن جاز فهم استمساك بعض مداوري خطاب القدامة الكلاسيكية بهذا الدليل ( أشير هنا إلى محمود شلتوت وعائشة عبد الرحمان ومحمد حسين فضل الله )، فإن تمسك بعض العلمانيين بترديده، في أوان إقبال القدامة الفائقة على تأثيل ومأسسة علمية الحقائق المعيارية والمرجعية الإسلامية، يدعو إلى الاستغراب والاستفهام.
فقد أخلت العلمانية الرخوة، بشرط حداثي معياري، هو شرط الاشتغال بالعلوم منهجيات وآليات ومفاهيم، وتشغيل المكتسبات المنهجية والآلية والإجرائية للعلوم الدقيقة والإنسانية والاجتماعية في فهم الظاهرة الدينية والنصوص المؤسسة والمتخيلات العقدية الألفية. وتتضح أبعاد هذا الاستغراب متى، أخذنا بالاعتبار المعطيات التالية :
1- استمرار الانقلابات المعرفية في حقل العلوم الدقيقة،
2- التطورات المنهجية في مقاربة العلوم الإنسانية والاجتماعية للمقدس وللظاهرة الدينية،
3- استعانة القدامة الكلاسيكية والفائقة المؤسسية بالعلوم الدقيقة للبرهنة على صحة مرتكزاتها النظرية وتأويلاتها وتسويغاتها المعيارية.
وهكذا بدلا من الانشغال بعلائق العلوم الدقيقة والإنسانية والاجتماعية بالنصوص المؤسسة وبالأبنية الرمزية للاعتقاد والشعائرية الإسلامية، ينصرف العلماني الرخو إلى مضمار التراثيات أو إلى تقديم شذرات من تاريخ الفكر الحديث، لتأصيل العقلانية والعلمانية ولبناء الحداثة الطرفية على أسس تاريخية أو تراثية. وهكذا انتهى العلماني الرخو، إلى علمانية تراثية، مقطوعة عن السند الابستمولوجي وعن المدد المثودولوجي للنظريات العلمية الحديثة، والى انشغال هوسي بالتبيئة والتكييف والتأصيل على حساب التحويل الابستمولوجي والقلب المنهجي ورسم خرائط طريق الانقطاع لا المعرفي فقط بل الايطيقي كذلك عن المرسخات المتقادمة، نظريا وعمليا.
ولئن سعت العلمانية الرخوة، إلى التماس الهدنة الابستمولوجية والى تعيين معازل فكرانية، فإن القدامة الفائقة، سوف تذهب بعيدا لا في التأسيس النظري لعلمية القول المؤسس فقط، بل لمأسسة العلمية الفائقة للنص المؤسس .وعوض تفكيك دعاوى القدامة الفائقة، والإبانة عن افتقارها إلى الملاءمة والاتساق والكفاءة التدليلية أو الاستدلالية و المتانة البرهانية، اكتفى منظرو العلمانية الرخوة، بالاستنكاف عن الاشتباك مع المادة الكونية في النصوص المؤسسة واستشكال محتوياتها الإخبارية والتقريرية والبرهانية بناء على مقررات العلم الطبيعي.
من البديهي إذن، أن تنتهي العلمانية الرخوة المنقطعة عن التقليد الأنواري أولا وعن التقليد النهضوي ثانيا ( شبلي شميل وإسماعيل مظهر في طوره الأول مثلا )،إلى الانحصار في الإشكاليات المغلقة وفي الافتقاد إلى العتاد الإجرائي والآلي العلمي.
تقع القدامة الفائقة في مفارقة كبرى إذ تسعى إلى الجمع بين الإقرار بالقصور النظري للعقل البشري وأخذها بنتائج العلوم الدقيقة في سياق منافحتها عن أصولها المؤسسة .وهكذا تمكنت من تحويل العلوم الدقيقة إلى سند فكراني، لمتخيلها الألفي ولفكريتها المناقضة جوهريا، لأساسيات العلم النظرية والمعيارية. وبدلا من تشريح هذه المفارقة، وإبراز المفارقة النظرية الكبرى الثاوية خلف نظريات المؤالفة بين المنقول والمعقول العلمي، اكتفت العلمانية الرخوة، بمصارعة القدامة الفائقة في مضامير إشكالية مبدئيا، أو في مجالات بلا مردود علمي ولا سوسيولوجي أو بالتماس السند من مرجعيات تراثية ملتبسة الوضعية المعرفية والمنهجية والتاريخية ( الاعتزال والرشدية والخلدونية مثلا ).
وهكذا تمكنت القدامة الفائقة عبر استعمالها الدقيق للذرائعية المنهجية وللاقتباس التقني الموجه، من إعادة تأهيل، منهجي وسوسيولوجي، للجهاز العلمي للنصوص المؤسسة، ومن إلغاء كل استشكال نظري لذلك التأهيل .وكان من نتائج الانقطاع عن الاستشكال العلمي لبنى المقدس الإسلامي، أن صار الوضع الدليلي للعلمانية الرخوة أقل استشكالا حتى بالقياس إلى بعض المناولات الاستشكالية التراثية.
يقول أبو إسحاق الشاطبي :
( ومنها : ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول، وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها : كالمنكرين لعذاب القبر، والصراط، والميزان، ورؤية الله عز وجل في الآخرة . وكذلك حديث الذباب وقتله، و أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، و أنه يقدم الذي فيه الداء . وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول.)
( - أبو إسحاق الشاطبي – الاعتصام – تحقيق : هاني الحاج – المكتبة التوفيقية –الجزء الأول – ص.222)
3- غياب الاستشكال العلمي للطقوسية :
تظهر العلمانية الرخوة كثيرا من الحذر في مقاربة البؤر المعرفية والسلوكية في القدامة الكلاسيكية والفائقة على حد سواء؛ وعوض الانكباب على تفكيك النسق المعرفي القدامي وتشريح نسقه الشعائري، ينصب الخطاب العلماني الرخو، على تجنب إشكاليات البؤرة والاكتفاء بإثارة النقع الفكراني أو التنقيب في التشكل الابستمولوجي أو الإيديولوجي للأبنية النظرية التراثية .فلا يمكن تفكيك بنية القدامة الفائقة، دون تشريح النسقية الطقوسية – الشعائرية، والكشف عن التشكل المعرفي للمعرفة الشرعية. والحال أن العلمانية الرخوة، تنسى أن لا علمانية بلا تنوير ولا تنوير بدون الاستعمال الأقصى للعقل في تناول إشكاليات الوجود الإنساني. لا مناص كذلك من نزع البداهة والأسطرة عما يبدو للمتخيل الجمعي بديهيا ومقدسا، وإعادة ترتيب الوضع الابستيمي لكثير من المرسخات الفكرية والمكرسات السلوكية.لا عقلانية إذن، من غير استشكال البداهة المعرفية القدامية واستكشاف المملكة الترميزية للطقوسية. ومن طرائف العلمانية الرخوة، الإكثار من الخوض في الكلاميات والعقلانية التراثية، والنأي عن العالم الدلالي للطقوسية الإبراهيمية علما أن العلوم البيولوجية والأنثروبولوجية تقدم أدوات هامة لمقاربة الفضاء الرمزي لهذه الطقوسية المركبة. والواقع أن علمانية تستنكف عن استكشاف الكون الدلالي للاعتقاد وتركيبة النسق الطقوسي، اعتمادا على مفاهيم وآليات العلوم الدقيقة والإنسانية والاجتماعية، ليست علمانية رخوة فقط بل هي علمانية مع وقف التنفيذ النقدي في أفضل الأحوال.
وبدلا من الانكباب العلمي على النسق العقدي، استكشافا وتعقيلا واستشكالا، بناء على الموجهات الابستيمية للعقلانية العلمية، يبتعد الخطاب العلماني الرخو عن هذا الفضاء كليا، مفضلا الاشتغال على النصوص الثواني أو الكتابة في تاريخ العلم أو في تحولات الابستمولوجيا الحديثة. والغريب في أمر هذه المشهدية الفكرية، هو انتقال القدامة من الرفض النسقي أو التقني للعلوم الدقيقة إلى استثمارها واستعمالها في تسويغ لا التدبر السمعي للنواميس الكونية فقط بل إلى "تعقيل" الطقوس نفسها. لقد برهنت القدامة الفائقة عن كفاءة ذرائعية في استثمار نتائج العلوم الدقيقة فكرانيا، وفي توسيع نطاق حقائقها السوسيولوجية، فيما بقي العلماني الرخو، سادرا في الفصل بين مجال الاعتقاد والأخلاق ومجال العلم والتعقيل.
يقول فؤاد زكريا :
(ومعنى ذلك بعبارة أخرى، أن القيمة الحقيقية للشعائر إنما تكمن في تلك القوة المعنوية التي تمكن الإنسان من مواجهة الظلم والطغيان، والسعي إلى أداء عمل نافع للمجتمع، أما التركيز على شكلية الشعائر دون اكتراث بما تؤدي إليه من مضمون، فهو في حقيقته تستر على المظالم ومساندة للاستبداد.)
( - فؤاد زكريا – الصحوة الإسلامية في ميزان العقل- دار التنوير – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 1985-ص. 23).
تتغلب النزعة التخليقية على هذا الشاهد، وتغيب النزعة التعقيلية والتعليلية؛ والحال أن المقام السوسيولوجي والمعرفي يقتضي استكشاف الكون الرمزي للطقوسية الإسلامية، لا الاكتفاء بمردودها الأخلاقي والوظيفي فقط. فمن غرائب العلمانية الطرفية، النأي عن أي استكشاف أو استشكال، للمتخيل القدسي وعن تاريخ الممارسة الشعائرية، والفصل الابستمولوجي بين حيز الوجدان والإرادة وحير العقل والفاهمة.
ولئن حصر رائد التفكير العلمي نظره في الفعالية الأخلاقية للشعائر، فإن رائد العلمانية التجديدية، سيكتفي بإضفاء صفات عرفانية باطنية وتجاوز الأفق الفقهي للطقوسية الإسلامية جملة فيما يدنو من العرفانية بدون أدنى ريب.
( إذا فهمنا هذا، يتضح لنا أن المعصوم، حين قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " كأنما قال بلسان العبارة " قلدوني في صلاتي بإتقان، وبتجويد، حتى يفضي بكم تقليدي إلى أن تكونوا أصلاء مثلي"، أو كأنه قال : " قلدوني بإتقان، وبتجويد وبوعي تام، حتى تبلغوا أن تقلدوني في أصالتي".. غير أنه ليس في الأصالة تقليد ..ولكن فيها تأسّ " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " " أسوة " قدوة في كمال حاله.
فالنبي آتانا بلسان الشريعة – لسان المقال – أمرا بالتقليد، وآتانا بلسان الحقيقة – لسان الحال – أمرا بالأصالة.. ولا تكون الأصالة إلا بعد تجويد التقليد ..فالأصالة غاية من تقليدنا النبي، وليس التقليد غاية في ذاته.)
(-محمود محمد طه – نحو مشروع مستقبلي للإسلام – المركز الثقافي العربي –بيروت- دار قرطاس – الكويت - الطبعة الأولى – 2002-ص. 255).
يعلن خطاب الأصالة والعلمانية الإسلامية عن انزياحه عن القدامة الكلاسيكية وعن القدامة الفائقة استتباعا، ويجتاف كثيرا من المتصورات النظرية للحداثة الكلاسيكية ظاهريا، إلا أنه لا ينتج خطابا علميا عن ينبغياته النظرية والعملية، بل يكتفي بإعادة التدليل، عبر آليات ومفاهيم عرفانية، عن منظوره الاستشرافي النشوري.
لا مجال هنا، لتأسيس تاريخية وفينمينولوجيا أو انثروبولوجيا الصلاة الإسلامية، ولا عن آليات تشكل واندغام هذا الطقس في الجسد النظري للعقيدة وفي التفاعل العضوي للجماعة المؤسسة وفي المصير التاريخي للأمة.
ورغم تشكك خطاب العلمانية النقدية في تاريخية بعض المرويات المتعلقة بالصلاة، فإنه يكتفي بالتفكير في ملاءة هذا الطقس لتحولات العصر وتعددية الفضاءات المجالية والثقافية في زمان العولمة والحداثة الفائقة. والحال أن التطلب العلماني، يستوجب البحث عن انبناء النسق الطقوسي وتارخيته واشتراطاته البيولوجية والنفسية وأبعاده الأنثروبولوجية لا الاكتفاء بالتلويح بالتوافق والتآلف مع المقتضيات الحداثية للأزمنة الحديثة.
(والمهم أن النبي كان يؤدي صلاته على نحو معين، فكان المسلمون يقتدون به، إلا أن ذلك يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو، على فرض أنه كان فعلا موحدا ولم يطرأ عليه أي تغيير أثناء فترة الدعوة، وإلا كان سكان شمال الكرة الأرضية، حيث يطول النهار صيفا حتى لا يكاد يوجد ليل ويقصر الشتاء حتى لا يكاد يوجد سوى الليل ، غير معنيين برسالة محمد كالذين يعيشون في المناطق المعتدلة التي لا فرق فيها كبير بين طول النهار صيفا وشتاء، وكذلك الذين يعيشون في المجتمعات الصناعية حيث تفرض مقتضيات الآلة أنساقا في الحياة والعمل لا صلة لها بأنساق الحياة والعمل في المجتمعات الرعوية والزراعية والتجارية، وبصفة أعم كل من بعدت أنماط حياتهم المعقدة عن بساطة أنماط الحياة التقليدية .)
( - عبد المجيد الشرفي – الإسلام بين الرسالة والتاريخ – دار الطليعة – بيروت – لبنان –الطبعة الأولى – 2001-ص. 62)
فإشكالية النص إشكالية ملاءمة وتحديث، فيما ينصرف المجهود العلمي إلى استقراء الإواليات البنائية للطقوسية الإسلامية والى تاريخ تشكلها وسياقاتها الجينيالوجية. ولا مناص هنا، من البحث في تاريخية هذه الطقوسية وفي سوابقها وأشباهها في الطقوسيات السامية وفي الشعائريات العرفانية والتعديدية وفي العلائق التركيبية الموجودة بين النصي والجسدي، بين البيولوجي والنفسي، بين متخيل الفرد ومتخيل الجماعة في أداء هذه الطقوسية وإدماجها في عصب الكينونة الاجتماعية. لقد انشغل العلمانيون كثيرا بالعقل العربي – الإسلامي، إلا أنهم لم يظهروا أي اهتمام بالطقوسية الإسلامية، رغم ثقلها وكثافة مدلولاتها الانثروبولوجية والسوسيولوجية والنفسية.
والغريب في هذا المقام، هو استفاضة القدامة الفائقة قي البرهنة على علمية الطقوسية الإسلامية،علما أن أصولها الكلامية والفقهية، تقر بغيبية التكاليف والشعائر والطقوس الإسلامية جملة.
( والثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل منها وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره، و الحج، ونحو ذلك.
فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية .)
( - أبو اسحاق الشاطبي – الاعتصام – تحقيق : هاني الحاج – المكتبة التوفيقية –الجزء الثاني – ص.464-)
لم تكتف القدامة الفائقة بالتسويع العلمي للنصوص الكونية، بل انبرت لتسويغ الطقوسية نفسها علميا، استنادا إلى تدليلات وبراهين مستقاة، من اضبارة العلوم الدقيقة. ومن الطبيعي أن لا تسفر هذه التسويغات البعدية عن منجزات ابستمولوجية معتبرة، ولا سيما إذا علمنا أن المقصدية الثاوية وراءها هو الذب عن قداسة النصوص المؤسسة واحتواء سلطة العلم الوضعي والمنهج التجريبي .لقد ذهب القداميون بعيدا، في انتحال الصفة العلمية وفي مأسسة علمية النصوص مهما كانت نوعيتها الخطابية ومقاماتها الوجودية وسياقاتها التاريخية ، في غياب شبه تام للعلمانية الرخوة المنشغلة إما بالتجريب المنهجي أو النظري أو بالتعاطي الهجاسي مع قضايا تراثية أو بالاشتغال الفكراني بالتسييس أو التخليق.
4- رفض الماركسية المعربة لاستشكال بنية الاعتقاد :
وثمة اتجاه آخر، يلغي سؤال البنية والتشكل ليكتفي بسؤال الوظيفية الوجودية؛ لا يمكن من منظور هذا الاتجاه، تناول البناء الابستيمي للدين، وتشكله المعرفي والتاريخي ومحتواه الأنثروبولوجي، بل يجب التركيز على الوظيفية الوجودية أو السيكو- اجتماعية للتدين ولما سماه بيتر سلوتردجيك بالنسق المناعي الرمزي عموما. ويرافق هذا التقدير المنهجي، التشكيك في جدوى المقاربة العقلانية والعلمية" للشيء" الديني، وإنكار تاريخ النقد الفيورباخي والماركسي للاغتراب الديني ولما سماه ماركس بـ"الشمس الوهمية".
( رسمت الماركسية إشكاليتها في تفسير الظاهرة الدينية بطرح السؤال : لماذا يحتاج البشر إلى الدين؟ ومحاولة الإجابة عليه. وقد وجدت الجواب في شقاء البشر. رأت إلى الدين على أنه وسيلة فذة من وسائل تعامل البشر مع الشقاء على هذه الأرض. بالدين يتحمل البشر الشقاء ويهربون منه ويقاومونه ويأملون بالخلاص منه ويرتضونه في آن معا. مع ذلك، يجري التعاطي مع كل غنى التفسير الماركسي للظاهرة الدينية على طريقة "لا تقربوا الصلاة.." أي باختزال كل هذا التفسير بعبارة واحدة هي "الدين أفيون الشعوب".)
(-فواز طرابلسي – عكس السير – كتابات مختلفة – رياض الريس للكتب والنشر –الطبعة الأولى – 2002-ص. 169-170).
يفصح هذا النص عن إرادة الطمس واللااستشكال والابتعاد عن أي مقاربة علمية للإشكالية الدينية ؛ ولعل التضامنات الجماعية والبحث عن نظام مناعي جماعي، هما اللذان يفسران هذا الاهتيام "بالسعادة الوهمية للشعب" وتحويل السلب النقدي في المتن الماركسي إلى إيجاب منافح في الهامش الاعترابي.
لا يمكن طرح سؤال النجاعة العملية للاستشكال، في غياب النقد المعرفي والعلمي، لبنية المعرفة الشرعية وللإبدال القدامي. وهي مهمة لا يمكن أن تحققها لا التوجيهات ولا التوجهات الفكرانية، ولا المقاربات الذرائعية المنشغلة بالوقع وبقراءة سطوح المشهديات الكونية ولا الذهول عن الدينامية التعقلية السارية في الأكوان الرمزية للكتل المناعية الكبرى منذ القرن السابع عشر على الأقل. أليس التنقيب عن التواؤم القسري مع العلم بعد طول ممانعة ورفض لأبجديات العلم( أشير هنا إلى موقف الكنيسة الكاثوليكية من غاليلي وداروين وموقف الإسلاميين المتعالي من التقانة في بداية المثاقفة النهضوية مثلا ) بمثابة " تمنيع " للذات بوسائل الغير؟ فالانتقال من المناعة والممانعة إلى "التمنيع"، دليل لا تخفى مراميه عن فعالية الاستشكال المعرفي للمعارف القدامية المنتجة في سياق الفكريات المناعية التقليدية. ألا ينطوي "التمنيع "على ترميق منهجي وعلى تغييب كلي لمبدإ التحوط المعرفي في سياق تدافع المعارف وتوالدها الانشطاري المستمر؟ ألا يكرر" التمنيع" الاعجازي المعاصر نفس خطايا "التمنيع" في زمن النهضة؟
( وحققوا أن الأرض منفتقة في النظام الشمسي والقرآن يقول : (أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما).
وحققوا أن القمر منشقّ من الأرض والقرآن يقول : (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ). ويقول : (اقتربت الساعة وانشق القمر).
وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول : (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن).)
( - عبد الرحمن الكواكبي – طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد – منشورات الجمل – كولونيا – ألمانيا – بغداد – الطبعة الأولى – 2006-ص.36)
لقد جرت مياه إعجازية كثيرة تحت الجسر بعد عبد الرحمن الكواكبي، واكتفت العلمانية الفاترة أو المتكيفة بالابتعاد جملة عن استشكال الخطاب المدبج في مديح علمية الحقيقية الشرعية. فالعلمانية لا تتأسس إلا بفصل الخطاب فيما يؤسس الانفصال بين البيان والبرهان.




