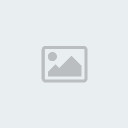
قد تكون العلاقة بين المصادفة و الضرورة في الفيزياء من الناحية الابستمولوجية المعرفية علاقة جدلية حيث يبدو التساؤل عنها من منظور كونيّ لا معنى له، فمثلاً نجد أن تحوّل نجم كونيّ إلى ثقب أسود ضروري من الناحية النظرية عندما يبلغ معدل كتلته الحد الحرج، ولكنّ بلوغ هذا الحد نفسه ما الذي يحكمه؟ إنه ناتج عن كتلة الذرات الأولية التي تجاذبت تثاقلياً لتكوين النجم، ولكن ما الذي يحكم عدد هذه الذرات وكتلتها الثقالية مجتمعة، إنها تساؤلات مقبولة منطقياً ولا بد أن تقودنا في النهاية لأن نقول أن الشروط البدئية رجحت احتمالا معينا، هذا الاحتمال المرجح لم ينشأ من ضرورة منطقية فهناك احتمالات أخرى لا يوجد منطقياً ما يمنع حدوثها، لقد نشأ من مصادفة رجحت ضرورة معينة تحكم سيرورة هذا النجم. ولعل انبثاق الكون بانفجار عظيم دون سبب معين يؤكد العلاقة الجدلية التي تقول أن الضرورة قد تنبثق من قلب المصادفة نفسها. وقد تزايد في السنوات الأخيرة إلى حد بعيد عدد العلماء الذين بدؤوا بدراسة سرّ نجاح التفكير البشري في سبر أغوار الكون والمادة، هل كان نجاحنا ضربة حظ، أم أنه كان من المحتم أن تعمل تلك المتعضيات البيولوجية التي نشأت في النظام الكوني على أن تعكس ذلك النظام في قدراتها الإدراكية؟ وهل التقدم الرائع مجرد صدفة عرضية في تاريخنا أم أنه يشير إلى صدى عميق وذي مغزى بين العقل الإنساني والنظام المستبطن للعالم الطبيعي، وهل نحن مقبلون على حقبة من التشظي بدأت بوادر معالمه المحسوسة منذ أربعة قرون خلت ثم عادت من جديد مع فجر العلم الحديث ممثلة بالثورة الفيزيائية على وجه الخصوص؟ وأبسط ما يقال أن ثمة جانبين من جوانب هذا التشظي مغزاهما ودلالاتهما معروفتان على نطاق واسع، الجانب الأول يتعلق بوضع الإنسان في هذا الكون وإدراكه له، بينما يتعلق الجانب الثاني بالنواتج المهيمنة للتكنولوجيا الحديثة، يترك الجانب الأول تأثيره على العقل، بينما يؤثر الجانب الثاني في الحياة بأسرها.
ولكن في المقابل نجد أن هناك تشظيا من نوع آخر لم يلاحظ كثيراً يتصل بتحول عميق في العلم وفي الفهم أيضاً، ذلك التحول الناتج عن التوجه نحو المزيد من القوانين والانتظام التي تلتقي معاً لتمثل كتلة موحدة، ومع الثورة الحديثة في الفكر العلمي فإن هذا التشظي أصبح كائنا هناك أيضاً حيث أضحت تلك القوانين مستغلقة تماماً على الفهم إذا ما نظرنا إليها بعيون العقل العادي أو الفلسفة الكلاسيكية، حيث نُظر تقليدياً إلى التفسير العلمي على أنه تفسير سببي، وإن تفسير واقعة لم يكن ليعتبر علمياً حتى يشار إلى أسبابها القريبة والبعيدة، لكن الإجابة عن أسئلة “لماذا” لا تحتاج أن تكون سببية كي تكون علمية، على الرغم من أن التفسير السببي يشكل جزءاً هاماً من التفسير العلمي في حالات كثيرة، صفوة القول أنه كلما كانت معارفنا أكثر وأكثر كلما بدا أن ما نفهمه أقل وأقل. وقد لا تكون المصادفة تعبر عن جهلنا بقدر ما تفعل الضرورة التي اعتدنا بحكم العادة على أن نفسر بها كل ما نراه وما لا نراه تفسيراً آلياً لا يمكن وفقه تصور أي حدث قد يحدث بشكل غير متوقع وكأن العالم يسير وفق تصوراتنا المنطقية له، وقد تناسينا أن ادعاء القدرة على تفسير كل شيء هو رفض مسبق لقبول كل ما هو جديد وغير معروف، و لعل ما يدهشنا حقاً هو أن نعرف أن جميع قوانيننا الفيزيائية المستخدمة مستخلصة من تجارب عديدة على امتداد قرون، ولكن هذه التجارب كانت تنجز بمادة اعتيادية ابتداءً من تجارب فرانكلين على طائراته الورقية انتهاءً بتجارب المجلس الأوروبي للبحث العلمي النووي المسمى (سيرن) في مسرعاته النووية، وهذا الذي ندرسه ويدهشنا لا يؤلف سوى 10 بالمائة فقط من مادة الكون، وما عدا ذلك مادة مظلمة غير مرئية لا نعرف عنها شيئاً غير وجودها، فهل والأمر كذلك يمكننا أن نكون على ثقة بصحة جميع قوانيننا؟ يقول هوفمان مؤلف كتاب نظرية الكم وقصتها الغريبة أنه وبكل صراحة ما من وسيلة مُرضية بلغة المكان والزمان والسببية تكون صالحة لوصف العمليات الذرية الأساسية في الطبيعة، ثم إن نتيجة التجربة على جسيم ذري بمفرده هي بوجه عام لا يمكن التنبؤ بها، بل كل ما يمكن أن نعرفه مسبقاً هو مجموعة من النتائج الممكنة المختلفة، إلا أن النتيجة الإحصائية التي نصل إليها بعد ما ننفذ هذه التجربة عدداً كبيراً من المرات يمكن أن نتنبأ بها بيقين تقديري. كما يقول فاينمان بأن العلم ليس يقينياً، فما دمنا نصدر الفرضيات في مجالات لم نفحصها بعد بأنفسنا فنحن بالضرورة في حالة شك، لكننا لا بد أن نقدم باستمرار آراء في مجالات مجهولة وإذا لم نفعل لا نستفيد، إن علم الفيزياء هو دائماً ملون بنفس الفرشاة فالأفكار الجديدة تبدو غريبة وغير مًرضية، ولكن وبعد أن تخترق جلدك وتعشش في روحك، تبرز لديك جماليات جديدة، وأسلوب لنظرة جديدة ورائعة للطبيعة لا يتوقف عند إعطائك رؤية أفضل، ولكنه يمنحك فرصة إلى النظر للمسائل بعمق.
من هذه التساؤلات ينبغي أن نفهم أن فكرة الاحتمال قد نشأت وتبلورت في بادئ الأمر من تصور المصادفة، والمصادفة هي الفكرة المضادة للضرورة، رغم أن ذلك لا يترتب عليه أنها نفي للضرورة أو إنكار لها، فقد افترضت المذاهب الفلسفية القديمة أن الارتباط بين السبب والمسبب إنما هو ضرب من علاقة منطقية بين مقدم وتال، لذلك كان العالم عندهم لا بد وأن يكّون نظاماً منطقياً أو نسقاً منطقياً واضحاً، وإذا عُزل أي شيء عن هذا النسق المنطقي الذي يعتمد عليه فإنه يصبح غير كامل، على اعتبار أن كل شيء يرتبط بالآخر رباطاً منطقياً، أما الوجهة المخالفة لذلك فترى أن ليس ثمة علاقة سببية إلا بمعنى التعاقب المنتظم للأحداث، حيث العلاقات السببية لا تتضمن ضرورة منطقية، بل تتابع زمني للأحداث تفرضه العادة لا المنطق، من هذين الاتجاهين نفهم الرفض الواضح من أصحاب الاتجاه الأول لمفهوم المصادفة، والقبول المبدئي له من الطرف الثاني، وهناك مجموعة من المفاهيم التي يجب توضيحها قبل البدء بسرد الأفكار، فأولاُ يجب التأكيد على أن المصادفة في الطبيعة لا يجب أن ننظر إليها باعتبارها مفهوما يرتبط بالعشوائية، بل إنها ليست إلا نتاجا ليس قبلياً لشروط بدئية، تلك الشروط بدورها ليست إلا إمكانات تفرز حدثا معينا، كما لا يجب لنا أن نغفل بأن هذه الشروط البدئية نفسها ليست حتمية أو سببية بالمعنى المتعارف عليه فيزيائياً أو فلسفياً لهذه الكلمة، إنها نتاج حدث متفرد خارج حدود ما نسميه الآن بالقانون، فإذا قلنا مثلاً بأن للمصادفة دوراً في حدوث حادثة معينة في الطبيعة، فليس معنى ذلك أن التغيير الذي حدث في هذا الموضع من الطبيعة يمكن أن يؤدي إلى أي شيء، ولكن المقصود هو أن ما حدث أمراً لا يمكن التكهن به لأنه ببساطة غير مرتبط بالحالات العادية للظاهرة التي تعرضت للحادثة، فسيادة المصادفات الموضوعية كأساس للفيزياء الحديثة لا يعني بالضرورة عجز العقل الإنساني عن السيطرة على الواقع الخارجي سيطرة نظرية وصناعية، بل إن العقل من خلال معرفته بقوانين المصادفة وتحديده لضروراتها يحقق سيطرته على الواقع ويجعل من إمكانيات المصادفة اللامحدودة ظواهر موجهة تخضع لإرادته الواعية، بتعبير آخر نقول أن المصادفة كواقعة موضوعية لا تجعل من ظواهرها خروجاً عن الضرورة والعلّية والحتمية، وإنما هي تتحد معها جميعاً في مفهوم مجالي عواملي أكثر موضوعية واستيعاباً لإمكانيات الواقع من التحديد الميكانيكي الانعزالي.
ووفقا لتقليد قديم يعود إلى سكتوس إمبريقوس، فقد تمت المطابقة بين القانونية، أي الاتفاق مع القانون، والسببية، كما لو أنه ليس ثمة أنواع أخرى ممكنة من القانون العلمي سوى القوانين السببية. وقد جارى هذا الخلطَ مفكرون من الطراز الأول حتى بعد شيوع اكتشافات القوانين اللاسببية – كقوانين البصريات الهندسية والترموديناميك والقوانين الإحصائية والقوانين الغائية للمادة الحية أو القوانين الجدلية للتاريخ البشري، وقد لاحظ هلمهولتز، في عمر متأخر، أنه في أعماله الشهيرة التي أجراها أيام الشباب قد ترك نفسه عرضة لتأثير قوي من كانط. وفقط فيما بعد، أدرك أن مبدأ السببية ليس سوى افتراض وجود القانونية في الظواهر الطبيعية كافة، وقد اعتبر مؤسس حلقة فيينا موريس شليك أن قوانين الطبيعة اتجاهات وقواعد سلوكية وإجرائية للباحث الذي يقوم بالاستقصاءات، وطابق أيضا بين السببية والقانونية عندما كتب ما يلي: “إن السؤال عما إذا كانت السببية موجودة يمكن تأويله وحسب كسؤال عما إذا كان القانون الطبيعي موجودا. فمبدأ السببية بحد ذاته ليس قانونا، إنه يعبر فقط عن حقيقة أن القوانين موجودة”.
وعلى الرغم من أن الفيزياء الإحصائية عمرها قرن تقريبا، فما زال ممكنا قراءة عبارات وجمل تنص على أن هناك تعارضا غير قابل للتسوية بين قوانين الطبيعة الأصلية والقوانين الإحصائية – كما لو أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون قوانين للطبيعة أو أنها ليست قوانين على الإطلاق، بل هي مجرد انتظامات إجمالية، طالما أنها لا تمكننا من التنبؤ بالأحداث الفردية على نحو يقيني. وحتى إدنغتون لم يستطع الاعتراف بوجود قانون للمصادفة لأن مثل هذا القانون يتعارض مع عقلانيته الفيثاغورية. وقد اعتبر عدد من المفكرين، منذ القرن الثامن عشر، أن المصادفة ليست سوى عنوانا لجهلنا بالقواعد الصارمة للسببية، وليست نموذجا من الوجود الموضوعي يعبر عنه نمط جديد من القانون، فهؤلاء لم يستطيعوا أن يستسيغوا الفكرة القائلة بأن الفيزياء عندما تخلت عن الفيزياء الكلاسيكية ومبدأها المألوف في الضرورة، فإنها لم تقصد وراء ذلك الاستغناء عن الحتمية كلياً، بل رفض الفهم الميكانيكي لها، والمصادفة لم تفهم سابقاً قط إلا بحسبانها طرفاً يقابل الضرورة ويستبعد كل منهما الآخر، و نحن ما زلنا نعزو للمصادفة ما خفي عنا، فهي بالنسبة لنا ليست إلا علة وهمية ابتدعها جهلنا، وإذا كانت المصادفة هي نتيجة لعدم كفاية معرفتنا كما قال اسبينوزا ، فإنها لا بد أن تختفي وتتراجع كلما ازدادت هذه المعارف، وعليه فإن المصادفة وفق هذا التصور ليس لها وجود خارجي موضوعي، بل وجود ذاتي يتعلق بكم المعارف الموجود لدينا، ويعتقد بأن عالماً مثل غاليليو أو ديكارت أو لايبنتز أو نيوتن عرفوا المصادفات أكثر مما عرفها أرسطو، إلا أنهم تجاهلوها كما تجاهلها أرسطو قبلهم، وإن كانت أسباب ذلك التجاهل مختلفة، فالمصادفة في فيزياء أرسطو خارج مجال فلسفته الطبيعية لأنها لا تصدر صدوراً مباشراُ عن غائية الطبيعة، أما عند مؤسسي الميكانيكا التقليدية فلم يكن للمصادفة أهمية تذكر بسبب أنهم كانوا يبحثون عن رد الطبيعة بمجملها لحركات أولية منتظمة، والمصادفة عندهم عملية عشوائية في جوهرها معقدة وغير منتظمة ، والسبب في تلك النظرة يكمن في أن الفيزياء ذات الطبيعة الميكانيكية والفلسفة القائمة عليها استبعدت المصادفة بطبيعة بنائها النظري، كما كان التفكير اللاهوتي يستبعد المصادفة لطبيعة عملياته الغائية، وما كان يمكن أن تتضح دلالة موضوعية سليمة للمصادفة قبل النتائج الفيزيائية الأخيرة للنظرية الحركية للغازات ونظرية الكم، والتي من خلالها يمكننا تصور المفهوم الحديث للمصادفة، وفيه يجب أن نبتعد عن الخلط التقليدي بين الضرورة والموضوعية، فالضرورة بالمعنى التقليدي هي أهم وجوه الموضوعية بل هي أساس للموضوعية، لكن ما لم يُركز عليه هو أن المصادفة أيضاً هي أحد وجوه الموضوعية، ولو أننا تخلصنا من الفهم الميكانيكي التقليدي الذي يوحد بين الضروري والموضوعي، لوجدنا بأن المصادفة أيضاً هي عنصر مقوم ومكوّن للموضوعية كما الضرورة على السواء، وهذا ما حدث تماماً في الفيزياء الحديثة حيث لم يعد القانون ترابطا حتميا بين الظواهر بل أصبح التصور احتماليا فقط، وإمكانية التنبؤ ضمن الاحتمال لم تستبعد تماماً في هذه الفيزياء، فالقابلية للتنبؤ قائمة فيها، إلا أن هذه القابلية للتنبؤ لم تعد مرتبطة بحدود الفردية، وإنما أصبحت ذات مدلول إحصائي تتوقف على مجال الظاهرة و ارتباطاتها، فمصير القابلية للتنبؤ في الفيزياء الحديثة تماماً كمصير الضرورة والعلية والحتمية لم تتقلقل ولم تغرب عن الفيزياء وإنما اتخذت مدلولاً جديداً غير ميكانيكي، مدلول يرتبط بالمجموع لا بالفرديات وبالواقعات المتفاعلة لا بواقعات جزئية منفردة، فحتى العالِم المقتنع بصواب التوصيفات الحتمية سيتردد على الأغلب من استنتاج أنه في لحظة الانفجار الكبير، وهي لحظة وجود الكون كما نعرفه كان تاريخ إلقاء هذه المحاضرة مدوناً مسبقاً في قوانين الطبيعة، فسيرورة الاكتشاف العلمي ليست مجرد انعكاس للوقائع بواسطة الاستقراء، بل هي عمل شاق دؤوب من إعادة الصياغة التجريبية و التي لا تحيط أبدا بكامل الشيء في ذاته مهما نفذت إلى أعماقه، إن التراكيب (الفرضيات) التي تدعى قوانين علمية، أي ق2، هي إعادة بناء متغيرة للقوانين الموضوعية ق1 في المستوى النظري: إنها لا تتطابق كليا مع القوانين الموضوعية ق1. والتطابق الجزئي، أو بعبارة أفضل هذه العلاقة الملتبسة بين ق1 و ق2، ليس حالة ناشئة عن الضعف البشري أو عدم النضج، بل هو نتيجة لحقيقة أن الاكتشاف العلمي هو إعادة صياغة أكثر مما هو انعكاس مرآوي، فمعرفتنا بالشروط الابتدائية هي دوماً ممزوجة مع بعض من عدم الدقة، ولا يمكننا تمييز الشرط الابتدائي الفعلي من بين العديد من الشروط الابتدائية الوهمية القريبة منه وبالتالي لا نعلم أي التوقعات الممكنة هي الصحيحة، وتنوع عالمنا المذهل يفترض ضمنياً احتوائه على إمكانات لا متناهية من صور الوجود والحركة والحياة والتطور، وقد كانت الأشياء في عالم الكون المبكر ساخنة الأمر الذي يعني أن الكون كان بمثابة فرن بطاقة عالية إلى أبعد حد، في ذلك الوقت كان هناك تناظر هائل في عالم الكون المبكر، وعندما بردت الأشياء تمدد الكون وتوسع وتحطم هذا التناظر، هذا التصور إذا ما حاولنا أن نعيد تخيله معاً على الصعيد الكوني نجد أن الصورة الفيزيائية التي نحصل عليها بخصوص منشأ الكون صورة رائعة، ففي لحظة ما متناهية في الماضي كان عالم المكان والزمان والمادة محدوداً بمفردة الزمان المكاني، لذلك تمثل نشوء الكون ليس فقط بالظهور المفاجئ للمادة، بل بظهور المكان و الزمان أيضاً، وفي الواقع لا يمكن أن نفرط بالتشديد على أهمية هذه النتيجة، وكثيراً ما يسأل الناس، أين حدث هذا الذي يسمى بالانفجار الكبير؟ في الواقع هو لم يحدث مطلقاً في نقطة معينة في المكان لأن المكان نفسه حدث بعد الانفجار، وهناك صعوبة مماثلة حول السؤال ما الذي حدث قبل الانفجار الكبير، والجواب يأتي أنه لا شيء قبل، فالزمن بالذات بدأ في الانفجار الكبير، ونحن نعرف أن الميكانيكا الكمومية بإضعافها الصلة بين العلة و المعلول توفر لنا طريقة قد تكون بارعة للتغلب على مشكلة نشأة الكون كحدث فجائي صدفوي لا يوجد له سبب فيزيائي، فإذا كان يمكن اكتشاف طريقة تتيح للكون أن ينشأ من العدم نتيجة للتقلب الكمومي، عندئذ لا يمكن أن تكون قوانين الفيزياء قد انتهت، بمعنى آخر إذا نظرنا بمنظار أحد علماء الفيزياء الكمومية، فإن المظهر التلقائي للكون لن يكون مفاجئاً جداً، لأن الأجسام الفيزيائية تظهر تلقائياً طوال الوقت دون أسباب محددة بصورة واضحة في العالم الكمومي المجهري، فالعالم في الفيزياء الكمومية لا يحتاج إلى فعل خارق كان سبباً في نشأة الكون أكثر من حاجته له في تفسير سبب تفكك إشعاعي للذرات عند حدوثه دون وجه سببي معين .
والضرورة في الفيزياء المعتمدة أساساً على نيوتن تقول بأن حالة منظومة في لحظة معينة هي مجموعة المواقع والسرعات للنقاط المادية المكونة للمنظومة، وعندما نعرف حالة منظومة فيزيائية (الموقع والسرعات) في لحظة معينة تدعى اللحظة الابتدائية، فإنه يمكننا استنتاج حالتها في أية لحظة أخرى، فمثلاً تتناسب القوة الجاذبة بين جسمين سماويين بمقلوب مربع البعد بينهما، وبمعرفة أحدهما أعرف الآخر، وهكذا فإن معرفة حالة منظومة في اللحظة الابتدائية تمكننا من حساب تغير حالتها مع مرور الزمن، وفي النتيجة معرفة حالتها في أية لحظة أخرى، هذا الأمر رسخه لابلاس بعد ذلك مؤكداً أنه بفرض وجود ذكاء يعرف في أية لحظة معينة كل القوى الفاعلة في الطبيعة وحالة كل الكائنات التي تشكلها، ويستطيع أن يُخضع كل هذه المعطيات للتحليل فإنه يستطيع في علاقة واحدة أن يعرف كل حركات الأجرام في الكون والذرات في المادة، ولا يبقى شيء غير مؤكد، ونحن نلاحظ في تلك الصيغة ما لهذا القول من صبغة لاهوتية، فالحتمية مطلقة لا تترك مجال للاختيار الحر و لا مكان للمصادفة، فاعتبرت منظومة نيوتن الرياضية منظومة خالدة للطبيعة ومستقلة عن القيم الخاصة للزمان والمكان، وهذه المفاهيم في المنظومة على درجة من الترابط الوثيق بحيث لا يمكن عموماً تغيير أي منها دون تخريب المنظومة كلها، لهذا اعتبرت منظومة نهائية، وبالفعل تطورت الفيزياء وفق هذه المنظومة خلال قرنين من الزمن تقريباً ، و نجاح العلم النيوتوني ومن وراءه مفهوم الضرورة يكمن في اكتشاف أن قوة وحيدة هي الثقالة تعين معاً حركة الكواكب والمذنبات في السماء وحركة سقوط الأجسام نحو الأرض، ومهما كان زوج الأجسام المادية المُعتبر، فإن المنظومة النيوتونية للضرورة تستدعي أنهما متعلقتان بذات قوة الجذب، وهكذا يبدو أن ديناميك الضرورة كلياً من جهتين، فتعريف قانون الثقالة الذي يوصّف كيف تنجذب الكتل إلى بعضها لا يحوي أية إشارة لأي مقياس للظاهرة، وهو يمكن أن يطبق على حركة كل ما في العالم من الذرات إلى المجرات، فكل جسم مهما كان حجمه له كتلة ويتصرف كأنه يتبع قوى تفاعل نيوتونية، فكل شيء معطى في كل لحظة، وهذه الضرورة تتضمن العكوسية بنفس الوقت حيث تم النص بوضوح على عكوسية المسار الديناميكي من قبل كل مؤسس الديناميك، فمثلاً عندما وصف غاليليو أو هايغنز نتائج التقابل بين السبب و النتيجة المفترضة كأساس لتطبيق الرياضيات على الحركة، فإنهم تمثلوا تجارب فكرية كنطوطة كرة مرنة على الأرض، وكنتيجة للانعكاس اللحظي للسرعة فإن جسماً كهذا سيعود إلى حالته الابتدائية ويطلق الديناميك هذه الخاصية في العكوسية على كل التغيرات الديناميكية، وينص هذا التصور على أنه إذا تم عكس سرعات كل النقاط في منظومة، فإن هذه المنظومة سترجع زمنياً إلى الوراء لتمر في كل الحالات التي مرت بها خلال التغير السابق حيث يعود إلى الشروط الابتدائية الأصلية، وبشكل عام يمكن التحدث عن معنى الضرورة في الفيزياء التي عبر عنها بشكل كامل نيوتن ننطلق من القواعد التالية، القاعدة الأولى تقول بأنه يجب ألا يُقبل من الأسباب إلا ما كان ضرورياً لتفسير الظواهر، فالطبيعة لا تفعل شيئاً سدى، والقاعدة الثانية تقول بأن المفعولات التي من صنف واحد يجب أن تُعزى بقدر الإمكان إلى أسباب واحدة، فتنفس الإنسان والحيوان وسقوط الحجر في أوروبا و أميركا، وضوء النار والموقد والشمس، وانعكاس الضوء عن الأرض والكواكب يجب أن يُعزى كل منها إلى الأسباب نفسها، الآن ودائماً، والقاعدة الثالثة تقول بأن خواص الأجسام لا تقبل زيادة ولا نقصانا والتي يشترك فيها كل الأجسام التي يمكن أن تُخضعها للتجربة، يجب أن يُنظر إليها على أنها خواص تنتمي لكل الأجسام عموماً ، و مع قانون الجاذبية المهيمن هناك قانون انحفاظ الطاقة الذي كان له الأهمية الكبرى في الفكر الفيزيائي خلال القرن التاسع عشر ، و هو بالنسبة للكثير من الفيزيائيين كان يعني توحيد الطبيعة كلها ، و قيمة القانون العلمي مستمدة من الإيمان الضمني بحتمية النظام العام للظواهر ، و بهذه الصورة يصبح قانون السببية طريقة البحث العلمي و الشرط الذي يجعل العلم ممكناً ، و من هنا جاء تعريف يربط المفهوم الميكانيكي للضرورة بمبدأ السببية الذي أصبح يمثل الرابطة الضرورية للحوادث في سلسلة زمنية ، يرى فريدمان أن ارتباط الحتمية بالسببية هو ارتباط حديث نسبياً ، و هذا التصور لمفهوم السببية يكمن خلفه افتراض حاسم ، العالم عقلاني و مفهوم ، و كثيراً ما يُعبّر عن هذا الافتراض بمبدأ السبب الكافي الذي يعلن بأن كل شيء في العالم كما هو بسبب ما ، و إذا كان هناك حقائق حول عالم يجب أن نتقبله دون سبب عندئذ تنهار العقلانية و يغدو العالم سخيفاً بلا معنى ، فالمعنى وفق هذا التصور يرتبط بمعرفة السبب الكافي لحدوث كل ظاهرة و في العقل لا يوجد ما هو غير مفهوم إلا الغير واقعي أصلاً ، و لكن هل هناك سبب كاف للإيمان بهذا المبدأ ؟ لا شك أن هذا المبدأ يعمل بنجاح عادة ، فثمار التفاح تسقط بسب الجاذبية و السماء زرقاء بسبب تبعثر موجات الضوء القصيرة و هلمجراً ، و لكن ذلك لا يمكن ضمان نجاحه دائماً بالضرورة رغم أننا نتعامل معه سواءً أكان معصوماً أم لا كفرضية علمية لكي نعرف إلى أين يقودنا ، و الواقع أن هناك مفاهيم خاطئة واسعة الانتشار تنظر إلى المشكلة السببية على نحو يجعل منها بالضرورة ميكانيكية ، و يرجع هذا بالمقام الأول إلى اختزال السبب إلى قوة ، فبالنسبة إلى غاليليو كانت القوى هي السبب الحقيقي للظواهر الطبيعية ، و بالنسبة لديكارت كانت القوة مرتبطة بشكل أساسي بتغير المكان ، أما نيوتن فقد أسهب في فكرة القوة المماثلة ميكانيكياً للسبب ، و يتضمن هذا أن القوى لا تنشأ فقط من تغيرات المكان ، و لكن كل قوة تنتج تغييراً في حالة الحركة في الجسم أيضاً ، فالقوة عند نيوتن وفق هذا التصور مماثلة للسبب ، و هي سبب التغير ، و هذا ما ولد في الأذهان أن الميكانيكا تستلزم السبب بالضرورة رغم أنه في الحقيقة لا تعد الميكانيكا نطاقاً سببياً خالصاً ، فمثلاً إن المبدأ الميكانيكي لحركة المادة بذاتها الذي هو مبدأ القصور الذاتي الذي أعلنه غاليليو و ديكارت و نيوتن هو مبدأ لا سببي بشكل واضح ، لأنه يذكر أن نموذجاً معيناً من التغيير و هو أبسطه على الإطلاق لا يتطلب سبباُ كافياً ، فقوانين الحركة التي كانت عند أرسطو ذات أساس سببي خالص نجدها عند نيوتن لها نطاق سببي فقط ، في حين أصبحت عند أينشتاين ذات نطاق سببي أقل بكثير رغم أنه غير معدوم ، و هذا ما جعل نيوتن و بشكل مغاير لأرسطو و كبلر لا يبحث عن السبب في دفع الكواكب حول الشمس ، لكنه بدلاً من ذلك بحث عن السبب الذي يحني المسارات المنحنية للكواكب ، دون أن يجيب عن سبب الحركة بذاتها ، و مع النسبية لأينشتاين حدث التمزيق الأكبر للسببية المرتبطة بالقوة الميكانيكية ، فما يسبب الانحناء في مسارات الكواكب ليس قوة تقليدية ، و إنما انحناء الزمان المكان بتأثير الجذب الثقالي للشمس ، فليس ثمة قوة مقترحة في النسبية العامة تتم وفقاً لها حركة الكواكب .
و قد أصبحنا نعرف في الفيزياء الذرية أن مفاهيم نيوتن إجمالاً لم تعد تصلح فيها ، فنحن كما نعرف لا يمكننا أن نتنبأ أن اكتشاف الحدث السابق الذي أدى لصدور جسم معين هو أمر مستحيل ، و نحن قد نعرف الحدث السابق و لكن ليس بدقة تامة أي أننا قد نعرف ماهية القوى المسؤولة داخل النواة عن إصدار الجسيم ألفا ، بيد أن هذه المعرفة نفسها يشوبها الشك الناتج عن التفاعل بين النواة و بقية العالم بما فيه الراصد نفسه ، و بالتالي فإن حجج كانط بمفهوم السببية القبلية لم تعد مرضية تماماً . و في هذا الصدد يقول بوانكاريه أنه في الواقع الفيزيائي السبب لا يؤدي إلى نتيجة ، و إنما هناك كثرة من الأسباب المتمايزة تساهم في حدوث النتيجة من غير أن يكون لدينا وسيلة لتمييز دور كل واحد منها ، و الفيزيائيون يسعون إلى القيام بهذا التمييز و لكنهم لا يقومون بذلك إلا بشكل تقريبي ، كما يقول فاينمان بأن صيغة قانون التثاقل هي أولاً صيغة رياضية ، و كذلك صيغة القوانين الأخرى ، و هي ثانياً ليست مضبوطة ، و قد اضطر أينشتاين إلى تعديلها و نحن نعلم أنها ليست صحيحة تماماً ، لأنها تحتاج إلى أن ندخل فيها النظرية الكمومية ، و هذا أيضاً شأن القوانين الأخرى ، فهي أيضاً غير مضبوطة و هنالك دوماً جوانب غامضة ، لا بد أن ندقق فيها أكثر و أكثر ، و سواء كان هذا أم لم يكن صفة من صفات الطبيعة فإنه على كل حال يكتنف جميع القوانين كما نعرفها اليوم ، و ربما كان ذلك مجرد نقص في معرفنا ، و يبدو أن مشكلة الضرورة في الفيزياء التقليدية لم يكن في إصرارها على تفسير كل ما حصل فقط ، بل بإدعائها اللاهوتي أنها تستطيع التنبؤ بكل مسارات المستقبل كما ستحصل ، و لو كان ذلك على السبيل الافتراضي ، فعندما نطبق قوانين الميكانيك الكلاسيكي على دراسة الحركات و التصادمات في نظام من الذرات و الجزيئات نتخيل أن منظومتنا لا تتفاعل مع باقي الكون من حولنا ، لكن هذا الفرض غير واقعي أبداً ، فحتى التأثير التجاذبي لإلكترون موجود على حدود الكون هو تأثير مهم لا يمكن إهماله ، و إذا عكسنا أشعة السرعة للجزيئات بعد ثانية من مراقبة منظومة ، فإننا لن نشاهد الزمن يعود إلى الوراء ، فبعد زمن قصير جداً سيغير الإلكترون الموجود على حدود الكون تسلسل الأحداث و ستزداد الأنتروبية ، و الأنتروبية تقيس كمية المصادفة المتواجدة في منظومة ما ، و بصورة خاصة فإن الأنتروبية للترين من الهليوم تعادل مرتين الأنتروبية للتر واحد في حرارة و ضغط نظاميين ، و إذا وضعت لتراً من الماء البارد قرب لتر من الماء الساخن ، فإن لإنتروبيتهما قيمة محددة ، و لكن إذا خلطت اللترين ، فإن أنتروبية اللترين الدافئين أكبر من تلك السابقة ، فبمزجك الماء الساخن بالبارد تكون قد زدت من أنتروبية الكون اللاعكوسة ، و هذه الفكرة معروفة باسم القانون الثاني للترموديناميك ، في كل سيرورة فيزيائية إما أن تبقى الأنتروبية ثابتة أو تزداد ، و إذا ازدادت تكون تلك السيرورة لاعكوسة ، لذلك يقول لورنتز بأن أية ظاهرة فيزيائية لا دورية هي ظاهرة لا يمكن التنبؤ بها ، و قد وضح ماكسويل بعبقريته أهمية الدراسات الإحصائية في العلوم الطبيعية عندما اقترح سنة 1873 استعمال الطريقة الإحصائية قائلاً بأن أصغر جزء من المادة يمكن أن تخضع للتجربة يتكون من ملايين الجزيئات التي لن يصبح أي منها ملموساً بشكل فردي ، لذلك لا يمكننا تأكيد الحركة الفعلية لأي من هذه الجزيئات ، أي أننا مجبرون على هجر الطريقة التاريخية المتزمتة ، و تبني الطريقة الإحصائية عند التعامل مع مجموعات كبيرة من الجزيئات ، إن هذا التغيير في الفهم هو من العمق بحيث أننا لا بد أن نتكلم عن حوار جديد بين الإنسان و الطبيعة ، فقد كان الكثير من الفيزيائيين حتى سنة 1900 ما زالوا يرفضون فكرة أن المادة مكونة من ذرات و جسيمات ، في حين قبل الكثيرون منذ زمن بعيد حقيقة أنه يوجد في لتر من الهواء عدد لا يمكن تصوره من الجزيئات التي يمكن أن تنطلق في كل اتجاه و بسرعات كبيرة ، و تتصادم في حالة فوضى مخيفة ، هذه المصادفات أصبحت تُقاس بأنتروبية هذا اللتر من الهواء ، و هو ما يسمى بالميكانيك الإحصائي و التي أصبح الآن يوجد منها الوسائل التي تُعينها بدقة ، حيث نجد المصادفة دُجنّت و أصبح لا غنى عنها لفهم المادة ، و من المهم أن ندرك أن القوانين بحد ذاتها لا تصف العالم بصورة كاملة ، و الغرض الصحيح من قيامنا بصياغة القوانين هو في الواقع ربط مختلف الحوادث الفيزيائية ، فالكون يتوسع في الوقت الحاضر على سبيل المثال في كل اتجاه بالسرعة نفسها ، فها معنى ذلك أن الانفجار الكبير كان متجانس الخواص في جميع الجهات ؟ ليس بالضرورة ، فقد تكون الحالة أنه بدأ التوسع بطريقة مشوشة و بسرعات مختلفة في مختلف الاتجاهات ، و أن هذا الاضطراب هدأ عن طريق عمليات فيزيائية ، فقد تكون تأثيرات احتكاكية عملت على كبح الحركة باتجاهات التوسع السريع ، و بدلاً من ذلك ووفقاً للتصور الحديث لتضخم الكون ، خضع الكون المبكر لطور من التوسع المتسارع اُستبعدت فيه الشذوذات الابتدائية خارج الوجود ، فكانت النتيجة النهائية كوناً يتمتع بدرجة عالية من التجانس المكاني و نمطاً هادئاً للتوسع ، و إذا كان العالم عقلانياً على الأقل إلى حد بعيد ، فما أصل تلك العقلانية ؟ فهي لا يمكن أن تنشأ في عقولنا ، لأن عقولنا تعكس فقط ما هو موجود الآن ، فهل يجب أن نبحث عن تفسير عند قوة عليا عاقلة ؟ أم أنه يمكن للعقلانية أن تخلق نفسها بالقوة الصرف لمعقوليتها الخاصة ؟ و بالمقابل هل يمكن للعالم أن يكون لاعقلانياً على نطاق واسع إلى حد ما ، إلا أننا نجد أنفسنا نعيش في واحة من العقلانية الظاهرة لأنها المكان الوحيد الذي يمكن فيه للكائنات الواعية المفكرة أن تجد نفسها فيه ، أليست هذه التساؤلات نفسها تطرح إشكالية التشعب القائم بين الذات و الموضوع ، فليس هناك من حيث المبدأ سبب منطقي لعدم إمكانية أن يكون العالم قد وجد بخلاف ما هو عليه ، و يمكن أنه كان شواشياً إلى حد جعل معه التعميم الاستقرائي مستحيلاً ، و المكان و الزمان اللذين يخيل إلينا وجودهما على شكل كيانين أوليين أساسيين لا نستطيع أن نتصور أي وجود خارجاً عنهما وفق التصور الميكانيكي النيوتوني و القبلي الكانطي ، ليسا سوى نتيجة مزيفة يوحي لنا بها هذا العدد الهائل من الجسيمات الأولية ، فالجسيمات الفردية لا توجد ككيان في زمان و مكان ، بل إن المكان و الزمان هما اللذان بوجدان بوجود هذه الجسيمات ، و السبب الوحيد في أننا نرفض مثل هذا الرأي في حالة الجسيمات الفردية هو أننا لا نستطيع أن نتخلى بسهولة عن التصور المألوف باعتبار المادة موجودة في زمان و مكان ، و ما أن نتخلى عن هذا الاعتبار حتى تزول جميع المفارقات و تتضح فوراً رسالة الكم و هي أن المكان و الزمان كيانين ليسا أوليين ، فالترموديناميك و النسبية و ميكانيك الكم جميعها متجذرة في اكتشاف المستحيلات و التحديدات التي تحد من طموحات الفيزياء الكلاسيكية ، و لهذا فهي تؤشر إلى نهاية بحث وصل إلى نهايته ، إنها نهاية فكرة النهاية في الفيزياء ، و لكن في المقابل فإن تجديداتها العلمية تبدو كبداية جديدة و انفتاح على فرض أخرى أكثر حيوية ، و لكي تحظى الفرضية بلقب “علمية” لا تحتاج للتحقيق الفوري، فما هو مميز للفرضية العلمية ليس الحقيقة ( حيث يطلب أن تشترك بعض الفرضيات مع بعض الافتراضات الشائعة)، ولا العصمة( التي هي علامة على الدوغمائية)، ولكن الاتساق المنطقي وقابلية التحقيق من حيث المبدأ ، تعني إمكانية التحقيق وهذا يتضمن كلاً من قابلية الدحض وقابلية التحسين( تحسين الاتساق والكفاية وبالتالي توسيع مجال التطبيق). فإذا كان وجودنا في الكون صدفة ، فما هو الاحتمال الذي جعل من تلك الصدفة ضرورة ، و بالمقابل إذا كان وجودنا يعبر عن ضرورة لازمة فما الذي جعل تلك الضرورة تنبثق بهذا الشكل و بمفهوم مكاني زماني معين ؟ أليس ذلك يعود إلى احتمال متحقق بلحظة انتهاء المتفردة ؟ و في الفيزياء نجد أن عدم القابلية للتحديد الميكانيكي بالنسبة لموضع الجسيم و سرعته ، و المظهر التكميلي للضوء كجسيم و موجة ، و التحديد الإحصائي للفوتون هي الصفات العامة للمصادفة الموضوعية ، فالمصادفة ليست إلا هذه القابلية المفتوحة للتغير و الإمكان و التعدد و عدم التحديد ، و أساس هذا التصور في الفيزياء الحديثة لا يعود إلى جهلنا أو أدواتنا ، بل إلى طبيعة العالم الذي ندرسه ، فالفيزياء الكمومية كأي جانب آخر من الفيزياء لا تتعلق إلا بالعلاقات بين الموضوعات الفيزيائية ، و كافة قضاياها و تعبيراتها إنما تصاغ بدون أي إشارة إلى مُلاحظ ، و الاضطراب الذي يحدثه الملاحظ مسألة فيزيائية بأكملها لا تتضمن أي إشارة إلى تأثيرات صادرة عن الكائنات الإنسانية من حيث أنهم ملاحظون ، إن أداة القياس تحدث اضطراباً لا لأنها أداة قياس يستعين بها الوعي البشري ، و لكن لأنها شيء فيزيائي ككل الأشياء التي تحدث اضطراب كونها موجودة فقط ، و بالتالي يغدو عدم اليقين ليس إلا نتيجة للتداخل الضروري بين عوامل فيزيائية متعددة و هو ينطبق على الطبيعة سواءً نظرنا إليها أم لم ننظر و هو مظهر يكشف لنا عن وجه المصادفة كموضوع فيزيائي أصيل ، و ما ينبغي التأكيد عليه مرة أخرى هو أن الفيزياء الحديثة لم تتخلى عن البحث عن علل الظواهر ، بل لا يمكن أن تكون علماً إذا ما تخلت عن تلك الغاية ، لذلك فهي لم تستبعد العلية ، و لكن قدمت مفهوم جديد لها يختلف عن الفهم التقليدي الذي كان يوحد بين العلة و الحتمية و بينهما و بين الضرورة ،و من خلال الفهم الفيزيائي الحديث يمكن القول بأن المصادفة لا تعني تخلف العلة كما عبر عن ذلك هيوم ، بل على العكس من ذلك نجد أنه لا سبيل إلى تعريفها و تفهمها دون أن نؤكد ألا شيء يحدث بدون علة سابقة و أن الأحداث التي تكون العالم تترابط في سلاسل متداخلة متشابكة في كل جانب ، إلا أن هذا التداخل و التشابك بين سلاسل الأحداث لا يصل بها إلى الاختلاط و الامتزاج التام الذي يحيل العالم إلى نظام مقفل كهذا النظام الذي يتمثل لنا في الصورة التي صاغها العلماء الميكانيكيون عن العالم الخارجي ، و إنما هو تداخل و تشابك مفتوح بين سلاسل العلل و الأحداث ، لذلك يمكننا القول بأن الكون يتميز بتعقيد منتظم ، و إمكانيات متعددة ، و على الرغم من التداخل المترابط لظواهر الطبيعة فإن هناك تناسق غريب فيها ، فقوانين الفيزياء التي اكتشفت في المختبر تنطبق تماماً على الذرات في المجرات البعيدة ، و الالكترونات التي تشكل صورة التلفاز و تحمل الكتلة و الشحنة و العزم هي نفسها التي على القمر أو على طرف الكون المعروف لدينا على الأقل و الذي يمكن رصده ، و إضافة إلى تناسق قوانين الفيزياء هناك أيضاً تناسق على ما يبدو في التنظيم المكاني للكون ، فعلى نطاق واسع تتوزع المادة و الطاقة بانتظام ، و يبدو كأن الكون يتوسع بالمعدل نفسه في كل مكان و كافة الاتجاهات ، و قد حاول أصحاب نظرية الكون التضخمي القول بأن طفرة مفاجئة في حجم الكون بعد ولادته بقليل كان لها التأثير الملطف على الشذوذات الأولية ، لكن المهم أن نعرف أن تفسير التناسق بمعنى آلية طبيعية لا يفيد بشيء لإضعاف الخصوصية ، لأننا نستمر نسأل لماذا تسمح قوانين الطبيعة لتلك الآلية بالعمل ، إن حتمية الاحتمالات وفق تمازج جدلي رائع هو ما تقوله لنا الفيزياء و تعلمنا أن سعة الأفق الفكري و الفلسفي لا حدود له أمام الواقع المتنوع لدرجة مذهلة ، فمجموعة الإمكانات التي يمكن أن تأخذها ظاهرة ناتجة عن سبب معين لا تسلك في ظهورها في الحقيقة سلوكاً كله فوضى ، بل سلوكاً يسير على نهج محكوم بقوانين صارمة ، لأن المصادفة هي أيضاً لها قوانين صلبة ، هي قوانين المصادفة ، فلا تتوزع تكرارات الإمكانات كيفما تفق الأمر ، بل تتوزع توزعاً منتظماً لا يدع مجالاً للشذوذ أبداً ، و عندما نقول أن لجسيم كمومي احتمالاً مقداره كذا لأن يكون في حالة معينة ، فإن هذا القول يجب ألا يعد تعبيراً عن جهلنا ، بل تعبيراً عن خاصة في الجسيم ، و هذا التأويل الموضوعي للاحتمالات يرافقه غالباً تمييز بين الاحتمال و الإحصاء ، فبينما يمكن للأول أن يكون صفة واقعية لجسيم بمفرده ، فإن الثاني لا يمكن أن ينسب إلا إلى مجموعات من الجسيمات ، فالإلكترون صغير لدرجة يجب أن يبلغ عدده حوالي مليار مليار مليار لكي يصبح أهلاً لأن نتحدث عنه بلغة الأوزان اليومية ، لذلك إذا رأينا العلم قد تجاوز اليوم التخلف الناشئ عن عدم الدقة المتأصلة ، فما ذلك إلا بفضل أعداد على مثل هذا القدر من الضخامة من جهة ، و لأن ميكانيك الكم قد اكتشف قوانين تحدد قيم الاحتمالات بدقة مذهلة ، فهو بفضل هذه الأعداد الضخمة يستطيع التنبؤ بجرأة ، وإذا اعترف اليوم العلم بكل تواضع بعجزه عن التنبؤ الصحيح بسلوك الإلكترون أو الفوتون أو أي جسيم آخر مأخوذ فرادى ، إلا أنه يستطيع التنبؤ برغم كل شيء و بكثير من اليقين كيف ستتصرف هذه الكثرة من الجسيمات بكل دقة ، و نحن نعرف أنه الفيزياء بعد الكمومية لم تعد الصيغ الرياضية تمثل الطبيعة ، بل تمثل ما نملكه من المعرفة بها ، و هذا يعني كما يقول هايزنبرغ أننا عدّلنا من توصيفنا للطبيعة الذي كان يمارس خلال مئات السنين و الذي كان يُعتبر لبضعة عقود خلت أنه الهدف الطبيعي لكل علم دقيق ، و فيما يخص النتائج النهائية يجب أن نذّكر أنه لم يوجد قط في دائرة علم الطبيعة الدقيق حلول نهائية إلا في عدد محدود جداًَ من مجالات التجربة ، و كلمة نهائي كما نطبقها على علوم الطبيعة تعني وضوحاً أنه يوجد دوماً منظومات مفاهيم و قوانين تشكل كلاً مغلقاً و تكون قابلة لأن تُصاغ رياضياً و هي تصح في مجالات معينة من التجربة ، فهي في هذه المجالات ذات صحة شاملة و لا تخضع للتحويل أو التحسين ، و لا يحق لنا بالطبع أن نأمل من هذه المفاهيم و القوانين أن تكون فيما بعد قادرة على تمثيل مجالات أخرى من التجربة ، و المفاهيم و القوانين الواردة في نظرية الكم لا يمكن أن نسميها هي الأخرى نهائية إلا بهذا المعنى المحدد ، و بهذا المعنى المحدد و به فقط يمكن للمعرفة العلمية أن تتحدد نهائياً في لغة رياضية أو في شيء آخر .
إن منطق العالم الذي نعيش فيه إذاً هو مدهش و لكننا نعتاد عليه ، و نحن يجب أن نفسر العالم بلغة شيء ما أساسي أكثر ، ربما مجموعة من الأسباب ترتكز بدورها على بعض القوانين أو المبادئ الفيزيائية ، و لكن حتى آنئذ فإننا نبحث عن تفسير ما لهذا المستوى الأساسي أكثر أيضاً و هكذا ، فأين يمكن أن تنتهي سلسلة التفكير هذه ؟ هل تستمر بنكوص لانهائي ؟ أليس هناك برج من السلاحف التي يقف عليها الكون ، يعلن جون ويلر بأنه لا بنيان و لا خطة و لا تنظيم ، لا إطار أفكار يستبطنه بنيان أو مستوى آخر للأفكار ، و هذا بدوره يستبطنه أيضاً مستوى آخر ، و آخر أيضاً إلى ما لا نهاية نزولاً إلى ظلمة لا قرار لها ، و يبدو أن العملية تبادلية و دائرية ، فالفيزياء تنتج مشاركة الملاحظين ، و مشاركة الملاحظين تنتج المعلومات ، و المعلومات بدورها تنتج الفيزياء . يقول روجر شانك بأن المعلومات هي مفاجآت ، نتوقع جميعاً أن العالم سيعمل حسب طرق معينة و عندما يفعل ذلك فإننا نضجر ، فشل التوقع هو الذي يجعل من شيء ما موضوعاً مهماً للمعرفة ، ليست المستندات مهمة إلا عندما تفشل




