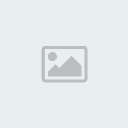
يبدو أنّ بعضَ المفاهيمِ والقضايا الفكريّة تُسيطر-دونَ غيرها- على الساحة الثقافيّة والإعلاميّة لأسباب سياسيّة ظرفيّة أو غير ذلك، فيتخذ السجالُ حولها طابعاً إعلاميّاً ودعائيّاً: مع أو ضد. ولا يعني ذلك أن لكلّ النتاج الثقافيّ المرحليّ السويّة والأهميّة المعرفيّة والتأريخيّة نفسها، بلا شك.
هكذا كانت الحالُ مع موجةِ الحديث والكتابة عن “العولمة” قبل بضع سنوات التي تصدّرت صفحات المجلات والجرائد والكتب المتخصّصة والمؤتمراتِ و السّجالات الفكريّة والاقتصاديّة والسياسيّة، ويبدو الآن أن إشكاليّات العولمة في طيّ النسيان على ما قد يستنتج المرء نظراً للغيابِ اللافتِ بعدَ طول حديثٍ وانشغال! والكتابةُ الرائجةُ على “المجتمع المدنيّ” قبل سنوات قليلة وندرتها فيما بعد توحي لنا وكأنّ المجتمع المدنيّ بات واقعاً محققاً في البلدان العربيّة!
وهذا بحدّ ذاته ظاهرة عالميّة، لها أسباب مختلفة، أقصدُ التّركيز الإعلاميّ على قضايا دون سواها. لكنها عندنا في البلدان العربيّة تتخذّ طابعاً أشدّ وطأة: لأن التناول الفكريّ والأكاديميّ العربيّ ليس له دور علميّ فاعل في تبيئة المفاهيم الفكريّة والفلسفيّة ودراستها بعمقٍ ورويّة بمعزلٍ عن ضجيج الصحافة والتناول السريع والمبتسر.....وأشياءٍ أخرى.
العلمانيّة..مالئةُ الكتب وشاغل المثقفين:
على ذلك، كان بودّنا أن يقدّم الدكتور أحمد برقاوي (وهو أستاذ فلسفة في كلية الآداب بجامعة دمشق،ورئيس قسم الدراسات الفلسفية) في كتابه الصادر مؤخراً “العرب والعلمانية” لنا سبراً علميّاً منهجيّاً للعلمانيّة مفهوماً وتاريخاً وواقعاً وكذلك الإشكاليات التي رافقتها محليّاً وعالميّاً، وتخليص السجال العربيّ والإسلاميّ الراهن من ثنائية: مع أو ضد العلمانيّة...وأن نقرأ كلاماً متناسقاً والمهمة التي أوكلها البرقاوي لكتيبه.
يدّعي مؤلفُ كتاب (العرب والعلمانية) في مقدمته: أنه يحاول أن يحدد العلمانيّة كمفهوم ويرصد تطور علاقة العرب به مثقفين وسياسيين وتقديم تصورات احتماليّة حول مستقبل العلمانيّة في الوطن العربيّ. لكنّه لم يوفّق، البتّة، في محاولته هذه. وليست المشكلة في عدد صفحات الكتيب القليلة، إنما في تلك الخفّة والتّسطيح التي تناول بها المؤلف موضوعاً شائكاً وإشكاليّاً وبصورة وَعظيّة وتبشيريّة لا ترتقي لمقاربةٍ ما، وعلى أية أرضيّة تحليليّة ومنهجٍ علميّ واحدٍ أو مركّب،لموضوعة العلمانيّة.
وعلى سبيل المثال، نسوق ،هنا، تعريفه لـ“الهُوية”، ربّما يترفّع عن تقديمه بعضٌ من طلبة الأستاذ برقاوي:<< ما العلاقة بين العلمانية والهوية؟ربما يكون السؤال بهذه الصيغة غير مألوف ومستغرباً.لكن السؤال هو في صميم المسألة التي نحن بصددها.
الهوية:
شعور بالانتماء الذي ينجب التمايز بين البشر من حيث شعورهم الذاتي.ولا شك أن الإنسان ليس حراً في اختيار وعيه بالهوية أو يجد صعوبة حتى لو شاء بشكل عام.إذ يمكن للبشر في مجتمع واحد أن يعبروا عن انتماءاتهم أو وعيهم الذاتي أو هوياتهم بأشكال مختلفة.كأن يعبر إنسان ما عن هويته بأنه مسيحي وآخر بأنه مسلم وثالث بأنه يهودي.....
فالمؤلّف يتحدث عن مفاهيم متباينة ومتقاطعة، ودون درايةٍ كافيةٍ منه يخلط بينها خلطاً واضحاً: الهويّة،الانتماء، الأصل، الذاتيّة، الأنا، الجنسية.....ولا يتوصل إلى تعريفٍ، وقبل ذلك إلى تصور ذهنيّ، للهويّة كمفهوم كُتِب عنه فلسفيّاً بالمقام الأول، كي يتمكّن من شرح “العلاقة بين العلمانية والهوية”، ويتوصل إلى ما يسميه “الهوية العلمانية” (ص19) حين لا تسعفه اللغة بمصطلح المواطنة.
والحقيقةُ أن رفع العلمانيّة إلى مستوى “هوية” فيه أكثر من مبالغة. أنها ستعني،تالياً، ومهما قيل،إلى دينٍ وضعيّ وجامد عكس ما يرومه المرء: تعزيز قيم المواطنة والليبراليّة السياسيّة والثقافيّة. كما أن المنافسة مع الإسلاميين من منطلق خطاب “الهوية”، لا المواطنة وحقوق الإنسان والحرية الدينية والفكرية والقوانين الحديثة، يدخلنا في شرك اللاعقلانية وسباقٍ لا طائل منه. هذا لا يعني “مسايرة” الإسلاميين، على العكس. بل لأن سجال الهوية هذا ،تحديداً، يطيبُ للإسلاميين كثيراً فرؤيتهم للمجتمعات على أنها كتلة ثابتة متوارثة و مفطورة على ما يسمّى بالشريعة الإسلامية والطبيعة الإسلامية منذ الأزل إلى الأبد أقرب لقلب و“عقل” العامّة من الناس. أي “الهوية الإسلامية” المزعومة لمجتمعاتنا وتواريخنا.وليس بالأمر الحسن أن ننطلق من الأرضية ذاتها،أعني خطاب الهوية. ولا هو بالأمر المفيد كثيراً على درب العلمنة المأمولة وكما يقول واقعها المتحقق في بقاع عدة و بتنويعات متباينة في أرجاء المعمورة والتي جاءت العلمانيّة فيها،متأخرة عن دعوات الإصلاح الديني بكثير،كحصيلة لإزاحة السلطات الدينيّة بعيداً عن مجال الدولة العموميّ والمشترك الوطني، لكن في سياق ثورة الحداثة الشاملة والعميقة التي طالت البناء السياسيّ والاقتصاديّ-الاجتماعيّ والثقافيّ للدولة والمجتمع على حد سواء .
ويجدر بالتنويه هنا على أن الباحث والمفكر السوري د.برهان غليون (المجدّد في هذا المجال،ولو تحفّظ المرء على بعض التفاصيل هنا وهناك)، في حدود متابعتنا،كان من السبّاقين لنقد الخطابات العلمانويّة الرائجة بدون تأملٍ كبير في مساراتها وبيئاتها المختلفة و توظيفاتها السياسيّة والاجتماعيّة.و توقف في غير مكان عند نقد “الطابع التبشيري الممل للخطاب العلموي، وما يتميز به من الجمود والثبات وتكرار الصيغ والعبارات والشعارات نفسها، دون أدنى مراجعة أو محاولة لتجديد الفكرة أو تعميقها، منذ نصف قرن” و بحسب غليون نفسه،“من كانت هويته العلمانية فلا هوية له. إنها موقف من العقيدة والهوية. والذين يحولونها إلى عقيدة يخلطون بينها والفلسفة اللادينية. فمن المفروض أن يستطيع المتدين أن يقول عن نفسه ويكون بالفعل علمانياً، وإلا فليس للعلمانية قيمة ولا مبرر على الإطلاق. فهي ممكنة فقط بانضمام المؤمنين لمبدئها، وليست ممكنة إطلاقا بعزلهم أو استبعادهم”.
مدخلٌ خاطئ!
أصبحت حركات الإسلام السيّاسي، محور اهتمام الباحثين والإعلاميين في الغرب والمنطقة،نظراً للدور الذي تضطلع به هذه الحركات في المجتمعات العربيّة والإسلاميّة ومقدرتها على التعبئة الجماهيريّة والشعبيّة، وامتداد تأثيرها السياسيّ والحركيّ للدول الأوربية والأمريكية ممثلة اليوم بتنظيماتٍ إرهابية،ينضوي تحت إطارها أفراد من بلدان عربية وإسلامية مختلفة،وهي في حقيقة الأمر شكل مستجدٌّ من الحركات الإسلامية ..
لكن المعرفة بشؤون تلك التنظيمات الإرهابية وسُبل انتشارها وجذبها للشباب و تكتيتكاتها اللوجستية والمالية لن يغطي جزءاً هاماً من الواقع الأكثر تعقيداً الذي يبدو في وجهته العامة سائراً على درب “أسلمة المجتمع على مستوى العمق بعد أن كان إسلامياً ،أو مسلماً،على مستوى على السطح”؟. (أستعير هذا التعبير –بتصرفٍ شديد- من الدكتور صادق جلال العظم في معرض تعريفه للعولمة بأنها رسملة العالم على العمق بعد أن كان رأسمالياً على السطح).
والواقع أن المجتمعات العربية والإسلامية تعيش في هذه البرهة التاريخية حالاً من انفصامٍ كبير بين روح العصر وبين أوهامها المغرقة في ذاتويتها.لأول مرة يتم التعبير -إسلامياً وعربياًَ-عن الانفصال عن العالم والضجر منه على هذا النحو الفصيح والبليغ والسعي لبناء عالم مختلف كلياً غير موجود إلا في مخيلة هؤلاء ،وغير ممكن التحقق قديماً وحاضراً ومستقبلاً،يسمّى دولة الإسلام،دار النقاء والبراءة والسعادة.وبرأيي إن أية قراءة تستغني عن معاينة الوقائع المركبة والمتداخلة التي تدفع قطاعات كبيرة من مجتمعاتنا للانتحار الجماعي والارتياب من العالم كله،يصعب أن تفي الموضوع حقه.يمكن أن نضع جانباً – و لو لبعضٍ من الوقت- النظرية القائلة بأن انتعاش حركات الإسلام السياسي ما هي إلا مؤامرة على الحركات القومية والشيوعية والعلمانية العربية أو أنظمتها “التقدمية” أو تلك غير التقدمية،وأن ندفن رأسنا قليلاً في الواقع-بحثاً فيه،لا غروراً- ونتأمل في أحوالنا من جهاته كافة للخروج بتصورات أكثر واقعية وعقلانية لها،ومن ثم اجتراح حلولاً إبداعية لها ومخارج واقعية.كما أن هناك تجليات مختلفة للوعي الإسلامي اليوم والبارحة لا تختصر في كبسولة واحدة.
من هنا نقول أنه خلال مناقشتنا لمفهوم العلمانيّة عربيّاً ،من الضروري إجراء مراجعة شاملة ومفصّلة لمُجمَل ما كتب حول العلمانيّة من مواقع مختلفة خلال العقود الأربعة المنصرمة: مفكرون وباحثون علمانيون وغير إسلاميين وكذلك إسلاميين ،كخطوة أولية على طريق البحث. وبإمكان المتابع أن يقع على مساهمات و مقاربات كبيرة وأساسية عن العلمانيّة ومن وجهات مختلفة ومتعاكسة (برهان غليون-عزيز العظمة،صادق جلال العظم ومحمد عابد الجابري و محمد أركون وجورج طرابيشي و سيّد القمني والمستشار محمّد سعيد العشماوي و سمير أمين وحسن حنفي وعبد الوهاب المسيري....) وهذا غائب تماماً عن كتاب محوره العرب والعلمانية؟
باستثناء وقفة قصيرة عند قلّة من المصلحين في بدايات القرن الفائت والوقوف عند أصل الكلمة “العلمانية” عربياً ،هل هي من العِلم أم من العَالم، ودون الإتيان بجديد على هذا الصعيد ،أيضاً،لا نعثر على ما يفيد اتجاه البحث “العرب والعلمانية”.هذا ما يفوّت على المؤلف ملاحظة الخيط الفكريّ الرابط بين الموقف من العلمانيّة والنظرة الأوسع لقضايا الدولة والمجتمع والتراث والدّين والحَدَاَثة. وإذا كان من المفيد تلخيص كتاب “العرب والعلمانية” للقارئ نستطيع القول-دون كبير إجحاف- أنه لا فكرة أصيلة في الكتاب، ولا مناقشة لأفكار أخرى ولا حوار أو سجال مع وجهات النظر الأخرى، المتفقة أو المختلفة ولا طرح لما قد يحفزّ القارئ،المتخصص أو غير المتخصص،لإعمال الذهن والعقل. كما عدم التركيز الواضح في مجمل الكتاب، وهذا ينمّ عن عدم مرور تلك المقولات العمومية المشكلة لمتن الكتاب،في مختبرٍ عقليّ وفلسفيّ،قبل ترجمتها كتابة وكلمات وأسلوباً..فجاءت أفكار مبتسرة،لا طائل منها،سوى التهويل من خطر إسلامي قادم،لم يتفضل الأستاذ برقاوي،باقتراح حلول مشرّفة لنا لإنقاذنا من واقعنا الراهن، وما قد يقينا من كوارث قادمة،سوى مقولات بلا تأصيل ولا تعيين واقعيّ“العلمانية والديمقراطية”.غير أن الديمقراطيّة المُقترَحَة من قبل المؤلف، وكثيرين أمثاله ،ديمقراطيّة بلا ملامح وأسس،لا تناهض الاستبداد من حيث تفكيك نقطة(أو نقاط) ارتكاز الأنظمة الاستبدادية الرئيسة،باستثناء نظامٍ عربيّ بعينه (مسموحٌ بشتمه في سوريا!) وكأن النظام ذاك ينفرد بالديكتاتوريّة،لأنه “غير علماني”؟ أما “العلمانيون” الذين رفعوا شخوصهم وخطاباتهم وصورهم وأصنامهم لمرتبة المقدّس، ومارسوا استبداداً صريحاً “علمانياً”،فبم نفسر استبدادهم؟ وإلى أين نذهب بالصراع حول السلطة والثروة والقوة، “أسرار” الدولة التسلطيّة...




