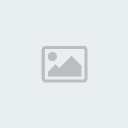
يمكن اختصار تاريخ الأدب، والنقد إثره أو يوازيه في سؤاله، وسؤال الأدب ـ أسئلته هي تعريفه، ما يمكن أن يملأ محتواه بعد أن تنهض صروحه الأجناسية، وتتعين خصائصه وقوامه اللغوي الفني. والسؤال الأدبي، الرهين بتكوين تعابير وتمثيلات بلاغية وجماليات معينة، من جهة،وبقول خطاب الإنسان بذاته/وبوجوده في الحياة من جهة أخرى،يتحول مع النقد إلى سؤال مزدوج، نظرا لانكبابه على فهم وتأويل هذا الخطاب وإواليات اشتغاله، ولانتقاله منه إلى ماهو أبعد وأعلى، نحوالتجريد والمفهمة، أي النظرية والرؤية والمنهج، وما يتفرع عن هذه المكونات جميعها من مساطر وإجراءات.
يعنينا السؤال لأنه صنو المعرفة بل مؤسسها، بعد أن تكون قد عبرت مراحل التشكيل الأولى، وتحددت الملامح البارزة لموادها وأصنافها حد الاستتباب والرسوخ في البيئة والأذهان كأنها عقيدة لا تقبل التجديف، فينبثق هو ليزلزل الأرض تحت أقدام المؤمنين الواثقين، ويزرع بذرة الشك في اليقين، يقين معرفة سابقة، طارحا أفكارا ومجترحا استفهامات. سيبلبل الخواطر بوساوس من شأنها دائما أن تظهر، وخاصة لدى المطمئنين إلى المعتقدات المطلقة، وكأنها تشكك في العقيدة نفسها. وإنها لتفعل حقا عندما تجدد مساءلة المعرفة، من أي نوع كانت، في محتواها، وأكثر من ذلك في المحورالأساس الذي عليه تنهض وبه تستقر.
هذا ما انتهجه بالضبط تزفتان تودروف) Tzvetan Todorov ( ) 9391ـ ) الباحث الجامعي،والناقد والكاتب الإنساني اليوم، البلغاري الأصل، المتجنس فرنسيا، الذي يعود إليه الفضل مع صفوة من الدارسين النادرين في إحداث ثورة حقيقية في مفهوم الأدب وابتداع نظريات ومفاهيم التحليل السردي وعلوم اللغة، أُدخلت كلها إلى الجامعة الفرنسية، في حقبة التحول الحاسمة نهايات الستينات ومطالع ما تلاها وانعكست سريعا على المحافل الأكاديمية العربية، بلدان المغرب العربي بالدرجة الأولى والقصوى.
إننا نعود إلى تودوروف لا لنزيح الغبارعن ما بات تراثا نقديا، مكرسا في الجامعات وحوليات العلوم الإنسانية،الأدبي منها خاصة،وليس بالضرورة لفحص تراكيبه وأنساقه وسنن نظامه، فإن ذلك، على ما فيه من فائذة، مبذول للدارسين والطلاب على السواء، به يختبرون النصوص وبأدواته المنهجية يحللون ويفككون. نعود، لشأن آخر تماما،استدعته المفارقة،وما يقول به المثل من أنه بضدها تتميز الأشياء، ما يتطلب لا محالة استدعاء الغائب، وحتمية“قياس الشاهد على غائب” أمس.
فتودروف الراهن يقول أو يدعو إلى عكس ما قننه وأفتى به كشرعة للدرس الأدبي لا تبغي بغير لبّ الأدب وأدبيته الجوهرية،الوحيدة، بديلا؛ إنه ببساطة يصدرالنص الدستوري لإعطاء الشرعية للانقلاب الذي شرع “يتآمر” فيه على حقله المفاهيمي المركب، ذاك البنيوي، اللساني والبويطيقي، منذ بداية الثمانينات وتواصل منذئذ ليتنزل على مدى عقدين إنتاجا يعانق الإنساني والمصيرالجمعي والحوارالمشترك، يقوم على مرتكزالدلالة، نضت عنها اللبوس السميوطيقي لعِلمها، متخذةً ما اعتبرته، تعتبره بحق، همّا جديرا بأي باحث، بأي أديب، بالأدب أن يتخذه خطابا، وعلى الكتابة أن تعيد إليه الإعتبارمادة، نهجا وأفقا.
حين ُيصدِر مريد التشكيليين الروس اليوم كتابه الجديد“La littérature en péril” أو “الأدب في خطر”(دار فلاماريون للنشر،2007) فربما ليقطع بصفة نهائية حبل السرة مع تاريخهم، وبالتالي السلالة الثقافية الأولى التي إليها انتسب، وبها عُرف وتَصَدّرالمجالس في فرنسا، هو المهاجر البلغاري، وكسب ولعله، من نحوآخر، حنّ إلى الأصل الإيديولوجي لبيئته، في نبعه الثوري والإنساني الأصيل، قبل أن تكسر عنقه يد البطش الدكتاتوري باسم الماركسية اللينينية وهيمنتها “التوتاليتارية”. وماذا لوقلنا إنها محطة أخرى في مسارهذا المثقف الجوّال، ماذا؟!
على كل، فالرجل وصل إلى فرنسا سنة 1963، ممنوحا من بلده بلغاريا، من جامعة صوفيا، بذريعة التخصص في موضوع لغوي، بينما في رأسه مخطط للإفلات من قبضة المعسكر الشيوعي والنظام التعليمي السائد في جامعة واقعة في قبضة التوجيه الإيديولوجي. هناك تحايل مؤقتا على الوقوع في هذا الفخ باختياره لشهادة التخرج موضوعا اقتضى مقارنة صيغتين لقصة كاتب واحد درسهما لغويا ونحويا. بمجرد الانتقال إلى باريس رأى الأفق المفتوح، وطرق الباب المناسب، وسلم على اليد الحَفِيّة، ممثلة في َعلَمين هما بين من سينقلون الدرس الأدبي النقدي في السوربون تلك النقلة النوعية التي لا يقيس مسافتها ونوعها إلا سدنة مدرسة التاريخ الأدبي التقليدي والفيلولولوجي، الذي أصيب اختصاصهم في مقتل على يد رولان بارت، وجيرار جنيت وأنداد لهما وتلاميذ، بين غرب ومغارب.
على يد هذين الشيخين، سيقطع تودوروف الخطوة الأولى في المسار الجامعي الجديد، أو بالأحرى المجدد، الموافق لهواه. فهو لم يصل إلى القلعة الباريسة صفراليدين ولكن مالكا إرثا أدبيا فريدا هوالذخيرة التي دُعي إلى نقلها إلى الخزانة الفرنسية لتعزز نهجا وترسخ دعائم، نعني تلك النصوص النظرية الباذخة للشكلانيين الروس،المتفوقة في عشرينات القرن الماضي، من كبارآبائها فيكتوركلوفسكي، إيخنباوم، أسسا درس الأدب، النثرأولا، والشعرجزئيا، ومفهوم أدبية الأدب المشتغل بأدواته وإجراءاته المخصوصة به، من هنا أصل التسمية، وهم يتصدون للتسطيح الذي راحت الثقافة الرسمية، بنت الثورة البولشيفية، تحاول تعميمه فارضة أكثرمن هذا النموذج الواحد صانع نص السخرة، و“البروبغاندا” الشوهاء. نعلم أن كليبنيكوف ومايكوفسكي تصديا له في صناعة القصيدة بالفصاحة الصافية والإستعارة العالية والإيقاع السديد.
هكذا، وبتحريض من جنيت، ينقل تودوروف هذه النصوص إلى الفرنسية لتصدر سنة 1965 بعنوان “نظرية الأدب نصوص الشكلانيين الروس” لتنطلق القاطرة على سكة تجديد مفهوم الأدب، مع جنيت دائما، خلال عشر سنوات عبر مجلة “Poétique”، مسنودة بسلسلة دراسات. هي وغيرها منالأعمال النظرية والتحليلية اتجهت نحو تغيير خط تدريس الأدب في الجامعة الفرنسية، وتحريرها من السياج المحدود للتحقيب والآداب الوطنية المغلقة، وأسيرة المعايير الخارجية، المعزولة عن النص، بالتوجه أساسا إلى دراسة الأعمال في ذاتها، وبانفتاحها على بعضها، يستخدم المشتغلون في هذا الحقل أدوات التحليل البنيوي والعلوم اللسانية أساسا، أولا، والدلالية، ثانيا، والسيميائية أخيرا، على مراحل هي مجمل التطور الذي عرفته المناهج الأدبية الحديثة من تطور، بدءا من نهاية الستينات، وصعدا، نلمع إليها ونشير إليها اختزالا فقط، وإن جزءا من هذه المناهج والجهود الكبرى المؤسسة والمطورة هي ما ضمه العمل الضخم لتودوروف المعنون:“القاموس الموسوعي لعلوم اللسان” شكّل منذ صدوره، وما يزال، مرجعا لا غنى عنه في بابه لكل من يسيرعلى درب الدرس الأدبي الجديد أمس، ما انفك يتخذ أكثر من سربال، ويثيرغيرموقف ومراجعة، ما نحن بصدده إحداها الأشد مفارقة، والأقوى إثارة وجذرية، وهو ما سنعرض له في الفقرة الموالية من هذا المقال.
من محارة القول إلى أقيانوس المعنى
توالت أعمال البويطيقي البلغاري، الذي اكتسب الجنسية الفرنسية آنئذ، بانتظام وفي الخط القويم لضبط وتقنين شروط ومفاهيم ومعيارية العمل الأدبي داخل الدائرة الأدبية الصرف، أي العناصر والمكونات والإواليات المرتبطة بصناعة القول والأداء الفني وتكوّن الدلالة فنيا في ارتباط مع رسم التنوع الأجناسي للخطاب، وبالتركيز على البنيات السردية أو ما سيتحدد أكثر عند جينيت خاصة بـ“علم السرديات”.الحاصل أن الفارّ بعقله مما كان يسمى بـ“الستار الحديدي” وجد ضالته في العكوف على القول وفنيته في ذاتهما، بمعزل عن المعنى، أو المضمون، أوالصلات التي يقيمها الإبداع مع العالم، وهذا في مناخ الإنفجارالثقافي الذي عصف بفرنسا بعد حركة 68 الطلابية والعمالية، والفكرية خاصة ما عرفت إلا نضوجا ومزيد تفتح وتنوع، وتجدد. ولعله إلى هذا المنزع الأخير قد يُعزى التغيير الذي سيطرأ على المسارالفكري لتودوروف، حين سيشرع منذ نهاية السبعينات الخالية في كسرالقوقعة السيمانطيقية المغلقة والانفتاح التدريجي على العالم الخارجي، جغرافيا وثقافيا، ينشد مساءلة التعدد الثقافي وفهم الآخر. مما قاده إلى رحلات بلدان أميركا اللاتينية، المكسيك أولا، أثمر كتابا عنه(1978)، ثم إلى قراءات لأعمال كبارالتنوير، مونتسكيو، مونتاني، توكفيل، وأضرابهم، والإنفتاح، بالتالي، على اختصاصات أوسع:علم النفس، التاريخ،الأنثروبولوجيا والفلسفة والأخلاق. بموازاة هذا كان ينتقل إلى الإندماج في المجتمع الفرنسي بكيفية هيكلية وملتزمة، بالإشتراك في لجان بحث واستشارات، في ميدان التعليم وبرامجه على الخصوص، ما قربه إلى مفهوم الأدب على صعيد التدريس لا نظريا حسب.
هوذا يقول :“حين بدأت اندماجي التدريجي في المجتمع الفرنسي في فرنسا ذات الديموقراطية التعددية، بدأت ألاحظ أن الأفكار والقيم المجموعة في كل عمل أدبي لم تكن مسجونة في قالب إيديولوجي مسبق الإعداد، بالتالي لم يعد هناك من داع لتجاهلها، وهكذا زالت أسباب اهتمامي الخصوصي بالمادة الأدبية اللغوية للنصوص”(الأدب في خطر،13 ص)؛وفي مكان آخر:“منذ منتصف السبعينات فقدت طعم مناهج التحليل الأدبي، وبدأت أتعلق بالتحليل نفسه، أي باللقاء مع الكتّاب”(نفس المصدر).لينتقل إلى طرح السؤال المعرفي الذي لا يبلى حول ماهية الأدب، ويوجِدَ له تعريفا مناسبا لوعيه في المرحلة: “لا يولد الأدب في الفراغ، ولكن داخل مجموعة من الخطابات الحية يقتسم معها عديد خصائص، ولذلك لاعجب أن حدوده، عبرالتاريخ، ما انفكت تتغير؛ أقول أحسست بانجذابي إلى أشكال التعبير الأخرى، دون أن يتم ذلك على حساب الأدب.”(نفس المصدر ص 14).
لنفهم، إذن، كما سيتكفل الكتاب المرصود بالعرض التفصيلي،أن الدارس الشكلاني ينتقل فعلا إلى مجرة أخرى اسمها جوهرالمعنى، ومضمون العالم، ومصائرالتعدد الثقافي والإنساني فيه، إن شئنا من الفرديات اللصيقة بالثقافة الليبرالية والهموم الوجودية والأنطولوجية، من الهويات المغلقة، المحكومة بالشكل، والعدمية، وأنويةالفرد المركزية، إلى الأفق الإنساني الأرحب الذي يبقى فيه للوجود، وللعمل الأدبي معه، المعنى، ذلك الذي يبحث عنه القارئ، يسند به وجوده هو الآخر. لقد أثمرهذا التحول أعمالا ملحوظة أضحت علامة مميزة له، أهمها كتاباه: face l’extreme à “(1999)؛”Mémoire du mal,tentation du bien"(2000). مع التنبيه إلى أن مهاجرين سابقين من ضربه قلبوا هم بدورهم ظهر المجن لتكوينهم الأصلي الذي اخترقوا بهالجامعة الفرنسية،قالببين عاليها سافلها، ذاهبين في خط التفتح واستنكار الإنغلاق على الأبحاث السيميولوجية وما في منحاها، أبرزهم، طبعا، جوليا كريستيفا التي مثلت، هي وغريماس، المهاجر بدوره، في الثمانينات، طوطم وقبلة كل من يسير في درب العلامة. هذا، وبما أن تودوروف ليس رجل فتاوى ولا دعاوى خطابية، بل باحثا متمكنا، حريصا على الحجاج في كل موضوع يطرق، نجده في الكتاب المرصود يعمد إلى عرض أسباب التحول وتركيبها على نحو تاريخي وأركيولوجي وجدلي، ليخلص إلى ما يمثل لب أطروحته، أو موقفه البديل، ننعته بجدارة إيلاء المعنى، بمعنى الرؤية العميقة للعالم في كليته، الأسبقية، أوعلى الأقل أن لا تعتبر شأنا نافلا، مثلما تنحوأي نزعة ميكروثقافية وجمالية ذاتوية صرف.
لقد أعاد في كتابه بواسطة الحفر تنضيد البنيات الفكرية، والجمالية خاصة، كما سادت في مجمل الثقافة الغربية، بدءا من الإغريق، وإلى الطلائعيات الأخيرة، راصدا علاقات الشد والجذب بين مفهومي الشكل والمضمون، من ناحية، ومفهوم الجمال، بالتالي غائية الخلق/ الإبداع في تنازعها بين المتعة والمنفعة، احتكارالنظرة والتقويم وعمومية التلقي كمنتج لجمالية حديثة، من ناحية أخرى، ليرسم مجموعة القطائع التي ارتسمت على مساحة خريطة المعرفة الإستطيقية بتجلياتها التعبيرية والتشكيلية يعلو فيها الرسم البياني أحيانا ليبلغ ذروة عكوف الفن على الفن وانفصاله عن محيطه، لكنه إجمالا لم ينقطع البتة عن جذرالحياة، محذرا في الوقت ذاته من النزعات الشكلية المفرطة، والروح“الهلنستية” وكلِّ مستمد من جذر فلسفي يعتبر الفرد الموجود الوحيد.
هي عملية إعادة تنضيد تستعين بتاريخ الأدب والمعرفة الفلسفية في الثقافة الكلاسيكية والفرنسية والألمانية، من العجيب أن لا تشمل السلافية إلا عبورا، وتنزع في الأخيرإلى مؤاخذات غيرمباشرة، أولا، على الإبداع السائد في فرنسا الغارق في أنويته، والذي لم يعد سرديا يحلق أبعد من التخييل الذاتي، وثانيا، وهو الأهم، للوصول إلى لحظة قراءة صك الإتهام المباشر ضد الجرم الذي يجعل الأدب في خطر. صك يمهد بالتماس ظروف تخفيف يراها طرف الإتهام في ما عاشته أوروبا جراء الحربين العالميتين بنتائجهما الوخيمة على أصعدة مختلفة، هي التي ولدت أجواء الخراب النفسي والإهتزاز الشامل للقيم، لكن المناخ السوداوي يستفحل ليقوقع الإبداع وينزع إلى مزيد من قطع صلته بالعالم الخارجي وروافده الحية. وإذا كانت البيئات الفنية الغربية قد انشطرت إلى تيارين كبيرين، شكلي، شكلاني، مغرق في النزوع الفرداني، وثانٍ يوتوبي، سليل المجتمع الإشتراكي الماركسي، منتج الواقعية الإشتراكية ومحالياها التفاؤلية المزعومة لصالح الإنسان، فالغلبة للأول، إبداعا، ومدارس نقدية، وتوجيها إعلاميا، ورؤية ثقافية، ما يولد صورة ضحلة للفن والأدب. وهو ما يناهضه بشدة، في مضمار منهجية تدريس الأدب في التعليمين الثانوي والجامعي، الهادفة إلى تلقين طرق التحليل البنيوي للنص، لا فهم النص ذاته، بما يحول الأداة في حد ذاتها إلى هدف، أي إغفال المعنى الذي هو الغاية. نعم للمقاربة البنيوية، ولكل ما حملته من تجديد، شريطة أن تحافظ على وظيفتها الأداتية بدل أن تنقلب هدفا؛ إن في هذا قتلا للأدب!.. بقدر ما يتصدى للجرم المقترف بمحاولة إعادة الإعتبارلمفهوم الأدب، بما يفتحه من آفاق شاسعة للغنى الداخلي للإنسان وتعبيره، ما سميناه في المطلع سؤاله المعرفي، وبكل ما يتيحه التعبير،عندما نفهم يقول الباحث البنيوي الإنساني، في آن، من تجديد محتوى سؤال: ما الذي يستطيعه الأدب؟ مستهلا الجواب بقوله “إنه يفتح إلى ما لا نهاية إمكانية التفاعل بين الأفراد ولإثراء عالمنا بلا حدود (...). يسمح لكل واحد منا بالإستجابة لشرطه الإنساني.”(ص 16) وأن“الحياة الحقيقية هي الأدب، وأن كل ما في العالم يفضي إلى كتاب”(88ص ) أو ليس جديرابنا نحن الذين تتلمذنا على التيارات البارتية التودوروفية الجينيتية الغريماسية، البنيوية، السميائية،السردانية، سواء غيبا أو بوعي أن نبادر إلى مراجعة ثقافتنا النقدية، وطرح أسئلة جديدة مماثلة وأعمق؟.




