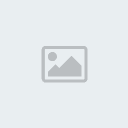
يعتقد
إدموند بيرك أن فقهاء القانون ليسوا إلا مؤرخين تعوزهم الدقة. لوا ينبع هذا
الرأي من نقص في تحليله بقدر ما يعبر عن سخطه على جماعة من فقهاء القانون
الإنجليز الذين عاشوا في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، وربطوا أنفسهم
بالتراث القانوني لأسلافهم، أولئك الأسلاف الذين اعتبروا القانون علماً
نظرياً خالصاً معزولاً عن حركة المجتمع، ومن ثم نظروا إليه على أنه مجرد
مجموعة من المبادئ والقواعد المستخلصة من مجموعة من المعايير الثابتة التي
لا تتأثر بالتطور، ولا تختلف باختلاف الزمان ولا المكان.
إن ملاحظات بيرك هذه ما تزال صحيحة في مجملها إلى اليوم على الرغم مما
انتهت إليه المدرسة التاريخية في القانون الغربي من أن القانون نشأ وتطور
تبعاً لنمو وتطور حياة المجتمع. حقاً يوجه المشتغلون بالعمل القانوني
اهتمامهم كل إلى أحدث المصادر القانونية والقرارات التشريعية. ولعله من
الملاحظ كذلك أن القانون الإنجليزي اعتبر عام 1189م أقصى حد للاحتجاج
بالسوابق التشريعية. لكن التشريعات الغربية المعاصرة بإجمال ـ وهذا أمر له
مغزاه الخاص هنا ـ قد أحلت نهج التتبع التاريخي للقانون منزلة ثانوية، فإن
هذه التشريعات تتجه أساساً إلى دراسة القانون بالنظر إلى ما هو عليه في
الواقع أو بحسب ما ينبغي أن يكون عليه، لا باعتبار ما كان عليه في الماضي.
ومهما يكن من أمر فإن التشريع الإسلامي ـ في صورته التقليدية ـ يقدم لنا
مثالاً واضحاً تماماً للعلم القانوني المنفصل عن الاعتبارات التاريخية.
فالقانون في النظرية الإسلامية التقليدية أحكام الله المنزلة من عنده
(عزوجل) التي أوجبها على عباده، وهي سابقة في وجودها وجود الدولة
الإسلامية، لا مسبوقة بها، وهي حاكمة للمجتمع الإسلامي وليست محكومة به.
ويترتب على ذلك استبعاد النظر إلى تطور القانون في ذاته على أنه ظاهرة
تاريخية وثيقة الصلة بنمو المجتمع وتطوره. أما تدرج الكشف عن أحكام الله
(عزوجل) وصياغتها فمن الطبيعي التسليم بخضوعه للنمو والتطور الذي ينقسم حسب
ما ارتضاه النظر التقليدي منهجياً إلى مراحل عديدة متميزة: لقد كان لزاماً
أن يوجد المهندسون الذين وقع عليهم عبء التخطيط في البداية، ليتلوهم أهل
الصناعات المختلفة الذين تعهدوا خطة الأولين ونفذوها. وكان إسهام الأجيال
المتعاقبة بعد ذلك أن تضيف إلى هذا البناء ما رأته مناسباً من تحسينات
وزخارف. وحينما اكتمل هذا البناء وجد المتأخرون أنفسهم في موقف سلبي فلم
يستطيعوا إلا أن يكونوا حراس هذا الصرح الأبدي. لكن ظل النظر إلى هذا
التطور باعتباره أمراً معزولاً تماماً عن التطور التاريخي للمجتمع. إن دور
الفقيه لم يكن محدداً بمعايير موضوعية تنبع من ظروف زمنه ومجتمعه بل هو على
العكس من ذلك محدد بمعايير ذاتية بحتة تنبع من مجرد ما لآرائه من قيمة في
تتبع الكشف عن الحكم الشرعي. وهكذا تفتقر الصورة التقليدية لتطور الفقه
الإسلامي إلى البعد التاريخي تماماً.
ولما كان الوحي الإلهي ق انقطع بوفاة النبي (ص) فإن الشريعة ـ بما تحقق لها
من كمال التعبير والبيان ـ قد صارت إلى الثبات وعدم القابلية للتغيير.
إنها روح مجردة تحلق فوق المجتمع، متحررة من مقتضيات الزمان، وعلى هذا
المجتمع أن يتطلع إلى ما تمثله من معايير مثالية وصحيحة إلى الأبد. ووصف
قواعد هذه الشريعة بالمثالية لا يني افتقار التعبيرات القانونية عنها
للاعتبارات العملية الملائمة للحاجات الحقيقية للمجتمع، كما أنه لا يعني أن
عمل المحاكم الإسلامية لم يلحق أبداً بهذا المثال، فإنه لا صحة لهذا أو
ذاك. كل ما نريد أن نقرره هنا أن الفكر الفقهي الإسلامي كان في أساسه
تفصيلاً وتحليلاً نظريين أكثر من كونه علم قانون وضعي منبثق من قاعات
المحاكم. وباختصار لم تكن وظيفة التشريع الإسلامي هي التنبؤ بما سوف تلتزم
به المحاكم في الواقع بقدر ما كانت وظيفته إعلام تلك المحاكم في معظم
الأحوال ـ وباستثناء محدود لا يستحق الإشارة إليه ـ بما ينبغي عليها أن
تقضي به.
ويتقرر بناء على ذلك أنه لابد من التفرقة في القانون الإسلامي ـ إذا
استخدمناه بمدلوله الاصطلاحي الذي يعني مجموعة القواعد التي تضبط علاقات
المسلمين ـ بين النظر المثالي والواقع العملي. بين الفقه المدن في بطون
المبسوطات الفقهية والأحكام الواقعية التي طبقتها المحاكم فعلاً. وتقدم هذه
التفرقة أساساً ملائماً للنظر التاريخي الذي سيضطلع بتحديد مدى الاتفاق
والاختلاف بين عمل المحاكم وقواعد الشرع. وتجدر الإشارة إلى أن التراث
الفقهي الإسلامي لم يحفل كثيراً بالنظر إلى هذا الضرب من التناول. وحقيقة
لا تنقصنا كتب الطبقات في أحقاب معينة، وكذا لا تنقصنا المظان المتعلقة
بالولايات غير القضائية ونحوها، ولكن تلك الكتب والمظان لا تمثل تسجيلاً
مستقصياً ومستوعباً للتطبيق القانوني، كما أنها أقل من أن تعد محاولة
للمقارنة بين هذا التطبيق ومقابله من الرأي الفقهي، والأمثلة القليلة التي
تروي عن اعتراض بعض الفقهاء على التطبيق القانوني ليست إلا إستثناءات،
لكنها تكشف عن الموقف السلبي الذي اتخذه غالبية الفقهاء. وما يمكن تقريره
هنا أن معايير القانون الشرعي واحتياجات العمل السياسي لم يلتقيا غالباً.
ولربما كانت القوة المستبدة للسلطة السياسية هي التي ألجأت الفقهاء إلى
التحوط باتباع أسلوب التباعد والتجاهل بدلاً عن المجاهرة بالإنكار
والاعتراض على ما يجري من تطبيقات قانونية. وعلى أية حال فلعل طبيعة التراث
الفقهي ـ بالإضافة إلى عدم وجود أي نظام لتسجيل خطوات التقاضي ـ مسؤولة عن
جعل البحث التاريخي في الخلاف بين الجانبين النظري والواقعي واجباً على
قدر كبير من الصعوبة. لقد ألقى المستشرقون الضوء على بعض أوجه الاتفاق
والاختلاف بين هذين الجانبين، ولكن ما يزال النطاق الذي تم فيه ترجمة النظر
الفقهي إلى واقع ـ في أزمنة وأمكنة معينة ـ أمراً غامضاً إلى الحد الذي
يشكل نقصاً خطيراً في معرفتنا بتاريخ التشريع الإسلامي.
توضح هذه الملاحظات المختصرة على طبيعة الشريعة الإسلامية أن مفهوم التطور
التاريخي للقانون كان غريباً وأجنبياً تماماً في الفهم التقليدي للشريعة،
وأن التاريخ القانوني ـ بمفهومه الغربي لم يكن نوعاً من الدراسة لم ينل حظه
من الاهتمام فحسب، بل الحق أنه لم يوجد قط. وقد دعا إلى مراجعة هذا الموقف
التقليدي مراجعة جذرية في القرن الحالي تطوران مختلفان في طبيعتهما
ومنشئهما، وإن ربطت بينهما أهميتهما العميقة هنا، كما سيتبين، أولهما:
إصدار يوسف شاخت بحثه عن أصول التشريع الإسلامي الذي لا يزال مقبولاً في
أسسه العامة، والذي أثبت فيه أن النظرية التقليدية للقانون الشرعي كان
نتيجة عملية تاريخية معقدة استغرقت قريباً من ثلاثة قرون، وإن كانت شاخت ـ
ينسب كرماً منه ـ الفضل في تحديد منهجه إلى سلفه العظيم إجناس جولد تسيهر ـ
وقد توالت بعد ذلك أبحاث المستشرقين لتؤكد تلك الصلة الوثيقة بين نمو
الفقه الإسلامي، وظروف الواقع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وثانيهما:
تغير مفهوم الفقه وانحساره عن حدوده الجامدة التي لا تقبل التطور: بما حدث
في العالم الإسلامي بعامة من تغيرات قانونية في العقود القليلة الماضية،
وبما حدث في الشرق الأوسط بخاصة من تعديلات في قانون أحكام الأسرة المعمول
به في المحاكم، هذه التعديلات التي أتاحت له التلاؤم مع ظروف المجتمع
وطبيعته.
وعند هذا نشأ تاريخ التشريع الإسلامي. ويصح الآن النظر إلى الشريعة على
أنها نظام قانوني متطور، كما يصح وضع التصور التقليدي للقانون موضعه
التاريخي الحقيقي. لقد كان هذا الفهم التقليدي أساساً لنوع من التناول تبدو
فيه الأحكام الفقهية بمظهر التعبير عن إرادة الله التي لا راد لها. ويتميز
هذا النوع من القوانين السماوية عند مقارنتها بالقوانين المعتمدة على
العقل الإنساني بخاصيتين أساسيتين، أولاهما: أنه نظام ثابت لا يتبدل، ومن
ثم فإن معاييره ثابتة ثبوتاً مطلقاً، وليس لأية سلطة قانونية حق تغييرها.
وثانيتهما: أن الشريعة الإسلامية المنزلة تمثل السمت الموحد لجميع شعوب
العالم الإسلامي، على حين أن الاختلاف سيكون هو النتيجة الحتمية لقوانين من
وضع العقل الإنساني المتأثر بالظروف المحلية الخاصة والمعبر عن احتياجات
مجتمع معين. وبناء على هذا فسيكون من الممكن قياس التطور التاريخي للتشريع
الإسلامي ـ الذي يتمثل في ثلاث مراحل متميزة مر بها التشريع الإسلامي في
صورته التقليدية: هي النمو والاكتمال والانحدار ـ على أساس من مبدأي الثبات
والوحدة.
ويمكن القول بأن فترة نمو الفقه التي بدأت في القرن السابع (الأول الهجري)
وانتهت في القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) قد شهدت تضاؤل الخلاف بين
أجزاء العالم الإسلامي بالتدريج، وكانت عوامل المرونة التشريعية تتجه إلى
الانحسار كلما تقدمت النظرية التقليدية لتكسب أرضاً جديدة. وهكذا دخل النظر
الفقهي في قالب من الجمود منذ القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) لم
يتخلص منه حقيقة إلا في القرن الحالي. وربما حدثت بعض المبالغات المسرفة في
تصوير هذا الجمود وتحديد درجته، وبخاصة في غير مجالات القانون الأسري، فإن
المبادئ الشرعية الثابتة قد اتسعت لكثير من الخلافات الواسعة في الرأي بين
المذاهب الفقهية من جهة بين أشخاص الفقهاء من جهة أخرى. ولكن يبقى من
المؤكد مع ذلك أنه كانت هناك فجوة أخذت تتزايد بين مقررات النظر الفقهي
التقليدي ومطالب الحياة المتنوعة للمجتمع المسلم. ولقد ظل العرف المحلي
معمولاً به في تلك الوقائع التي بدت فيها الشريعة غير قادرة على تلبية
الحاجات الضرورية مما أدى إلى التوسع في اختصاصات المحاكم غير الشرعية.
ثم جاءت ـ وعلى نحو مفاجئ ـ الحركة الحديثة للتجديد التشريعي، لتنهي حالة
الجمود التي كان عليها الفقه طوال تلك الفترة. وكما حررت فكرة العدالة
القانون العرفي الإنجليزي من قيود العصور الوسطى الثقيلة فلقد حررت هذه
الحركة شرايين الشريعة وأوصالها المتيبسة. ويرى المجددون إمكان تطوير الفقه
حتى يتلاءم مع حركة المجتمع ويدعم تقدمه في العصور الحديثة. ومن ثم فإن
الاتجاه السائد لديهم هو الميل إلى مزيد من المرونة في التشريع. وقد كانت
النتيجة التي لا معدى عنها لذلك الميل هي الاختلاف المتزايد على امتداد
العالم الإسلامي. وترجع هذه النتيجة كذلك إلى اختلاف معالجة الفقه التقليدي
للتوفيق بينه وبين ظروف الحياة الحديثة المختلفة باختلاف بلاد العالم
الإسلامي، وتنوع صور الحياة التي أخذت بها.
ومن الضروري في الحقيقة التمييز بين الفلسفة القانونية الإسلامية الحديثة
وما كانت عليه في صورتها التقليدية، غذ تفترض الفلسفة القديمة التقليدية أن
القانون منزل من لدن الله (عزوجل) وأنه يحدد الأحكام التي يجب احتذاؤها في
بناء الدولة والمجتمع دائماً وأبداً. ويتلوّن القانون في التناول الحديث
باحتياجات المجتمع، ووظيفته هي الإجابة على المشكلات التي يواجهها المجتمع.
ويشبه هذا التمايز ـ مع قدر من التوسع ـ ذلك الجدل المحتدم في التشريع
الغربي الحديث بين أنصار مذهب القانون الطبيعي وأتباع المدرسة الاجتماعية.
غير أن النمط الذي ينادي به المجددون المسلمون يقدم في الحقيقة مثلاً هاماً
للتوفيق بين هذين الاتجاهين. ولربما كانت ((الهندسة الاجتماعية Social
Engineering بعبارة العالم الأمريكي Dean Pound هي الوصف المناسب لهذا
النوع من النشاط الذي يقوم به المجددون المسلمون. إن الحكم القانوني في
الإسلام لا يتحدد وفقاً لاحتياجات وتطلعات المجتمع وحدهما، إنما يمكن إعمال
هذه الاحتياجات وتلك التطلعات على نحو مشروع في حدود المعايير والمبادئ
التي أمر بها الشرع على نحو لا يقبل التغيير ولا التبديل. لكن المسألة التي
لم تحسمها حركة التجديد الحديثة هي: إلى أي مدى يمكن إعمال هذه الاحتياجات
والتطلعات في إطار المبادئ الشرعية.
ومن ثم فإن الصدام بين أحكام الفقه التقليدي التي يُدّعى عدم قابليتها
للتغيير وبين متطلبات المجتمع الحديث يثير أمام مفكري الإسلام مشكلة ذات
طبيعة أصولية، إنه لا يمكن للمصلحين تبرير إصلاحاتهم القانونية اعتماداً
على مجرد ما تمليه الضرورة الاجتماعية، إذا أريد للقانون أن يظل محتفظاً
بطبيعته، باعتباره تعبيراً عن الحكم الإلهي، وإذا أريد له أن يبقى في
النهاية قانوناً إسلامياً. وعلى هؤلاء المصلحين إذن أن يجدوا الأسس الفقهية
والأدلة المؤيدة لآرائهم في المبادئ التي قررتها الشريعة صراحة أو ضمناً.
ولقد كان من الصعب إيجاد تلك الأسس والأدلة في ظل تغلب النظرة الفقهية
التقليدية. وفي هذا المجال بالذات تبدو الصلة بين الجهود التشريعية لهؤلاء
المصلحين وبين نتائج دراسات المستشرقين على قدر كبير من الوضوح.
ويتمثل مستند اتجاه التشريعي بصورته المتطرفة في فكرة أن التشريع الإلهي لم
يرد بأحكام تفصيلية مستوعبة ولا جامدة، خلافاً لما ذهب إليه أصحاب الاتجاه
المحافظ، وإنما جاء بمبادئ عامة ومجملة تحتمل عدة تفسيرات وتأويلات تختلف
باختلاف الأحوال والعصور. ومن ثم فإن الاتجاه التجديدي هو حركة تستهدف
ضرباً من ((التأويل التاريخي)) للتنزيل الإلهي. وقد برهن المستشرقون على أن
نشأة الفقه الإسلامي لم تكن إلا نوعاً من تحقيق معطيات النصوص الشرعية في
إطار الظروف الاجتماعية المتغيرة، فقدموا بذلك أسس الواقع التاريخي الذي
يدعم الفكرة التي تقوم عليها النظرة التجديدية. والواقع أنه بمجرد أن توضع
النظرة التقليدية في سياقها التاريخي باعتبارها مجرد مرحلة في التطور
التشريعي فإن جهود المجددين لن تبدو بأية حال منفصلة انفصالاً كاملاً عن
المفهوم التقليدي الذي كان يبدو بمظهر الاتجاه الصحيح الوحيد، بل ستغدو
امتداداً للتقاليد الفقهية الأصيلة، باتخاذها نفس الموقف الذي اتخذه الأئمة
الأوائل، وبإحيائها للذخائر الفقهية التي توقف نموها ـ على نحو مفتعل ـ
حوالي عشرة قرون.
وعلى هذا النحو يمكن لمساعي التجديد أن ترسي أرسخ دعائمها على فهمها الصحيح
للتطور التاريخي للفقه. والحق أن علم تاريخ التشريع يكتسب أهمية حاسمة لم
تكن له في الماضي، بسبب تحفز حركة التجديد للتوثب والانطلاق، واستشراف
التشريع الإسلامي للدخول في عصر جديد. ومن ثم فإن الفقيه المسلم لا يسعه
أبداً أن يخاطر بوضع نفسه في زمرة أولئك المؤرخين الذين تعوزهم الدقة.




