بلاغة المفردة القرآنية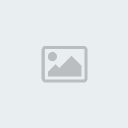
إنّ
تاريخ المفردة يُذكِّرنا بكثير من الأحكام النقدية التي كان لها حضورها على
صفحات كتب النقد الأدبي، والإعجاز القرآني. ففي الذاكرة بيت المسيّب ابن
علس، وتعليق طرفة عليه، وما رُوي عن حسان بن ثابت، وما قيل له، وفي العصر
العباسي بيت ابن هرمة وغير ذلك كثير. ولكنّها أحكام مُتفرِّقة لم تُجمع،
إلى أن تلقفتها كتب النقد الأدبي، وكتب التفسير، وكتب البلاغة، وكتب
الإعجاز القرآني.
فتجد أهل التفسير – على سبيل المثال – يُفرِّقون بين كلمة (المُسَحَّرين)
في قوله تعالى حكاية عن قوم صالح (ع): (قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
الْمُسَحَّرِينَ * مَا أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ
شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (الشعراء/ 153-155)، وكلمة (المُسَحَّرين) في
قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب (ع): (قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
الْمُسَحَّرِينَ * وَمَا أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (الشعراء/ 185-187).
فقد ذهب المفسرون إلى تأويل هذه المفردة بما يتناسب مع سياق الآيات، ومع
آراء النحويين واللغويين كذلك. ولكنّ أصحاب كتب المتشابه اللفظي، ومن عُنِي
بالجانب البلاغي من أهل التفسير ذهبوا إلى البحث عن دلالة حذف الواو من
قصة صالح، وذكرها في قصة شعيب عليهما السلام. ولمّا كان إهتمامنا في هذا
المقام بمعنى هذه المفردة في القصتين، فقد تجنبت البحث عن سر ذكر الواو، أو
عدم ذكرها، واكتفيت بما يُسعِفُ في تحديد دلالة لفظة (المسحّرين).
لقد عرض أئمة التفسير لهذه المفردة، وذكروا الأوجه المحتملة لمعناها، حتّى
أفهموا القارئ أنّها من المشترك اللفظي، ولكنّهم لم يُصَرِّحوا بترجيح معنى
على آخر؛ فعند الفرّاء أنّها بمعنى المخوَّف، والمعلّل والمخدوع، أمّا ابن
جرير الطبري فقد نص على الإختلاف في معناها، فقال بعضهم هي بمعنى:
المسحورين، وقال آخرون: بمعنى المخلوقين، وقال أهل البصرة: كل من أكل من
إنس أو دابّة فهو مُسَحَّر، ومثله عند بعض نحاة الكوفة، ثمّ قال: "والصواب
من القول في ذلك عندي: القول الذي ذكرته عن ابن عباس، أن معناه: "إنّما أنت
من المخلوقين الذين يُعَلَّلون بالطعام والشراب مثلنا، ولست ربّا ولا ملكا
فنطيعك، ونعلم أنك صادق فيما تقول".
وذكر الزمخشري في التعليق على الآية الواردة حكاية عن قوم صالح، أنّه الذي
سُحِرَ كثيراً حتى غلب على عقله، وقيل هو من السحر الرئة، وأنّه بشر. ولكن
إعتماداً على ذكر الواو وحذفها، فقد رأيت أنّه يُرَجّح في قصة صالح
البشرية، وفي قصة شعيب يُرجِّح السحر والبشرية معاً، قال: "فإن قلت: هل
اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا، وتركها في قصة ثمود؟ قلت: إذا أدخلت الواو
فقد قُصد معنيان، كلاهما منافٍ للرسالة عندهم: التسحير والبشرية، وأنّ
الرسول لا يجوز أن يكون مسحّرا، ولا يجوز أن يكون بشرا. وإذا تركت الواو
فلم يُقصَد إلا معنى واحد، وهو كونه مسحّراً، ثمّ قرر بكونه بشراً مثلهم.
وذكر البقاعي ما في المعنى من إختلاف، ثمّ رجَح في قصة صالح رأي ابن عباس،
الذي اختاره الطبري من قبل، وذلك إعتماداً على قوله تعالى بعد ذلك: (مَا
أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا)، أي فما وجه خصوصيتك عنا بالرسالة، وهل يكون
الرسول من البشر؟.
وذكر الإسكافي أربعة أقوال في معنى المُسَحَّرين، أوّلاً: الذين لهم سحر
وروية، وثانياً: المعللون بالطعام والشراب، وثالثاً: المسحورون، ورابعاً:
المخلوقون.
والذي يبدو لي كما قال الزمخشري، أنّ الأولى في قوم صالح بمعنى البشرية،
وفي قصة شعيب بمعنى السحر والبشرية وغير ذلك من الوجوه. وإنّما ذهبت إلى
ترجيح هذا الرأي على غيره، لأنّ قوله تعالى في قصة صالح: (مَا أَنْتَ إِلا
بَشَرٌ مِثْلُنَا)، بدل من قوله تعالى: (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
الْمُسَحَّرِينَ)، والبدل عين المبدل منه، أو على معنى التأكيد، حيث حُذِفت
الواو. وفي قصة شعيب ذكرت الواو فأفادت أن ما بعدها يختلف عمّا قبلها،
فحملت (المسحّرين) دلالات متعددة أساسها المكر، والخديعة.
وهنالك مُرَجِّحٌ آخر على أنّ دلالة (المسحّرين) في قصة شعيب أوسع منها في
قصة صالح، وهو الشدة والغلظة في حديث قوم شعيب له، وطلبهم لآية خاصة، ثمّ
نَعتُهم لنبيهم بالكذب، وفي خبر بعد خبر. وهذا غير موجود في قصة صالح.
فاقتضى ذلك أن تكون دلالة (المُسَحَّرين) في قصة شعيب أكثر إيغالا في
الإتهام منها في قصة صالح.
ونقرأ في كتب إعجاز القرآن، فلا نكاد نغادر مبحثاً إلا وفيه من الأمثلة على
بلاغة المفردة القرآنية الشيء الكثير، حتى حار المرء في ذكر المثال خشية
التكرار، فالخطابي يُظهر لنا محاسن إختيار لفظة (فأكله) على افترسه، في
قوله تعالى: (.. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ...) (يوسف/ 17)، وغيرها من المفردات.
وبعيداً عن إستقصاءالأمثلة التي ملأت كتب القدماء، ودراسات المحدثين، نجد
أنفسنا أمام عدد من الأمثلة التي تلامس موضوع المتشابه، وتتنبه له، الأمر
الذي يدعو لذكر بعضها، والتعليق على بعضها الآخر، وعلى جهود الباحثين الذين
كتبوا في مثل هذه الموضوعات، ليتقرب بذلك موضوع الدراسة من نقد النقد، أو
نقد بعض الدراسات التي تناولت المفردة القرآنية.
ففاضل السامرائي مثلاً تخصص في مثل هذه المباحث، وصنّف فيها مجموعة من
الكتب منها: (التعبير القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) و(لمسات
بيانية في نصوص من التنزيل). ولقد استطاع السامرائي أن يُخرِجَ للناس
تُراثاً طيِّباً من المتشابه اللفظي، والنكات البيانية والنحوية، بعد أن
كانت حبيسة الكتب القديمة. ولكن يُؤخذ عليه تقديم القاعدة النحوية – في
كثير من الأحيان – على السياق القرآني، ونقله آراء غيره من المفسرين،
وأصحاب كتب المتشابه اللفظي، وعدم عزوها إلى مظانها في كثير من الأحيان،
حتى يُخيَّل للباحث فضلا عن عامة الناس أن ذلك من إستنباطه، تماماً كما كان
الشعراوي يفعل في تفسيره. غير أنّ في كتبه أمثلة تغني الباحثين ودراساتهم،
وإن كانت في مجملها مبثوثة في كتب التفسير والمتشابه اللفظي.
ففي كتاب التعبير القرآني يُبيِّن لنا السامرائي أنّ العرب توقع الجمع
تمييزا للقلة، وتوقع المفرد تمييزا للكثرة، فيقولون: ثلاثة رجال، فإذا زاد
على العشرة وصار كثرة، جاؤوا بالمفرد، فيقولون: عشرون رجلا. وبهذا يحل
إشكال تكرر اليوم (365) مرّة، وتكرر الأيام (30) مرّة. ويتحدث عن البنية في
التعبير القرآني، معتمداً على دلالة الفعل، ودلالة الاسم، ثمّ إستخدام
الفعل بدون المصدر وغيره من الموضوعات.
ويذكر في الكتاب نفسه مجموعة من الأمثلة التي سأُعالج بعضها بعد قليل، وذلك
مثل قوله تعالى: (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا
مَعْدُودَةً...) (البقرة/ 80)، وفي آل عمران: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ...) (آل عمران/ 24).
ويقف أيضاً مع قوله تعالى: (.. لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ
رَبِّي...) (الأعراف/ 79)، وقوله في آية أخرى: (.. لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالاتِ رَبِّي...) (الأعراف/ 93). ثمّ يفرق بين قوله تعالى:
(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ)
(الأعراف/ 78 و91)، وقوله تعالى: (.. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
جَاثِمِينَ) (هود/ 67 و94).
هذه الأمثلة، وغيرها من مثلها، سيجد القارئ بعد دراستها أنّ السامرائي
يُغْفِلُ أحياناً دلالاتها، ويكتفي بتبيان سبب مجيئها على هذا النحو من
التعبير، فلا يزيد عمّا قاله السابقون إلا قليلا، ومع ذلك فإنّ جهده في
تقريب هذه المسائل إلى الناس طيِّب وواضح جدّاً.
وتحدث فضل عباس عن الكلمة القرآنية، في جميع كتبه وبحوثه، ولو أخذنا على
سبيل المثال حديثه عنها في كتابه (إعجاز القرآن الكريم)، نجده يُقدِّم
للكلمة القرآنية بعبارات، لو أفردت كل واحدة منها بالتمثيل لصار المبحث
مباحث، ثمّ يحدثنا عن قيمة الكلمة في العصور السابقة، إلى أن يقودنا إلى
خصائص المفردة القرآنية، وما تعطيه من قيم ودلالات يصعب حصرها.
وفضل عباس يُنكِرُ الترادف في القرآن الكريم، ومن ثمّ نجد له مبحثاً
بعنوان: دعوى الترادف في القرآن، يقف فيه على مجموعة من الأمثلة، ويُبيّن
الفرق بينها، وهو في ذلك لا يصدر عن هوى، إنّما يستقري النص القرآني،
ويعتمد السياق، ويُوظّف ما لديه من أدوات نحوية وبيانية، حتى يطمئن إلى
المعنى المُستخرَج. نجد ذلك في تفرقته بين قام، ووقف، وقعد في قوله تعالى:
(.. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا...) (البقرة/ 20)، وقوله تعالى:
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ) (الأنعام/ 30)، وقوله تعالى:
(وَقِفُوهُمْ إنَّهُم مَسْئُولُونَ) (الصافات/ 24)، وقوله تعالى:
(وَقَالوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ القاعِدِينَ) (التوبة/ 86)، وقوله تعالى:
(وأنَّا كُنّا نقُعُدُ مِنها مقاعِدَ لِلسَّمعِ) (الجن/ 9)، وقوله تعالى:
(والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ) (النور/ 60) وغيره كثير.
ويجمع الآيات التي تتحدث عن الخوف، والآيات التي تتحدث عن الخشية، ويُفرِّق
بين المفردتين. وكذلك الحال مع (جاء وأتى) و(الفعل والعمل) و(القعود
والجلوس) و(الإعطاء والإيتاء) و(السنة والعام) و(الشك والريب) و(اللوم
والتثريب والتفنيد) وغيره.
ثمّ يسير بنا بعد ذلك، إلى أن ينتهي إلى إستعمال الألفاظ المختلفة في
المواضع المتشابهة، وهذا من أقرب المباحث لموضوعنا، فيفرق فيه بين إستخدام
(الإلقاء) و(القذف) في سياق متشابه، وهو سياق الجهاد ومحاربة الأعداء.
وكذلك الفرق بين (حادّ) و(شاق). وفي سياق الحديث عن أهل الكتاب فرّق بين
(الإغراء) و(الإلقاء)، وختم فضل عباس بالفرق بين (الدثار) و(التزمل). وهي
في مجملها أمثلة وثيقة الصلة بموضوعنا، وقد ذكَرْتها من كتبه دون غيرها من
الكتب، وإن كانت في غيرها موجودة؛ نظرا لما فيها من معانٍ جديدة، لم يُسبق
في كثير منها، وإلا فما أكثر مَن درس الترادف، والمشترك اللفظي، والتضاد
وغير ذلك من لغة القرآن الكريم. وهذا لا يعني بالضرورة أن أحدا لم يأت
بجديد في دراسة المفردة القرآنية، وإنّما قصدت أنّ الإشارة إلى مباحث فضل
عباس، تغني عن التكرار، وتصلح لأن تكون تمهيدا للحديث عن المتشابه اللفظي
في المفردة القرآنية أكثر من غيرها.
ومع ذلك فإنّ الحديث عن الترادف لا يُمكن أن يُحسم في مثال أو مثالين، فهو
يحتاج إلى دراسات مستقلة، وقد كانت وعُرِض لآراء الفريقين: مَن يُنكِر
الترادف، ومَن يؤيده، وكان هدف الفريقين إثبات المزيّة، وليس الطعن في لغة
القرآن. ومن ثمّ فإن ما يعنينا نحن في هذه الدراسة هو البحث عن سر التعبير
بهذه الألفاظ، سواء أقيل هي من الترادف، أم نُفِيَ عنها ذلك، المهم ألا
يكون القول بالترادف حائلا دون البحث عن سر التعبير بها، أمّا أن ننعت
الكلمات أو الأشياء دون البحث عن سبب الإستخدام فهذا غير مقبول في التحليل
البياني.
إنّ المفردة أصل الدقّة في التعبير القرآني، وذلك في إختيار الألفاظ،
وإنتقاء الكلمات، فالمعرفة لها شأنّها، والنكرة لا تقل عن ذلك، ومثله
إختيار المفرد أو الجمع، وغيره من أنواع التصريفات، شرط أن يكون ذلك
محكوماً أو موَشَّحا بدقة المعنى، والوفاء بالقصد، إضافة إلى تحديد
المدلول، حتى تُمسي المفردة كأنّها خلقت لهذا الموضع دون غيره، فلا المكان
يُريد بساكنه بدلا، ولا الساكن يبغي عن منزله حِولا، كلمات قرآنية يراها كل
واحد مقدَّرة على مقياس عقله، وعلى وفق حاجته.
ولقد أوجف البلغاء بركابهم، وجلبوا ما استطاعوا من خيلهم ورَجِلِهِم،
ولكنهم اعترفوا جميعا أنهم ما زالوا على ساحل النص القرآني، ولم يغوصوا في
لججه، وكتابُ الله كما قال ابن عطية في مقدمة تفسيره لو نُزِعت منه لفظة،
ثمّ أُدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. وقريب من هذا المعنى
ما ذكره محمد عبدالله دراز: "ضع يدك حيث شئت من المصحف، وعد ما أحصته كفّك
من الكلمات عدّا، ثمّ أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجاً عن الدفتين،
وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني إلى ذاك. ثمّ انظر: كم كلمةً
تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة
تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك (.. كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (هود/ 1).
المصدر: كتاب المتشابه اللفظي في القرآن الكريم




