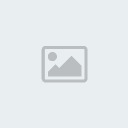
في مقالة له في جريدة USA Today بتاريخ 9/8/2010 بعنوان "لماذا الدين"
أجاب الكاتب أوليفر توماس عن هذا السؤال مورداً ثلاثة تبريرات واهية ضعيفة
كاشفاً عورة الدين وأسسه الواهية فهو يدَّعي:
1. أنّ الدين يجعلنا راغبين بالحياة،
2. أنّ الدين يجعلنا محتشمين ومهذبين،
3. أنّ الدين يعطينا إحساساً بغاية ومعنى الحياة.
يتابع السيد توماس بأن يقدم لنا ثلاثة أسئلة لا يمكننا أن نخضعها للمنهج العلمي ولكنها وبطريقة ما تكشف قيمة الدين:
لماذا نحن موجودون؟ ماذا يعني كلّ هذا الذي حولنا؟ كيف ينبغي لنا أن نعيش إذاً؟
إنّ المقدّمة التأسيسية لهذه التأكيدات والتساؤلات هي بالأساس خاطئة،
والادعاء الأول ربما يكون الأكثر سخافة على الإطلاق، فأنا مثل الملايين من
الناس أرفض الدين تماماً وبشكل مطلق ولكنني أحبّ الحياة وأريد أن أعيشها
إلى أقصى حدودها. وبالنظر إلى الادعاء الثاني فإننا نعرف أن الفضيلة
والاحتشام لم ينبثقا من الدين وتوماس نفسه يقرّ بذلك لاحقاً في مقالته.
أما الادعاء الثالث فهو مرفوض وسندحضه لاحقاً في هذه المقالة.
أما بالنسبة لتساؤلاته الثلاثة فبإمكاني أن أسأل وبنفس الشرعية التي أسبغها عليها:
" لماذا السماء أرجوانية؟"
إنّ هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه لأن مقدمته المنطقية خاطئة متصدعة.
فالسؤال عن ماهية الشيء لا يجعله ذلك الشيء. إن كل سؤال يطرحه توماس يستند
على فكرة لا يمكن دحضها، ولكنها خاطئة في نفس الوقت وهي أن الحياة لها هدف
ومعنى. لقد تمّ تلقيننا أننا فقط نحتاج إلى أن نكتشف ما قد يكون عليه ذلك
المعنى، وفقط بالجواب على هذا السؤال فإننا نستطيع أن نقرر كيف نعيش
حياتنا.
إن هذا لأسوأ حشو وثرثرة منطقية على الإطلاق. نحن نفترض
أن الحياة لابد لها معنىً ما، لذا فإننا نبدأ في البحث عن ذلك المعنى، ومن
خلال عملية البحث هذه نخلق افتراضاً غير مبرهن أن الحياة لها معنى! نحن
نفترض الجواب من خلال طرحنا للسؤال وهذا يفضي بنا إلى نتيجة غير ذات معنى
وغير منطقية.
فبطرحنا للسؤال قد خلقنا مقدّمة خاطئة. لقد جعلنا السماء أرجوانيّة فقط من خلال سؤالنا: لماذا السماء أرجوانية؟!
على أنّه بإمكاننا أن نتجنّب التناقضات المنطقية هذه بالجواب على السؤال: لماذا الدين؟ بدون أن نستحضر ونستشهد بالدين كجواب.
فلنبدأ بإبطال توماس – دون أن يعلم – لفرضيته الخاصة عن سبب وجود الدين،
وبشكل لا علاقة له بأسئلته أو تبريراته الثلاثة. يجمل توماس استنتاجاته من
بحث لفيكتور فرانكل عن معسكرات الموت النازية والتي يصل فرانكل من خلاله
إلى نتيجة أنّه هناك نوعان أساسيّان من البشر: الناس المحترمون المهذبون
والناس البذيئون غير المحترمين. إن هذا التقسيم ليس بين الناس المتدينين
والناس غير المتدينين وبذلك يقوض أي ادعاء بأن الدين هو مكون أساسي مساهم
في الاحتشام والتهذيب. ويقول توماس بصراحة:" ليس كل الدين جيداً". إذاً
وبما أنه هناك أناس بلا دين جيدون وأناس متدينون سيئون فعلى أي أساس يستند
توماس في استنتاجه أن الدين يساعدنا على أن نكون محتشمين محترمين؟ يحاول
توماس أن يتهرب من هذه المعضلة بالاقتباس من آلبرت شفايتزر الذي قال أن
الدين الجيد هو الدين الذي يؤكد على الحياة. هنا نأتي إلى مسألة أخرى
مثيرة للفضول بأن نؤمن أن الدين جيد لأن الدين الجيد هو الذي يؤكد على
الحياة. إذاً بالمقابل لماذا لا نأخذ بعين الاعتبار مسألة أن الدين سيء
لأن الدين السيء هو الذي لا يؤكد على الحياة.
لحسن الحظ نحن لسنا
بحاجة إلى أن نعتمد على توماس لكي ندحض مزاعمه فعلماء الإحاثة الآن
يتقبلون بشكل كبير فكرة أن أسلافنا آمنوا بالحياة ما بعد الموت (الآخرة)
منذ ما يناهز على 300000 سنة. إن عملية الدفن الشعائرية والتي ظهرت أول
الأمر زمن إنسان النياندرتال في مكان ما في تلك الفترة المذكورة هي
العلامة المميزة للدين في مراحله المبكرة، فطقوس الدفن تدل على مفهوم
متطور لفكرة الفناء أو على الأقل هي محاولة لفهم المعاني الضمنية للموت؛
وتوجد احتمالية كبيرة وواقعية بأن الدين هو (مفهوم ما) عن الحياة ما بعد
الموت سبق اللغة كواحدة من أقدم الإبداعات الإنسانية.

إن نشوء اعتقاد ما بفكرة الحياة بعد الموت مبكراً في التاريخ الإنساني أمر
ليس مفاجئاً وغريباً، ففيما يتعلق بمسألة البقاء نحن مبرمجون على الخوف من
الموت، لكن ربما وبخلاف حيوانات أخرى نتحمل ذلك العبء الثقيل القاسي في
تأمل ومعايشة هذا الخوف. إن الدين هو إحدى الوسائل التي من خلالها نتعايش
مع إدراكنا لحتمية الموت فهو يخفف من ألم حقيقته وديمومته، والألم جراء
فقدان شخص نحبه على أمل اللقاء في حياة أخرى. الموت أمر لا يمكن تجنبه وهو
يثير أسئلة واضحة ومقلقة في آن؛ وحتى العقل البدائي بحاجة إلى بعض الأجوبة
من قبيل: ماذا يحدث لشريكتي بعد أن تموت؟ إلى أين تذهب؟ ماذا سيحدث لي؟ هل
سأراها مجدداً بعد أن أموت؟
غير أن الموت ليس وحده الأمر المجهول
المقلق، فهنالك أسئلة محيرة طرحت نفسها في القديم مثل: ما هي كرة النار
تلك التي في السماء؟ لماذا تغادرنا نار السماء لتذهب إلى الظلام الدامس
البارد لتعود مرة بعد أخرى وهكذا دواليك؟ ما هي النقاط البراقة تلك التي
في السماء والتي أراها عندما تختفي كرة النار؟ لماذا يسقط الماء من السماء
أحياناً؟ إن العالم لهو لغز كبير يصرخ بيأس باحثاً عن إجابات.
من
هنا نستطيع أن نزعم أنّ الدين هو وليد الخوف من تلك الأشياء المجهولة
المبهمة العصية على فهم عقل بدائي؛ من الدافع إلى التحكم في أشياء لا يمكن
ضبطها؛ من حاجة الإنسان إلى القدرة على التحكم بقدره في مواجهة عالم متقلب
غامض. وإذا كان الأمر كذلك فالأفكار الأولى للدين لم تنشأ من أية رهبة من
حيرة أو نظام للطبيعة قد يوحي إلى وجود مصَمِّمٍ (خالق) بارع خفي، وإنما
من القلق جراء الأحداث والشدائد التي مرَّ بها الإنسان بشكل يومي، وكيف أن
عظمة الطبيعة أثَّرت في أسلوب حياته اليومي. ولكي يتغلبوا على المرض
والموت والجوع والبرد والجروح والألم فلا بد أن أسلافنا قد بذلوا جهداً
كبيراً في التماس العون من قوىً أعظم آملين بشدة في أن يتمكنوا بطريقة ما
من التحكم بمصيرهم بمساعدة إلهية. وكما هما دائماً فقد اتحد الأمل مع
الخوف بقوة في عالم الألغاز المرعب لخلق أساطير وقصصٍ خيالية عن خبايا
الطبيعة القاسية.
إنّ دماغ الإنسان بارع في طرح الأسئلة، ولكنّه
ببساطة يمتعض من فكرة ترك أي منها بلا إجابة، فنحن عاجزون عن تقبل عبارة
"لا أعرف" لأننا غريزياً لا نستطيع إلا أن نرى نمطاً وندرك سبباً لكل حدث
نواجهه ونكتشفه. نحن نقرر أنه لابدّ أن يكون هناك نمط ما أو سبب ونتيجة
حتى ولو لم يكن أيٌّ منها موجوداً، لذا فإننا نختلق أجوبة بينما نحن في
حقيقة الأمر لا نعرف، نطور فكرة عن أساطير خلق متقنة ومفصلة، آلهة الشمس
والمطر والحرب والبحر. نعتقد أننا نستطيع أن نتواصل مع آلهتنا وأن نؤثر في
سلوكهم لأننا بذلك سنمتلك تحكماً ما، وسنفرض نظاماً ما على غموض العالم
المتَّسم بالفوضى والاضطراب. وللتقليل من الحقيقة المؤلمة لكوننا جاهلين
فإننا نختلق أجوبة نخدع بها أنفسنا متصورين أننا نفهم العالم وقادرين على
تفسيره. لذا فقد كان الدين محاولتنا الأولى في الفيزياء وعلم الفلك.
لكن الدين لم ينشأ فقط من الخوف من المجهول والفناء، والرغبة في التحكم
بسياق الطبيعة وفهمه، بل هنالك سبب آخر وهو الترابط الاجتماعي، فنحن
حيوانات اجتماعية قطيعية بطبعنا. إن خاصية التعاون هي التي تجعل من
الإنسان الحيوان - ذلك المخلوق الضعيف البطيء الحسّاس – قوة هائلة على
الأرض. لكن التعاون يصبح أكثر صعوبة مع تزايد العدد. لذا، فبعض وسائل
الحفاظ على النظام الاجتماعي ضرورية. إن المجتمعات البدائية سرعان ما
تعلمت أن قواعد السلوك التي فُرضَت على هيئة طقوس وشعائر قد مكَّنت جماعات
كبيرة من الناس من العيش في جو أكثر تقارباً وحميمية، فالطقوس تخلق مبادئ
ضد ما قد يجعل الناس يحكمون بسهولة على سلوك الآخرين في بيئات اجتماعية
مختلفة، فأي انحراف عن المبدإ من السهولة تمييزه وكشفه. وبهذه الطريقة
يمكن أن يتمّ الحفاظ على النظام.
لاحظوا أنّ مراهقي عصرنا
الحالي يعبرون عن شخصيتهم الفردية الفظة بتشابههم في ارتداء ثيابهم، وأي
دخيل غير مطابق لهم من السهل تمييزه. إن الدين قدَّم ولازال وسائل واضحة
لتعزيز القواعد المجتمعية من خلال وعد المطيعين بحياة بهيجة في الآخرة،
وبالعقاب الأبدي لسيئي السلوك والتصرف. فالدين يُستخدم كرشوة ليحثّ على
التصرفات الجيدة. في النهاية تحول الدين إلى قوة سياسية صرفة جامحة وهجر
كل دور قد يتصف بالاعتدال والليونة. وإذا استخدم الدين كأداة للتحكم بسلوك
الفرد فلا بد لوجود شخص ليطور هذه القواعد ويضمن تعزيزها وتحصينها، ومن
أفضل من الزعماء الدينيين والشمامسة والقساوسة ليقوموا بدور شرطة السلوك؟
وأية طريقة أفضل لتتلاعب بالناس وتخضعهم لإرادتك من اختلاق قواعد وقوانين
ليمارسوا – مُلزَمين - بموجبها حياتهم؟ ومع هكذا تأثير على الحياة اليومية
لكل مواطن امتُلِكَت السلطة التي تم تأمينها تقليدياً للدول المدنية
والإمبراطوريات مع كل الزخارف الاعتيادية المتعارف عليها مثل الجيوش
والأموال والقصور.
إذنْ، لماذا الدين؟ إنه ضعف الإنسان وسذاجته.
إن العامل المسيطر على جميع الأديان الرئيسية هو تلك الخماسية المخضعة
الجبرية والمكونة من الخوف من الموت، والحاجة إلى تفسير المجهول من لغز
الطبيعة، ورغبة الإنسان في التحكم بمصيره، والنزوع إلى الترابط الاجتماعي،
وإغراء القوة الفاسد المفسِد. إذاً لا مكان في المعادلة للافتراض القائل
بأن الحياة لها هدف ومعنى، وبدلاً من ذلك فالدين الذي نحن خلقناه يتطلب
حقيقة أن الحياة لها غاية كوسيلة لنبرر بها أنفسنا – هذه الغاية يمكننا أن
نجدها فقط من خلال الإيمان – وبما أننا نؤمن بقصة خلقنا الخاصة بنا فإننا
لا نشك، ولا نسأل عن النتائج.
غير أننا نشعر بالامتنان لوجود
طريق أخرى نرى من خلالها العالم. إن النتيجة الأكثر أهمية وجوهرية للنمو
والارتقاء هي أن الحياة ليس لها خطة أو تصميم ولا هدف أو معنىً متأصل فيها
(وهذه حقيقة تم التغاضي عنها غالباً)؛ فالآلية العشوائية للاختيار الطبيعي
تحول دون أي احتمالية للتخطيط والتصميم، وبدون التخطيط فإن فكرة الهدف
تصبح زائدة لا قيمة لها. ولسوء الحظ فإن منهج التفكير هذا لم يتم تقبله
بعد بشكل واسع خارج المحافل الأكاديمية، ولكن أيّة تساؤلات متعلقة بمعنى
الحياة تصبح غير منطقية على ضوء الدروس المستقاة من عملية النشوء والتطور.
وفي عالم بلا تخطيط وبلا هدف لا يمكن أن تكون هناك تساؤلات عن المعنى.
فالسؤال "لماذا" ببساطة ليس شرعياً وصحيحاً عندما يستلزم الجواب المُراد
غايةً أو هدفاً أعلى.
يستطيع أحدنا أن يسأل لماذا تدور الأرض
بعكس عقارب الساعة عندما ننظر إلى القطب الشمالي من علوّ. يشمل الجواب
تاريخ الغازات التي كانت تدور حول نفسها لتتّحد في النهاية، وتشكل كوكب
الأرض. إنّ هذا التفسير يعطينا جواباً للسؤال "لماذا" كمسألة تتعلق
بالتاريخ، وليس كمسألة تنطوي على أو تلمح إلى هدف أو غاية ما. فالسؤال
"لماذا" عند البحث في مسألة ما تتعدى التاريخ كسؤالنا عن السبب الذي جعل
الله الأرض تدور غرب - شرق يبدو غير ذي معنى في عالم بلا تخطيط وتصميم. و
بطرحنا للسؤال "لماذا"، فقط، فإننا نوحي إلى وجود هدف ما. لذا، فبغياب
الهدف يغيب السؤال ذاته ويتلاشى.
إنّ كتّاباً من مثل ريتشارد
دوكينز وستيفن ج. غولد قد كتبوا على نحو بارع ومقنع حول الدروس المستفادة
من تاريخ الحياة متأملين أن الافتقار إلى المعنى خطِر ومرعب لمعظم الناس
في تعاليم الدين الحالية. لكن "اللاتحيّز الصارم الأعمى" لدوكينز لا ينبغي
أن يكون مخيفاً ومقلقاً خاصة عندما ينظر إليه كفرصة لفهم روعة الحياة
بجميع مظاهرها المتنوعة المجيدة. إن تقبل "اللامبالاة" هذه يزيل قيود
وعوائق الآمال الزائفة والوعود الفارغة للدين ويخلق مكانه فرصة لنرى
العالم بوضوح معبرين عن ذواتنا على الأرضية الصلبة للتاريخ الطبيعي. فقط،
عندما نعبر عن أنفسنا بصدق نستطيع حينها أن نطور ونتبنى قوانين أخلاقية
شرعية صحيحة وهادفة لجنسنا البشري. وعندما نتحرر من الخرافات والأفكار
الخاطئة، فقط، نستطيع حينها أن نخلق المعنى والغاية الخاصين بنا كنتيجة
عادلة لكوننا بشريين.
إنّ هذا الجواب على السؤال "كيف ينبغي أن
نعيش" ليس هبة من فوق ولا قانوناً ثابتاً للطبيعة ينتظر أن يتم اكتشافه،
بل هو مستمد من ومعلوم من خلال مكاننا الطبيعي في المجال الحيويّ.
إنّ تقبل اللامبالاة هذه لا يعني قبول عالم ميكانيكي لا مبال خال من الدفء
والألفة، فبتحرير قبضتنا العنيدة المتشنّجة على الأمل الزائف وراء
(التخطيط والهدف والمعنى) سنكون أحراراً في الحركة والانتقال إلى ما بعد
الواقع الجامد البارد لعالم عشوائي، وسيكون باستطاعتنا أن نخلق إحساساً
جديداً وأعمق بالنفس وبالجماعة على أساس تكويننا البيولوجي وتطورنا
ككائنات اجتماعية عاقلة. وعلى سبيل المثال فأي متدرّب جديد على القفز في
الهواء لن يشعر بمتعة الطيران الحرّ إذا بقي متشبثاً بعناد بالطائرة لا
يتركها. وعلى نحو مشابه، يجب أن نتحرر أولاً من الآمال والخرافات الزائفة
حول الغاية الإلهية لكي نستمتع بثمار تحررنا من الأسطورة.
إنّ
مدى صلاحية السؤال: لماذا نحن موجودون هنا (بالتلميح إلى الغرض وليس
التاريخ) تماماً كصلاحية سؤالنا: لماذا توقف مكعّبا النرد على الرقم
ثمانية في المرّة الأولى وعلى الرقم ستّة في المرة الثانية. لا وجود هنا
لكلمة "لماذا" فالمكعّبان توقفا على هذه الأرقام كنتيجة للاحتمالية دون أي
توجيه يدوي باتجاه رقم أو حصيلة معينة. أمّا نحن - مثل أي شيء حيّ على
الأرض - فمكعبات النرد تلك.
إنّ وجودنا – كوجود البكتيريا
والزنابير والورود – هو نتيجة للاحتماليّة دون الحاجة إلى استحضار أو
الاستشهاد بأي شيء ما عدا الجينات والاحتماليّة والاختيار الطبيعيّ.
الدين هو مثل زائدتنا الدودية أثرٌ لا وظيفي من بقايا ماضينا البدائي،
وربّما خلال بضعة آلاف سنة سيستحضر إله إبراهيم نفس التسلية المشوقة
الباعثة على الفضول كما يفعل آلهة المطر والشمس في أيامنا هذه، أو ربما
سيوضع إلهنا ببساطة على الرف مع زيوس وجوبيتر. وإذا حدث ذلك فسوف لن نزعج
أنفسنا مجدّداً بالبحث عن المعنى والهدف كفرض إلهي سماوي، بل سنعمل على
تحديد وإيجاد معنىً وهدف خاصّ بنا بالاحتكام إلى الخير المتأصّل فينا
والمستمدّ من نزعتنا الاجتماعية وتاريخ نشوئنا وتطوّرنا …… يوماً ما.




