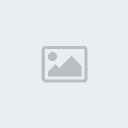
عُدّت فرنسا عموماً حاضنة الحداثة الغربية التي هزت العالم بأطروحاتها وأفكارها التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني مرة واحدة وإلى الأبد. لم تكن الحداثة الغربية شأناً داخلياً تنحصر نتائجه الفكرية والمادية في بقعة جغرافية محدّدة (غربية) لها قوانين وسمات خاصة كما لدى بقية شعوب العالم، بل انداح طوفانها الجارف خارج حدودها بقوة واندفاع فاق في أحيان عديدة درجة القوة التي عاشها في بلد المنشأ فرنسا والعالم الغربي عموماً، الأمر الذي جعل تواريخ بلدان العالم اللاغربي (وهي التسمية التي اعتمدت ربما بعد اندراج العالم كله في تيار الحداثة الغربية) تقف على مفترق طرق صعب وخيارات مصيرية فلم تعد قادرة على الحفاظ على الخصائص والسمات المحافظة لمجتمعاتها التقليدية وأيضاً لم تندرج في سياق الحداثة بشكل كامل نتيجة جملة من العوامل والمعيقات داخلها وخارجها، الأمر الذي جعلها ريشة في مهب الريح، فلا هي رياح الحداثة تحملها إلى آفاق جديدة، تلحمها مع سيرورتها الغربية ولا هو واقعها المحلي بقادر على حمايتها والنهوض بها في العالم الجديد الذي وجدت نفسها مرغمة على الدخول والعيش فيه.
كتاب "الطرق إلى الحداثة، التنوير البريطاني، التنوير الفرنسي، التنوير الأمريكي" يقيم تمييزاً واضحاً بين مدارس الحداثة والتنوير الرئيسية في الغرب كما نستدل مباشرة من عنوانه، وهو أمر غير شائع في العالم العربي حيث يتم التعامل مع الحداثة والتنوير كمفهوم واحد أصله فرنسي بالتحديد ويعود إلى عهد الثورة الفرنسية ومفكريها وفلاسفتها الكبار الذي نظرَّوا لها وتنبؤوا بها، دون ذكر المدارس الانكليزية أو الأمريكية التي اختطت لنفسها اتجاهات مختلفة بالشكل والجوهر.
تتولى الكاتبة جرترود هيلفمارب في كتابها بناء عرض تاريخي مختصر لأسس وأفكار التنوير في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، من خلال ثلاثة فصول تختصر عناوينها الفكرة التي قامت عليها، "التنوير البريطاني سوسيولوجبة الفضيلة، التنوير الفرنسي إيديولوجية العقل، التنوير الأمريكي علم سياسة الحرية"، مع تأكيدها الواضح وتشديدها على التنوير البريطاني، بلغ عدد صفحات الفصل الخاص به ثلاثة أضعاف حجم دراسة التنوير الفرنسي أو الأمريكي، وهو ما يعكس خطتها ومنهجها في الكتاب في استعادة التنوير البريطاني مكانته المفقودة في مشروع الحداثة الغربية المظفر ف"الهدف ليس البرهنة على الأسبقية الزمنية للتنوير البريطاني، وإنما البرهنة أيضاً على طابعه الفريد وأهميته التاريخية". وهي تريد بذلك تكريس الحداثة بنسختها البريطانية - الأمريكية بعيداً عن طابعها الجذري الراديكالي المتمثل بالحداثة الفرنسية وذلك انطلاقاً من موقع يميني محافظ.
أما لماذا احتل التنوير الفرنسي هذه المكانة الفريدة والسمعة الأكيدة بوصفه مصدراً لفكرة التنوير، فبسبب الثورة الفرنسية التي كانت أوّل ثورة في التاريخ تأتي نتيجة أفكار فلاسفة ومفكرين فرنسيين قدموا تحليلات وأفكارا جريئة مثلت إرهاصاً وإيذاناً بثورة قادمة تحققت فعلاً على أرض الواقع. وبهذا المعنى يقول هيغل "إن الثورة الفرنسية نتجت من الفلسفة". وهي لم تؤثر على فرنسا والغرب فقط بل امتد تأثيرها على العالم كله، وهذه ناحية افتقدتها الثورة الأمريكية رغم نجاحها الساحق، فصارت مرجعاً تاريخياً ودليل عمل للثورات القادمة في أنحاء أوربا وأيضاً العالم اللاغربي، وهذا يمنحها خاصية إضافية تميزها عن بريطانيا التي عاشت تجربة مسالمة ولم تحتج لثورة دموية وعنيفة تهز عرشها، وأيضاً عن أمريكا التي قامت بثورة ناجحة ولم تنته نهاية دموية مماثلة لتجربة الثورة الفرنسية.
الفروقات والتمايزات التي تتقصاها الكاتبة بين مدارس التنوير الغربي المذكورة، في غياب كامل وغير مفهوم للتنوير الألماني، تغني فكرة الحداثة وتؤكد على مصداقيتها وتجذُّرها لا في الفكر الغربي وحده بل في الفكر الإنساني عامة رغم الكثير من المراجعات والانتقادات التي بدأت تبرز إلى السطح في الدراسات الغربية منذ عقود قليلة والتي تمثل الكاتبة أحد اتجاهاتها المحافظة. "العقل" الذي اختص به الإنسان دوناً عن بقية الكائنات الحية هو من أبرز نقاط التمايز والاختلاف التي قام عليها التنوير الفرنسي والذي وصل به الفلاسفة الفرنسيون وخاصة الموسوعيون إلى مكانة وقدرة تنافس مكانة وقدرة الله والدين على الأرض فالعقل بالنسبة للفلاسفة الفرنسيين أمثال فولتير وديدرو ودالمبير وغيرهم من الموسوعيين هو "كالنعمة بالنسبة للمسيحي"، وضع في حالة استنفار قصوى ضد الكنيسة وما تمثله على الأرض وفي السماء وضد النظام الملكي أيضاً، ولذلك عبرت عنه الكاتبة ب"إيديولوجية العقل".
ولنا أن نتخيل الزلزال الكبير الذي أحدثته الثورة الفرنسية وآثارها على أوربا والعالم. فالعقل كما أراده الفلاسفة الفرنسيون كان مصدر كل سلطة مشروعة وأداة طموحة وفعالة لتغيير حاسم لا يصالح ولا يهادن المؤسسات القائمة من دينية وغير دينية، إنه يسعى إلى بناء تاريخ أرضي تحتل فيه الإرادة البشرية بعموم أفراها والأفكار الإنسانية حول التسامح الديني والإصلاحات القانونية المكانة الأولى في سلم الوعد بالسعادة البشرية المأمولة وهو ما ترفضه الكاتبة ضمناً.
في بريطانيا الوضع مختلف إذ لم يكن هناك فلاسفة بالمعنى الذي حملته الكلمة في فرنسا بل كان هناك فلاسفة أخلاق نتيجة إيمانهم بوجود حاسة خلقية فطرية جبل عليها الإنسان تدفعه إلى التعاطف مع غيره والإحساس بآلام الآخرين ومساعدتهم والشفقة عليهم وهي أفكار تتماشى مع التصورات والأفكار الدينية المسيحية فلم يُقِم تنويريّو بريطانيا تعارضاً حاداً بين العقل والدين يفضي إلى عداوة مستحكمة لا تحل. فحتى نيوتن المادي أقام نظامه الكوني على يد الله الخالق الذي يعتني بالكون ويدبر شؤونه على النحو الأمثل. "إن الحاسة الخلقية أو العاطفة الأخلاقية أو الوجدانات الاجتماعية . . هي المصطلحات المحددة للفلسفة الأخلاقية التي كانت في صميم التنوير البريطاني وأعماقه. وهي القاسم المشترك بين الفلاسفة العلمانيين والمتحمسين الدينيين، وبين كنيسة أساقفة انجلترا والوعاظ والمبشرين الويلزيين وهذه الأخلاق هي التي وجدت تعبيراً عملياً في حركات الإصلاح والمشروعات الخيرية . . " ضمن هذا الاتفاق والتوافق بين تيارات ومؤسسات اجتماعية واقتصادية ودينية متعارضة كما يفترض، لا يعود من حاجة ماسة إلى ثورة دموية كالثورة الفرنسية ما دامت "الروح الإنسانية تسير إلى الأمام" بخطى واثقة وهو ما ميز التنوير البريطاني برأي الكاتبة.
إذا كان العقل يتصدر التنوير الفرنسيّ، والفضيلة تتصدّر التنوير البريطانيّ، فإنّ الحرّية هي التي تتصدر التنوير الأمريكي والحرية المقصودة هي "الحرية السياسية والمبادئ والمؤسسات الملائمة للجمهورية الجديدة . .
باسم الحرية – السياسية – أعلنوا فيما بعد استقلالهم عن بريطانيا". الحرية السياسية عنوان التنوير الأمريكي لم تتعارض مع الدين ولم تعادِه وهو، أي الدين، لا يحضر في وثيقة الاستقلال إلا على نحو طفيف وعام جداً من خلال عبارات مثل "قوانين الطبيعة وقوانين الله" أو "العناية الإلهية" ولم يمنحه الدستور جانباً إيجابياً. ولكن الدين، وهنا المفارقة الأميركية بامتياز، يحضر في المجتمع وتقاليده بقوة ورسوخ لافت يوازي قوة ورسوخ مكانة الحرية السياسية في الدستور، فالحكومة لم تفرضه فرضاً ووجد فرص وجوده جنباً إلى جنب مع التقاليد الديمقراطية الحديثة وصارت الحرية والدين يعيشان معاً في كنف الدولة والمجتمع بتناغم لم تعشه ولم تقبله فرنسا الثورية مطلقاً. ولخّص أحد الكتاب الأميركيين الخصوصية الأمريكية بقوله: "إن دستورنا لم يوضع إلا من أجل شعب أخلاقي ومتدين. إنه لا يلائم تماماً حكومة أي دستور آخر". هذه الخلطة الأميركية توافقت أيضاً مع الاقتصاد فإطلاق الحرية الاقتصادية تحت مظلة السياسة ومباركة الدين شكل دعامة جديدة لتنوير أمريكي خاص جداً ولا ينطبق حقاً سوى على أمريكاً. واقع الحال أن الخلطة الأمريكية على صعيد المجتمع والدين لم تكن وردية تماماً مع وجود السكان الأصليين والرق، وهي مشكلة تكفلت بحلها بالنسبة للحالة الأولى البندقية التي شهدت تطوراً تقنياً لافتاً، والحالة الثانية حلت قانونياً بحظر الرق مع بقاء آثاره وممارساته العنصرية الكريهة في المجتمع حتى الآن.
لم تتساءل الكاتبة، انطلاقاً من موقعها المحافظ عن العلاقة بين الغرب والاستعمار، ولم تتطرق إلا لماماً إلى التداعيات الاستعمارية للغرب واحتلاله في فترة تاريخية معينة بقاع واسعة من العالم. فبريطانيا وفرنسا لهما تاريخ استعماري وامبريالي طويل وعريق ارتكز في بعض أسسه على ادعاء نشر قيم التنوير والحرية والعقل. وورثت أمريكا ذلك وتحولت إلى آخر معاقل الاستعمار الحديث بنسخة تتعدى همجيتها وخطورتها أسلافها من البريطانيين والفرنسيين.
رغم الاختلاف الكبير بين التجارب المذكورة إلا أن الطرق إلى الحداثة والتنوير تقاطعت وأثمرت وانصهرت فيها تجارب مجتمعية متميزة شكلت ووسمت الغرب بميسمها وجعلت منه تجربة خاصة ومغايرة لكل التجارب الإنسانية في بقية المجتمعات البشرية. وصارت المقابلة بين الغرب والعالم مشروعة وحقيقيّة وليس فيها من المجاز شيء.




