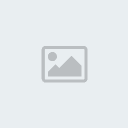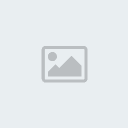
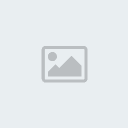
المدرسة العمومية في أزمة، هذه حقيقة لا سبيل إلى نفيها، وهي أزمة ليست مخصوصة ببلد دون غيره، بل هي عالمية، وتلحق حتى بأكثر المجتمعات تقدما، ففي فرنسا مثلا، الدولة التي قعّدت للمدرسة بعد الثورة، واعتبرتها العروة الوثقى الحافظة للعقد الجمهوري، تجمع كل الدراسات و البحوث على وجود أزمة عميقة للمدرسة، و هي أزمة تبرز في مظاهر عدة، أهمها تراجع المستوى بشكل مهول، فأكثر من 26 في المائة من التلاميذ المرشحين للباكالوريا عاجزون عن الكتابة بلغة فرنسية سليمة، والنسبة أعلى في مواد أخرى كالرياضيات، و نسبة العنف المدرسي تجاه الأساتذة ارتفعت بشكل كبير، وهو أمر جعل وزارة التعليم تستنفر جهودها في محاولة لإيجاد حلول، بل إن البرلمان نفسه "دخل على الخط"، إذ اقترح بعض نواب اليمين حلا "أمنيا" جذريا، يقضي بتفتيش التلاميذ في أبواب المدارس، و وضع كاميرات مراقبة في الممرات.
و إذا كانت الأزمة قد صارت مسلمة في الخطاب الرسمي لدولة راهنت "وجوديا" على المدرسة العمومية منذ قرنين، فإن الأزمة في بلدان أخرى تستلهم نموذجها، من مثل المغرب و الجزائر و تونس و مصر، هي أعمق و أخطر، و المظاهر أوضح من أن تعرض.
ما العلة في هذا التراجع؟ و ما أسبابه؟ و متى حصل؟ وكيف؟
من منظور التحاليل التبسيطية التي تسعى إلى "شخصنة" الأمور و البحث عن "كبش فداء" تلبسه التهمة و ترتاح من عناء التفكير، السبب هو إما التلميذ، الذي أصبح "دون المستوى" المعرفي أو الأخلاقي لتلميذ "الأمس الغابر"؛ وإما المدرس، الذي صار مجرد كائن "كسول" مادي يتعيّش على المجتمع. تفسيرات مثل هذه فارغة من الدلالة، لأنها لا "تفسر" شيئا، بل هي نفسها محتاجة لتفسير. فاتهام التلاميذ و الأجيال الصاعدة بضعف المستوى الأخلاقي و المعرفي هي تقنية قديمة جدا، تستعملها الأجيال السابقة دائما لحماية مكتسباتها الرمزية و الاعتبارية من قيم الأجيال الصاعدة، وهذا أمر نجده حتى عند هزيود راوية الأساطير اليوناني القديم (القرن الثامن قبل الميلاد) الذي اشتكى من "ضعف" وسوء طبائع الجيل الصاعد في أيامه. و إلباس التهمة للمدرس هو أيضا أمر لا معنى له، لأن المدرّس ليس بالقوة التي نتصور حتى يستطيع أن يكون هو وحده العلة في تراجع نظام بكامله، بل هو مجرد عنصر و حلقة في آلة ضخمة، هذا إضافة إلى أن المدرس، حتى إن وافقنا جدل على مسؤوليته، لم ينزل من السماء، بل هو تلميذ سابق ومنتوج لمجتمع، وقيمُه من قيمِ مجتمعه.
العلة في نظري ليست شخصية و لا سيكولوجية، بل هي أعمق بكثير، و تمس معنى المدرسة ودورها و قيمتها في العالم المعاصر، أمام التحولات الرهيبة التي لحقت بالزمن والإنسان و المادة و الوجود. العلة عميقة و لهذا فإن الأزمة لحقت بالجميع، بالدول المتخلفة ، كما بالدول القوية الغنية و الراسخة.
في محاولة أولى لتفسير الأمر أعتقد أنه ينبغي استحضار العناصر التالية :
مبدئيا المدرسة مؤسسة عمومية، وهي جزء من نظام الدولة، بل هي قلب الدولة في العالم الحديث ومن هذا المنظور، فتراجعها هو جزء من تراجع الدولة في العقود الأخيرة، ومن الجزر العام والخسوف الذي عرفته المؤسسات أمام المد الاقتصادي الليبرالي و ثقافة المقاولة الحرة الكاسحة. فلا يمكن أن تتراجع سلطة السياسة أمام الاقتصاد، و سلطة الدولة أمام الشركات الخاصة، دون أن تتراجع المدرسة، بما أنها جزء من النظام العمومي.
لكن هناك أسباب مخصوصة بالمدرسة و متعلقة بديناميتها الداخلية هي الأهم. أولها، سبب يمس الغاية ، فالغاية من وجود المدرسة هي "نقل" وترسيخ قيم ومعارف و خبرات الأجيال السابقة للاحقة، فالمجتمعات حتى تستمر محتاجة لتوريث قيمها وخبراتها التي راكمت عبر قرون إلى أبنائها، والمدرسة هي من يضطلع بذلك، ومن هنا فسلطة المدرس و وضعه الامتيازي آتيين من كونه "الوحيد" الذي يضطلع بهذه المهمة. ففضاء المدرسة هو فضاء التبليغ، و من هنا استعارات النبوة و"الرسالة" التي ظلت لصيقة بالمعلم و التعليم. ثاني هذه الأسباب متعلق بالوسائل؛ فإلى عهد قريب الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق هذا التبليغ المذكور هي اللغة، إضافة إلى ما يمكن أن تستعين به هذه اللغة من عناصر، مثل السبورة و الدفتر والكتاب. ثالث هذه الأسباب يمس العلاقة مع الزمن، فزمن المدرسة بطيء، لأنه زمن تبليغ و ترسيخ و تربية، وهذا زمن بطيء بطبيعته، بل و ممل. رابع الأسباب متعلق بالقيم، فالقيم التي يوكل لهذه المدرسة نقلها و تلقينها ،هي قيم "أخلاقية" و فكرية في جوهرها، فمجال المدرسة هو مجال "أخلاقي" أساسا، والفكر و الأخلاق هما دائما مجاهدة و معاندة ضد الجسم و الأهواء والغرائز، فالمدرسة هي مؤسسة لترويض الغرائز، إذ هي من يضطلع بتحويل المادة الخام التي هي 'الطفل"، إلى "مواطن" مسؤول قادر على التحكم في غرائزه الطبيعية، ومؤهل للانخراط الفاعل في المجتمع.
المدرسة إذن في المنطلق هي مؤسسة أنتجت بغايات محددة هي التبليغ؛ تبليغ القيم والمعارف، و بوسيلة مركزية هي اللغة، لغاية تأهيل الطفل غير البالغ ليصير مواطنا.
هذه هي المدرسة بشكل عام وهذه مبررات وجودها.
ما ينبغي الانتباه إليه، في نظري، هو أن أزمة المدرسة آتية من كون هذه الغاية و هذه الماهية و هذا المبرر، هي عناصر وغايات صارت اليوم مشكوكا فيها، لأن مؤسسات أخرى، و قوى أخرى صارت تضطلع بهذه الأمور، بل و تبزّ المدرسة فيها بزّا، و أهم مؤسسة تحقق هذا الأمر هي الإعلام، الإعلام بمعناه الأوسع و الأشمل.
من التبليغ إلى الاتصال:
عرف العالم في القرن العشرين ثلاث ثورات كبرى على الأقل (التكنولوجية و الإلكترونية و الرقمية). و الحق أن هذه الثورات قد أحدثت تحولات هائلة في الوعي و السلوك الإنساني، تحولات في الوسائل و الإمكانيات، نتجت عنها تحولات في القيم والتصورات. فمن حيث الوسائل، وفرت الثورات المذكورة إمكانيات في التواصل و تبادل المعلومات والأخبار و التفاعل غيرت جذريا من مفهوم المسافة و الزمان و المادة والتاريخ، بل ومن طبيعة العلاقات الاجتماعية و القيم التي تؤسس لهذه العلاقات. فالثورة الرقمية مثلا أتاحت ما نراه اليوم من انتشار للواقط الهوائية و لشبكات التواصل و المعلوميات والشاشات و الهواتف و حوامل البث وغيرها من الكائنات العجيبة الفاتنة التي لا تنقطع عن مفاجئتنا في كل يوم. هذه الثورات المستجدة، خلقت تغييرات في مفهوم العالم والمجتمع والفرد و الزمن من جهة، وفي المعاني والأخلاق والعلاقات الاجتماعية من جهة ثانية. تغييرات لا أعتقد أننا استوعبنا حجمها وعمقها وجذريتها بشكل كاف.
ما علاقة كل هذا بالمدرسة؟
علاقة وثيقة و مباشرة، لأن المدرسة عمليا، أمام هذه التحولات، صارت، و على الأقل في صورتها وصيغتها الحالية، متجاوزة. أغلب أبناء الأجيال الصاعدة ينتمون إلى ما يسميه دوبري بعالم "الفيديو سفير" vidéosphére الذي عماده الصورة والرؤية و المباشَرة، والمدرسة تنتمي إلى عالم "الغرافوسفير" graphosphère الذي عماده اللغة والحرف والكلمة؛ مرجعية الأجيال الصاعدة هي الشاشة و مفاتيح الحاسوب، في حين أن مرجعية المدرسة هي السبورة والكتاب؛ مرجعية التلميذ هي الصورة و الإشهار والحوامل المتعددة، ومرجعية المدرسة هي الوزرة و الكلمة و الطباشير.
من حيث القيم - وهي الأهم - قيم التلميذ هي قيم السرعة والضوء و الرغبة في الوصول السريع السهل، هي قيم الإعلام والإشهار و"تلفزة الواقع" والمال و الفيديو كليب، في حين أن قيم المدرسة هي قيم "نكران الذات" و خدمة المجتمع وأدبيات التواضع و "وصايا لقمان"؛ قيم التلميذ "فردانية" تؤمن بالفرد المعزول أمام شاشته الذي لا يتواصل مع الآخرين إلا افتراضيا ويبحث عن الخلاص الذاتي، تماما كما يشاهد في "تلفزة الواقع" ومنافسات "ستار أكاديمي و"لوف ستوري"، حيث الجميع ضد الجميع من أجل "الربح" و الشهرة، في حين أن قيم المدرسة هي سعي لشدّ وتوطيد ولحم الفرد بالجماعة، وتربيته على "المواطنة"؛ دينامية عالم التلميذ هي دينامية الرغبة و اللذة، و دينامية المدرسة هي دينامية الواجب والنظام، ولا إمكان للغة الواجب أن تنتصر على لغة اللذة مهما فعلت، لأن الأولى تخاطب العقل، والثانية تخاطب الغريزة، والعقل لا يصمد أمام الغريزة عند كائنات في تلك السن.
الأمر ليس إذن تغيرا في الحوامل و الوسائل فقط، بل هو تغير في القيم و الوظائف، و هذا هو أصل الداء المدرسي، فقيم المجتمع تغيرت، في حين أن المدرسة ظلت تدافع عن نفس القيم، وهذه هي محنتها.
يمكن أن نلمس هذه المسألة في التصورات الدونية والساخرة التي يقدمها الإعلام عن المدرسة، فالمدرس كائن متجاوز و لا يساير العصر، لهذا فهو موضوع تفكّه، هو كائن تقليدي لا يفهم لغة العالم المعاصر، و لهذا فهو عند الصغار موضوع للطرائف و عند الكبار موضوع اتهام. المجتمع تغير في قيمه جذريا، تحول من مجتمع يؤمن بالتبليغ transmission الذي هو فعل يحصل بين لحظات في الزمان (الماضي- الحاضر- المستقبل)، وبإيقاع بطيء، وبوساطة سلطة الأجيال السابقة و الآباء - كما يذكر ريجيس دوبريه دائما- إلى مجتمع يحيى على الاتصال communication ، الذي هو فعل يمتد بين نقاط في المكان، وبإيقاع آني بعيدا عن أي وساطة أو رقابة. المجتمع إذن يطلب من المدرسة أن يضطلع بمهمة هو نفسه نبذها و تجاوزها عمليا، وهذا محال.
التحول عميق إذن، لهذا فإن الحلول التي تحاول أن تسلكها بعض الجهات لرأب الصدع، من مثل مساعي "تحديث" المدرسة و تطويرها باستحداث وسائل جديدة لن تغير شيئا، فتغيير الوسائل لن يجدي في أزمة تمس الدلالة و المعنى و القيمة، فالمسألة ليست تدبيرية أو "حكومية"؛ ليست متأتية من "رغبة شريرة" عند جماعة من المسؤولين "الأشرار" الذين يدفعون بها في الخفاء، بل هي تغيرات هيكلية تمس النظام، ولا علاقة لها بالأشخاص، فحتى المسؤولون اليوم هم عاجزون عن إيجاد أجوبة للمسألة، ويقفون حيارى، لأن الوضع يتجاوز النيات والإرادات الذاتية.
هل يمكن للمدرسة إذن أن تتجاوز في زمن الإعلام و الاتصال ؟
ممكن جدا، لأن المدرسة منتوج تاريخي، تجري عليه قوى التاريخ و تحولاته، إنها مؤسسة، والمؤسسات كما تولد تموت، بل نحن نجد بوادر مثل هذا الأمر في بعض المواقف، وفي انتشار وتكاثر المؤسسات الموازية والخاصة التي تدعو إلى تكوين حرفي "عملي" ومباشر. لكنّ نهاية المدرسة، والمدرسة العمومية تحديدا، نهاية هذه المؤسسة التي كانت إلى اليوم مكلفة بتبليغ وتوريث الخبرات والقيم المؤسسة للمجتمع، معناه نهاية هذا المجتمع نفسه، لأن انفراط الأسباب والعرى الحافظة، يؤدي طردا لانحلال ما يبنى عليها، وحينها نكون أمام خيارين : إما إيجاد بدائل قادرة على تعويض المدرسة ودورها المصيري - وهو بديل لا يمكن أن يأتي أبدا من الإعلام لأنّ رهان الإعلام ومهمته، ليست التبليغ بل تحقيق الاتصال فقط، وإمّا العودة إلى حالة المشاعة البدائية، حيث كل فرد يقاتل من أجل ذاته، وحيث الطبيعة تقاتل الجميع.