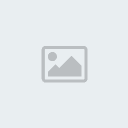
كان التفكير ولا يزال العامل الأساسي والأهم في الفهم والإدراك، ولكن لماذا نرغب بالفهم؟ نرغب به لأنه يجلب لنا الاطمئنان والشعور بالتفوق، هذا الشعور نفسه، مصدر المتعة الكبرى التي نصف بها لذة المعرفة، أو لذة إدعاء الفهم، فلذة الفهم تجنبنا ألم القلق و الخوف من المجهول، و نحن نخاف ما نجهله، لذلك يمكننا أن نتفق بداية على أن التفكير هو آلية معاوضة نفسية ناتجة عن القلق و الدهشة التي تصيب الإنسان أمام عالم خارجي مليء بالتحديات و آخر داخلي غريزي مليء بالرغبات. و كما تكره الطبيعة الخواء، كذلك يكره العقل العشوائية ، فنحن نرى، بصورة آلية، النظام في كل شيء، نرى صوراً في النجوم فوقنا، و نسمع أصواتاً في ضجيج هائل للنهر، وموسيقى في جو عاصف، و كما تقوم القنادس بصورة طبيعية ببناء السدود و العناكب بنسج البيوت، فإن الناس يرسمون الخرائط في السماء و على الرمل.
و ما نملكه من أفكار يشعرنا غالباً بالأمن و الأمان، لذلك نخاف المجهول، بل نخاف ما لسنا متأكدين منه تماماً، و من ثم نحجم عن أن نخطو أي خطوة في اتجاهه، صحيح أن مثل هذه الخطوة إذا قُدر لنا أن نخطوها، تبدو غير خطيرة بعد حدوثها، و لكنها تبدو خطيرة جداً قبل الإقدام عليها، و من هنا كان الخوف منها، فلا أمن و لا أمان إلا في الأشياء القديمة المجربة(1) .
فالتفكير و فق هذا المعيار، ليس عملية بيولوجية فقط، بقدر ما هو عملية سيكولوجية ديناميكية، و دلالة التحليل النفسي ليست في إرجاع النفسي إلى البيولوجي، بل في الكشف عن الجانب النفسي في الوظائف التي يُعتقد غالباً أنها بيولوجية و جسدية على نحو كلي(2) ، و الغاية الرئيسية لكل تفكير أو فكر هي التواصل مع عالم أو فكرة أو شخص ما، و قد يكون التواصل مع العالم سامياً أو وضيعاً، و لكن التواصل حتى مع أحط أنواع النماذج مُفضّل عن الانعزال لأبعد الحدود، فأي عادة أو اعتقاد أو تأمل أو تصعيد، مهما كان منافياً للعقل و منحطاً، لهم مهمة أن يربطوا الفرد بالآخرين، فهي ملاذات تحمي الإنسان من أشد ما يرهبه، العزلة و قلقها، فليس الفكر بحاجة فقط لإشباع منظم مرتّد إلى ما يديم أو يقيم الاستقراء المادي، بل أيضاً لإشباع ما يرتّد إلى حاجة البشري للأمن و الحب و الاطمئنان و الرضا الإيجابي عن الذات، و الشعور بالتقدير الذي يمنحنا إياه الآخر أو يُقَر لنا به في العالم (3). و بالتالي فإن التفكير يعني إرادة التعبير و إدراك للآخر كموضوعي ( طبيعي أو اجتماعي أو إنساني )، و نحن نلاحظ أن الآخرون ليسوا مشكلة بالنسبة إلى الطفل و لا للوعي الراكد، فالمشكلة تكون عند إرادة التغيير التي تستلزم الفهم، أو أن إرادة التغيير تستلزم الوعي بالغير(4) .
و هذا ما نتلمسه من خلال علاقة اللغة و اللاشعور، فمن المحتمل أن تكون التوترات و الصراعات التي تدور داخل النفس قد استطاعت أن تلعب بالبداية، دوراً لا غنى عنه في تحديد لغة الإنسان، و اللغة هي أداة الفكر الوحيدة للتحليل النفسي، و بالمقابل فإن الإنسان نفسه ينغرس و هو يكتسب اللغة، في نظام رمزي سابق الوجود، و من ثم تخضع رغبته للضغوط النسقية لذلك النظام، فلإنسان يتيح للغة و هو يتبناها أن تؤثر على طاقاته الغريزية الحرة، و أن تنظمها (5). و ربط الوجدانات و العمليات الغريزية بأفكار الكلمات، يعتبر من زاوية تحليلية نفسية أول خطوة يتحتم على الفرد أن يخطوها في نموه، فمن هذه الزاوية يعتبر التفكير عملية تجريبية يستخدم فيها أقل ما يمكن من كميات الغريزة، و هذه المحاولة في كبح العمليات الغريزية، بربطها بأفكار يمكن معالجتها شعورياً، هي واحدة من أعظم اكتسابات الأنا البشرية عمومية و ضرورة، و من ثم فنحن لا نعتبرها نشاطاً للأنا، بل واحداً من عناصرها المكونة التي لا غنى عنها، و زيادة شدة العقلانية أثناء المراهقة، بل و ربما ذلك التقدم البارز في الفهم العقلي للعمليات النفسية، ليس ببساطة إلا جزءاً من المحاولات العادية للأنا المستقل للسيطرة على الغرائز عن طريق التفكير، فالخطر الغريزي مع قلق الأنا نحو عالم مجهول هو الذي يجعل الكائنات البشرية ذكية، و في فترات الهدوء في الحياة الغريزية عندما لا يكون هناك خطر، أو لا يكون هناك تصور حقيقي للخطر على الأقل، يكون بوسع الفرد أن يسمح لنفسه بدرجة معينة من الغباء، و يكون للقلق الغريزي ذلك الأثر المألوف للقلق الموضوعي، فالخطر الموضوعي و الحرمانات الواقعية، تدفع بالناس إلى أعمال عقلية فذة و محاولات عبقرية لحل مشاكلهم .(6)
إن وضع المأزق، أو المشاعر الصادمة و التجارب المريرة، أمام الوعي، ثم تحت مناهج الدراسة الموضوعية، مع التوق للشفاء و الانعتاق، عمليات معرفية و منهجية تعطينا القدرة على التغيير، فنغدو عارفين بالواقع، و على وعي بضرورة الخلاص و التحرر، فنبحث عن تحقيق الرغبة بالحل و إعادة الاستقرار للوعي المأزوم(7)، و نحن نعرف أن المرء يبلغ عاطفة من الانفراج و تفريغ الشحنة، بفعل حل مسألة من المسائل، عندما يفلح جزء من التفكير تحت الشعوري من الوصول إلى نتيجة شعورية مُرضية، و الارتياح المؤكد الذي يرافق عادة حل مسألة من المسائل يوصف على وجه العموم بأنه عاطفة ممتعة من السيادة على الذات، و الانتصار الناجم عن انجازات ترتبط بمصالح الأنا، و عواطف حب الذات التي تقلص التوتر بين جوانب النفس، بين الأنا و الأنا الأعلى على سبيل المثال، و سيكون من المفيد أيضاً أن نعتبر أن حل المسائل في كل الميادين الإبداعية، يمكنه أن يُفضي إلى اللذة بفعل تفريغ الشحنة.(8)
فرغبة المعرفة تتمثل - وفق هذا الاعتبار - في طرد الخوف و العودة للطمأنينة، و الشيء الباعث على الخوف و هو موضوع الحصر و القلق، هو على الدوام ظهور عامل رضّي مقلق يتعذر تفاديه وفقاً لمعيار مبدأ اللذة، و إننا لندرك للحال بأن هذا المبدأ لا يكفي ليدرأ عنا خطراً خارجياً، بل كل شأنه أن يدرأ عنا أذىً معيناً قد يتعرض له تنظيمنا النفسي(9) .
و إذا بحثنا في أصل التفكير و الرغبة في المعرفة، وجدنا لذلك أصل عميق في الطبيعة الغريزية الإنسانية ذاتها التي تسقط أو تصعّد مفاهيمها على الواقع الموضوعي، تحت ضغط خطر خارجي مصدره قوة الطبيعة، و آخر داخلي أنشأه التطور الاجتماعي بتأثير القوانين الأخلاقية، و ما لا ينبغي أن يغيب عن بالنا، هو أن نصف حياتنا، أو نحو ذلك، تجري في حالة من اللاوعي، ففي منطقة الهو، و هي التي تمثل الجانب الغريزي من النفس البشرية، تهيمن العملية المسماة بالعملية الأولية، فليس هنالك ائتلاف بين الأفكار، و الوجدانات متاحة للنقل، و المتناقضات لا يستبعد بعضها بعضاً، بل يمكن حتى أن تتحد و يحدث التكثيف بطبيعة الحال، و المبدأ المهيمن الذي يحكم العمليات النفسية هنا هو مبدأ اللذة، أما في الأنا و هو الجانب الواقعي من النفس البشرية فنجد العكس، حيث ترابط الأفكار يخضع لشروط صارمة نطلق عليها ذلك المصطلح الشامل – العملية الثانوية – حيث الحفزات الغريزية لم يعد بوسعها أن تسعى إلى الإشباع بغير ضجيج، فهي مطالبة بأن تحترم مطالب الواقع و قوانينه، لذلك يمكن القول أن الفكر و نقيضه يتواجدان معاً في البنية النفسية للإنسان، و المقصود هنا الفكر المنطقي الذي يمتلكه الأنا الواقعي و الملتزم بالسائد، و الأخر الثوري الخارج عن الحدود الذي يمثله الجانب الغريزي الحر و الثائر، و لعل الثورات الفكرية الكبرى، تتشابه مع اندفاعات الهو اللاعقلانية، حيث لا يتقبل الفكر السائد مباشرة تلك التغيرات الكبرى، إلا بعد تشذيبها من المنظور الأكاديمي الاجتماعي، و بعد أن يضطر إلى تبنيها لتدخل ضمن كيان الأنا الواقعي العاقل و المنطقي، تلك الثورات لا تعترف بقوانين مطلقة تُفرض عليها من واقع معين، إنها ثورات فكرية تعبر عن رغبة الجانب العميق من النفس في تجاوز مفاهيم الواقع و مسلماته المطلقة، لهذا لا يوجد عبث عندما نشبه العبقري بالمجنون، فكليهما يتجاوزان الفهم الذي تتوقعه الأنا الاجتماعي و يكسران قيود الفكر المألوف، و ما تقابل المصطلحين في الوعي الاجتماعي، إلا تعبير إسقاطي يريح الأنا الاجتماعي من قلق الجديد، بتهمة الشذوذ، على كل من يكسر قيود الطمأنينة التي صنعته لنفسها.
من هنا يبدو لنا أن للتفكير و اليقين بالمعرفة الشاملة معنيين مختلفين تماماً، و هما معنيان متناقضان و متماهيان معاً، فقد يكون للفكر جوانب التواصل الداخلي مع البشر و العالم و تأكيد للحياة، و من جهة أخرى، قد يكون تشكلاً ارتدادياً ضد شعور جوهري بالشك، له جذوره الراسخة في عزلة الفرد و شعوره التاريخي بالقلق، و التفكير غالباً ما يُظهر الطمأنينة من خلال اندماجه مع حكم سلطة عامة أو رأي عام، فالشخص العادي الذي يذهب إلى متحف و ينظر إلى لوحة رسام شهير أو يستمع لمقطوعة موسيقية لعازف مشهور، أو يستمع محاضرة لعالم معروف و ذو ثقة جمعية، فإنه ينظر إلى تلك اللوحة، أو المقطوعة، أو المحاضرة، على أنها شيء جميل و مؤثر، و إذا حللنا حكمه وجدنا أنه ليست لديه أية استجابة داخلية خاصة للوحة مثلاً، لكنه يعتقد بأنها جميلة لأنه يعلم أنه من المفترض أن يعتقد أنها كذلك (10). فكل إنسان يجبر على الحياة باستمرار داخل نطاق المفاهيم الاجتماعية، وطبقاً لمعايير المجتمع التي لا تعبّر عن ميوله الغريزية، و بذلك يحيا بالمعنى السيكولوجي فوق مستوى إمكانياته حتى ليمكن وصفه موضوعياً، بأنه منافق، سواءً أكان يعلم أو لا يعلم أن حياته الظاهرة خلاف حقيقته الباطنة.
و قد يكون الادعاء المتعجرف على سبيل المثال هو في العادة ارتكاس تعويضي لعاطفة الدونية العميقة، و لكن التحليل يبين أن ذلك يرتكز بدوره على نرجسية مكبوتة. لذلك مضى فرويد أكثر من أي شخص قبله إلى توجيه الاهتمام إلى ملاحظة القوى اللاشعورية و غير العقلية و تحليلها، تلك القوى تحدد جوانب السلوك الإنساني، و لم يقتصر فرويد و أتباعه في علم النفس الحديث على كشف القطاع غير العقلي و اللاشعوري في الطبيعة البشرية، ذلك القطاع، الذي أهملت العقلانية وجوده، بل قد أظهر كذلك أن هذه الظواهر غير العقلية تتبع قوانين معينة، و من ثم يمكن أن تفهم فهماً عقلياً، و ذلك من خلال فهمنا للغة الأحلام و الأغراض الجسدية، بل و حتى الإلهامات الفكرية الكبرى، كذلك التصرفات غير العقلية في السلوك البشري، فاكتشف أن هذه التصرفات غير العقلية بالإضافة إلى بنية الطبع الكلية للفرد، هي ردود أفعال على التأثيرات التي يمارسها العالم الخارجي، لاسيما منها تلك التي تحدث في الطفولة المبكرة، لذلك فإننا نفهم الفرد عندما نراه في سياق الثقافة التي تصوغه (11). و الإنجاز الأساسي لفرويد، هو الكشف عن التعارض بين السلوك و الشخصية، بين القناع الذي ألبسه و الحقيقة المختفية وراءه، و من هنا يرى لاكان أن بصيرة فرويد الأساسية كانت في اكتشاف أن للاشعور بنية، و هذه البنية تؤثر بطرق لا حصر لها على أقوال البشر و أفعالهم، و تكشف عن نفسها بهذا التأثير و تصبح قابلة للتحليل، فاللاشعور يُلح علينا في صور لا تنتهي لنسمعه في أحلامنا، وفيما ننساه، و فيما نتذكره بصورة مشوشة، و في زلات القلم و اللسان، و النكات، و الرموز، و العادات، و نمط التفكير، إن الطاقة النفسية التي تسبب الكبت و تحافظ على استمراره، تواجهها و تتحداها طاقة أخرى تسعى بالخداع و الحلية عموماً إلى دفع محتويات اللاشعور المكبوتة إلى مجال ما قبل الشعوري – الشعوري، لذلك فقد يتكلم اللاشعوري رغم الكبت و الرقابة(12) . فللاشعوري له أسلوب خاص به، و ما يكشف عنه التحليل النفسي خلال ظاهرات التحويل أثناء علاج المصابين بالأمراض النفسية، يمكن أن يشاهد أيضاً في حياة غيرهم من الأسوياء، فهناك من الناس من يلوح أن في أعقابهم حظاً عاثراً، أو كان هناك قضاءً غاشماً يقف دون خطاهم، لكن التحليل النفسي قد اهتدى منذ عهد بعيد إلى أن القدر الذي يشكون منه، و مجرى حياة الواحد منهم في الجانب الأكبر منه، لم ترسمه الأحداث الخارجية بقدر ما رسموه هم لأنفسهم، إذ فرضته أهواء الطفولة المبكرة و مؤثراتها، و حتمته ظروف الماضي، لا الظروف التي يقابلهم بالحاضر(13) . فصراع الذات مع العالم، لا يتم فقط من خلال مواضيع خارجية من المحيط الاجتماعي، بل يتم أيضاً داخلياً مع التأثير المتمثل لهذا المحيط داخل الذات الإنسانية من خلال خبرات الطفولة المكبوتة، و جملة القيود الاجتماعية المتمثلة بالأنا العلى، و بهذا المعنى يربط فرويد الصراعات السيكولوجية، بالتطور العام للتاريخ الإنساني، فالغرائز لا سيما الجنسية، يمكن في ظل الضغط الاجتماعي أن تٌصعّد إلى أنشطة ثقافية و اجتماعية، و لكن هذه العملية تتم على حساب لذة الفرد و سعادته، ذلك لأن الجنس يضع الطبيعة البشرية بيولوجياً، و الثقافة الاجتماعية في وضع المواجهة(14)، لذلك فإن تطور المعارف و ارتقائها الحضاري لا يعني اختفاء طفولة العقل البشري، فالعقل البدائي عقل لا يفنى، بكل ما لهذا التعبير من معانٍ، و قد يظن عامة الناس أن ما نسميه أمراض عقلية، هو بالضرورة ما يصيب الحياة العقلية بالدمار، لكن الواقع هو أن الدمار لا يصيب إلا المراحل و الأطوار اللاحقة، و ربما كان جوهر المرض العقلي أنه عودة إلى طرقه الأولى في العمل مع ما يرافق ذلك من ظروف انفعالية(15) . و الفكرة المجنونة التي لا تعرف واقعاً، لا نفياً و لا شكاً، و لا درجة من التأكد، تبقى مع ذلك فكرة، و يبقى في جميع الأحوال، أن كل هذه التصورات التي لا تقبل التوفيق فيما بينها، ترجع إلى الذات نفسها مهما تكن هذه الذات مشوشة و مبهمة. و في بعض الأحيان نرى أن في تأمل ما يفكر به الإنسان عند قيامه بالفعل و نقيضه قد يقود للجنون، فالناس المفطورين على التسامح، و اللذين لا يستطيعون حتى معاقبة طفل شرير، يمكنهم و دون الشعور بالتناقض إطلاق الصواريخ، و الأكداس المكدسة من القنابل المدمرة على المدن و الناس و الأطفال، و كون الناس العاديين هم الذين يقومون بهذا الفعل، أو لا يستهجنونه على الأقل، فإن ذلك يحمل من الغرابة و الهول ما تحمله أية فظاعة شيطانية من فظاعات الحرب(16).
فالجماهير مثلها مثل الأفراد تحتفظ بانطباعات الماضي في شكل بقايا و آثار ذاكرية لاشعورية. و هناك إدعاء عام للحس المشترك، هو أن كل ما لدى الآخر هو كمثل ما لدينا، و على الرغم من أننا متفقون عموماً، على الإقرار بدون صعوبة بتمايز النفوس البشرية، إلا أننا ننسى دائماً في الممارسة بأن الآخر هو في الواقع، كائن آخر ’ يختلف عنا في مشاعره و أفكاره و إدراكه، و عندما أجزم ضمناً أن ما يروق لي، يناسب أيضاً غيري، فإن هذا الافتراض يشكل أثراً موروثاً من زمن كان فيه الوعي، في ليله البدئي، زمن لم يكن فيه أي اختلاف بين الأنا و الأنت، و كم نشعر بالإهانة، بل و الضعف أحياناً، و الخذلان عندما لا نجد من يشاركنا قناعاتنا(17).
و المعرفة البشرية تتكون أساساً من التكيف المتواصل لأنماط الأفكار البدئية التي أعطيت لنا، و هذه تحتاج إلى تعديلات معينة، لأنها و هي في صورتها الأصلية، تتناسب مع أسلوب قديم من الحياة، لا مع متطلبات بيئة متمايزة تخصيصاً، و إذا كان لا بد من المحافظة على دفق الدينامية الغريزية، مما هو ضرورة مطلقة لوجودنا، لا بد لنا عندئذ من أن نغير قولبة هذه الصور النموذجية – البدئية، في أفكار مكافئة لتحديد الحاضر الراهن، و يبدو أن حلم الإنسان الغريزي بإرادة القوة ما زال مستمراً، وسيبقى، و غرائزنا تظهر بأكثر أشكالها فجاجة كلما ساهمت التكنولوجيا في تفجير المكبوت و قهر الطبيعة، و لعل تلك الرغبات تقودنا لمزيد من المرارة أكثر من اللذة التي نبغيها، فنحن نلاحظ بوضوح تام أن طريقتنا في الجري وراء السعادة لا تؤمن لنا دائماً حياة طيبة، فنحن مجتمع من الناس التعساء نعاني من الوحدة و القلق، والاكتئاب، و الاتكالية، و النزوع التدميري، و أغلبية الناس أنصاف حالمين – أنصاف أيقاظ، إنهم على غير وعي بأن ما يرونه حقيقة كأمور واضحة لا تحتاج إلى إثبات، ليست إلا أوهاماً من صنع إيحاءات البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، و المعرفة تبدأ بتبديد الوهم و رؤية الحقيقة عارية(18). و انه لأمر واقع عند فرويد، أن الإشارات المدركة لحالة عاطفية ما، من طبيعة تثير آلياً العاطفة نفسها لدى الشخص المُدرك، و يزيد هذا الإجبار الآلي حدة كلما زاد عدد الأشخاص الذين نتبين لديهم العاطفة نفسها، فعند ذلك يسكن نقد الفرد، و يدع نفسه تنزلق إلى العاطفة نفسها، و لكنه يزيد بذلك، إثارة الآخرين الذين كانوا يؤثرون فيه، و هكذا تكبر الشحنة العاطفية للفرد بالسريان المتبادل، و الأمر يدور إذاً، دون ريب حول تأثير نوع من الإجبار على فعل ما يفعله الآخرون، و التفكير كما يفكرون، أي على التوحد مع العدد الكبير(19) . و قد أنتجت الثقافة المعاصرة نمطاً من العيش و المعرفة و التفكير، أو من السلوك و الوعي شديد القسوة على المواطن، حيث يعيش في توتر مستمر اقتصادي، و صراع و دومات و عزلة، حيث تتبادل الثقافة مع المجتمع تعزيز اللحاق بالاستهلاك و المال على حساب الفكر و التأمل، و هذا ما نراه قد أدى بفئة ليست بالقليلة إلى الهروب من التفكير و هموم المعيشة و اللجوء إلى المهدئات و الكحول و الإدمان و التطرف، و في قطاع ثقافتنا العربية مثلاً نجد الكثير من السلوكيات و المشاعر المتضاربة، من خلال الميل إلى الاستجداء حيث تظهر هنا عوارض خوف هاجع، و رغبات مقنّعة، خوف من الفقر، أو من الشعور بالفقر، رغبة باستدرار الاحتماء وراء نموذج فكري جاهز دون جرأة البحث النقدي، خوف من الاقتحام، صراع بين الرغبة بالتجديد و الرغبة بالسلامة، بين المازوخية و السادية(20) .
و قد تُصاب الثقافة المعتزة بنفسها بعارض عميق و غير مُعترف به، هو هاجس القانون التفسيري الوحيد و الواحد، و الجامع المانع، فهنا تتسلط فكرة ثابتة هُجاسية تتحكم باستحواذ و بشكل قسري، مفادها أنه يوجد حل أحادي كلي يحتكر الحقيقة و العلاج، كلي القدرة، و على ذلك يسعى الفكر المُصاب بتلك الوساوس إلى الحفر و التنقيب و التخيل و التوهم، بحثاً لا عن حقيقة ظاهرة، بل عن تلك الكلمة السحرية التي تقوم بدور ماء الحياة الشافي لكل جرح، و بذلك يغدو الفكر المتصلب سجين مقولات محددة و شعور وهمي بالأمان، تلك المقولات تتحكم به بقوة ووثوقية تقوده إلى أفكار مسبقة، جاهزة، متراصة، شديدة الضغط على عالمه الواعي و اللاواعي، على سلوكه و قيمه، السلوك هنا يصبح استعراضي، يود إظهار الأبهة، بإظهار أحكام كلية عامة متسرعة و غالباً مفتقدة للعمق، يتظاهر بالقوة و البذخ، إنه نرجسي محكوم بانشطار نفسي اجتماعي، فهو يرى الخير في جماعته، مُخلصاً متصلباً، و يُلقي المرذول على ما لا يوائم نمطه في الحياة و التفكير، متماهي مع الفكرة القائلة بأننا حيث نكون أصحاب الحق و أهل المعرفة و الأرفع، فإن غيرنا هم الأدنى(21) . و هنا يؤكد التحليل النفسي على أهمية وجود ديناميات معينة في شخصية الفرد تُمارس تأثيرها في تصرفاته المختلفة، حيث يبرز فرويد أهمية اللاشعور في فهم مختلف جوانب الشخصية، بما فيها التعصب الذي يمكن تفسير نموه و ارتقائه في ضوء بعض الميكانيزمات، كالإسقاط و الإزاحة و التبرير و غيرها، و يرى بان التعصب دالة على الميول البشرية للإسقاط، إسقاط التشابه على وجه التحديد، و يُقصد به الميل الموجود لدينا جميعاً إلى أن نُسقط اندفاعاتنا غير المرغوب فيها على الآخرين، و بوجه خاص الاندفاعات ذات الطابع الجنسي و العدواني، و يساعدنا ذلك على أن نرى الآخرين يفعلون الأشياء التي تخاف أن ننسبها لأنفسنا، هذا الميكانيزم يسمح للشخص أن يُقاتل و يفسق و يفعل أفعالاً شنيعة، لاعتقاده أن الأشخاص الآخرين هم الذين بدؤوا بذلك، على سبيل المثال، إذا استخدم رجل شرطة أبيض العنف بحرية ضد مواطنين سود، فإنه من المحتمل أن يعتقد أن عنفه كان مطلوباً لمواجهة عنف الأقلية السوداء، أكثر من اعتقاده أن ذلك يرجع بصورة صحيحة إلى ميوله الشخصية العدوانية. و في الكبت و الإسقاط تصبح العمليات الغريزية مستحيلة على الإدراك، ففي الكبت تُطرد الفكرة المُستهجنة عائدة إلى الهو الغريزي، بينما في الإسقاط تنتقل إلى العالم الخارجي، و المجتمع لا يكاد يترك فسحة من الوقت لأنا الطفل حتى تصبح على وعي برغباتها، أو حتى تتبين قوتها أو ضعفها بالقياس إلى غرائزها، فاتجاه الطفل من غرائزه، تمليه وعود الآخرين و تهديداتهم، أي يمليه أمل الطفل في الحب أو توقعه للعقوبة (22). و قد عرفنا أن حركات دافعية تُعاني مصير الكبت المرضي المنشأ عندما تتنازع مع التصورات الثقافية، أو الأخلاقية للفرد، و نحن لا نعني قط بهذا الشرط، أنه لدى الفرد معرفة عقلية بسيطة عن وجود هذه التصورات، بل نعني دائماً، أنه يعرفها بوصفها تُمارس سلطة عليه، و أنه يخضع للمقتضيات التي تنجم عنها، و ما حملنا على تشكيل مثل الأنا الأعلى، أو الحس الأخلاقي في النظر للواقع، كان على وجه الضبط، التأثير الناقد للأبوين، و قد انضم إليهما، في مجرى الأزمنة، المربون و المعلمون و الجمهرة التي لا تُحصى و لا تنتهي من كل أشخاص الوسط المحيط، كالآخرين و الرأي العام، و المنحى الثقافي المهيمن (23). حيث يصبح الأنا الأعلى بمثابة المثال، للأنا الفردي الذي ينزع إلى الاقتداء به، و مشابهته، و إذ يرنو الأنا بلا هوادة إلى الكمال، فإنما انصياعاًَ منه لمتطلبات الأنا الأعلى الذي يمثل جميع القيود الأخلاقية، لذلك لا يجوز بحال الإغضاء عن دور العوامل السيكولوجية، حين يتعلق الأمر برد فعل الكائنات البشرية الحية على العالم الخارجي و فهمه، فهذه العوامل لا تضطلع بدور في بناء الشروط الاقتصادية و الفكرية فحسب، بل تعيّن أيضاً جميع أفعال الناس، إذ أن هؤلاء الأخيرين لا يستجيبون لهذه الشروط إلا من خلال دوافعهم الغريزية البدئية، كغريزة البقاء، و العدوانية، و الظمأ للحب، و الحاجة للذة، و تجنب الألم(24) . و يؤكد فرويد بأن ظهور الثقافة ارتبط بعملية الانفصال عن الطبيعة، و الشخص الذي يقف وراء هذه العملية هو عموماً شخصية أخرى غير الأم، قد تكون الأب، أو العم، الذي يقوم بوظيفة المعرفة، فهو الشخص العارف الذي يدرك الحقيقة و يعلن حركة المستقبل(25).
إن أنا واحدة بعينها لا يمكن أن يكون تحت تصرفها إلا عدد محدود من وسائل الدفاع، ففي فترات بعينها من العمر، و تبعاً لما تكون عليه بنيتها النوعية، فإن أنا الفرد تنتقي حيناً وسيلة دفاعية، و حيناً وسيلة أخرى، و هذه الوسائل يكون بوسع الأنا أن تستخدمها على السواء في صراعها مع الغرائز، و في دفاعها ضد انطلاق الوجدان، و هي في كل صراعاتها تنعم بدرجة أو أخرى من ثبات الاتجاه في استخدامها كل وسيلة تجدها تحت تصرفها، فالأوضاع البدنية من قبيل التصلب، و الجمود، و الغرائب الشخصية، كالابتسامة الثابتة، و السلوك الازدرائي أو الساخر أو المتعجرف أو المتحجر، كل هذه مخلفات لعمليات دفاعية جد قوية في الماضي انسلخت عن مواقفها الأصلية، كصراع ضد الغرائز و الوجدانات، و تطورت إلى سمات ثابتة في الشخصية (26)، من هنا قد نفهم الموقف المتحجر الذي يقفه مفكري العصور الوسطى من الثورات الفكرية المتلاحقة، و الموقف المتحجر للفكر السائد ضد أي نظرية ثورية جديدة. فنحن نتصور المعرفة كامتلاك، فنرفض تعديلها أو خسرانها، فالخسارة تعني الهزيمة، متناسين أن المعرفة هي فهم، و ليست سلاح، و هذا ما يجعل عموم الناس يستاءون بطبيعتهم من الأفكار الجديدة التي تقلق طمأنينة ما يمتلكون من معارف، مع أن الفكر الحقيقي لا يُمتلك بقدر ما يُمارس، و رفضنا لفكر الآخر هو رفضنا لممارسة الفكر كنشاط معرفي يعبر عن تجاوز غرائز الإنسان الحيوانية.
و بتملك الإنسان للموضوع، فإنه يُعبّر رمزياً عن التماهي فيه، فقد كان البشر الأوائل يأكلون طوطمهم المقدس لتماهيهم السحري الرمزي فيه، و أنا حين أبتلع الموضوع رمزياً – نعرف القول السائد عن أني سآكل الكتب – فإني أؤمن بوجوده الرمزي داخل كياني، و على هذا النحو يُفسر فرويد الأنا الأعلى، بأنها اندماج بالمثل الأعلى الأبوي الاجتماعي، و بالطريقة ذاتها يتحقق الاندماج الداخلي لسلطة معينة أو فكرة، فأنا أمتلكها كما هي مُصانة في أحشائي إلى الأبد إن جاز التعبير(27).
بذلك يكون الإنسان هو ذلك التناقض الحي بين الطبيعة و المجتمع، أي بين الغرائز الفطرية و القوانين الاجتماعية، فطبيعة الإنسان البيولوجية ليست الطبيعة الإنسانية، إن الإنسان هو هذا التطور الذي فيه و به، بقوم الثقافي مقابل الطبيعي، فتكون الطبيعة الإنسانية بهذا المعنى، وسط جدلي للتناقض بين الطبيعة الغريزية، و الضغوط الاجتماعية التي بلغت مستويات مختلفة من التبطن، هذا بالإضافة إلى أن الطبيعة الإنسانية تتضمن أيضاً صراعات بيولوجية داخلية تنتج عن وجود فعالية غريزية أخرى بين غرائز الموت و الحياة(28). و يبدو أن الثقافة تعمل في خدمة غرائز الحياة، فهي تربط الأفراد بعضهم ببعض، و تصنع منهم الأسر و القبائل و الأجناس و الأمم، و توحد بينهم في وحدة كبرى هي الإنسانية، و تطور الحضارة ليس سوى صراع الجنس البشري من اجل البقاء و الاستمرار و الخلود. لذلك جاءت الحضارة كثمرة لاستنكار الإشباع الغريزي، و هي تنتزع من كل قادم جديد إليها هذا الاستنكار نفسه، و طوال حياة الفرد هناك استبدالاً مستمراً للقهر الخارجي بالقهر الداخلي، و تسبب تأثيرات الحضارة تحولاً متزايداً باطراد للاتجاهات الأنانية إلى اتجاهات اجتماعية، و هكذا يتم إخضاع الكائن البشري، ليس فقط لضغط بيئته المباشرة، و إنما أيضاً لتأثير التطور الثقافي الذي بلغه آباؤه الأوائل(29).
فالدافع الجنسي مثلاً يضع تحت تصرف العمل الثقافي كميات كبيرة إلى حد غريب من القوة، و ذلك من جراء الخاصية التي تكمن في قدرته على أن يزيح هدفه دون أن يفقد، و هذا هو الأهم، شيئاً من شدته، حيث يؤكد فرويد أن القوى المستخدمة للعمل الثقافي تنشأ على هذا النحو في جزء كبير منها، من قمع ما نسميه العناصر المنحرفة من الإثارة الجنسية، فانعدام الإشباع للدوافع الجنسية الذي تسببه الحضارة، جراء الكبت، هو العاقبة لبعض الخصائص التي جعلها الدافع الجنسي خصائصه تحت ضغط الحضارة، و لكن هذا العجز ذاته، عجز الدافع الجنسي عن تأمين الإشباع الكامل، منذ أن يخضع للمقتضيات الحضارية الأولى، يصبح مصدر الروائع الثقافية الأكثر عظمة التي أنجزت بفعل تصعيد لمكنوناته الدافعية، فالنزعات الجنسية و تأكيد الذات العدوانية التي تبدو في مجموعها، كمحركات للحضارة و الثقافة، تشكل في الوقت نفسه المخاطر الأساسية التي تهدد منجزات المجتمع الثقافية، حيث يتحدث فرويد عن التضاد بين الدافع الجنسي و الحضارة، و لكنه و في محصلة لاحقة، يعترف بأهمية الصراع بين الاندفاعات العدوانية و المجتمع في بناء الحضارة نفسها، فمفهوم ثنائية المشاعر، أي النزاع بين عاطفتين متعارضتين، من الحب و الكراهية، يمثل في رأي فرويد علامة على تقدم الحضارة، و يبدو على هذا النحو أن الفارق غير القابل للتقليص بين مقتضيات دافعين هما الدافع الجنسي و الأناني، هو الذي يجعل الناس قادرين على الإنجازات الأكثر رفعة على الدوام، و لعلنا نلاحظ أن كلاً من العمل الأدبي و النكتة، يتيحان لنا أن نستمتع باستيهاماتنا الجنسية و العدوانية، و رغباتنا الخاصة، بل والحميمية، دون وساوس و لا خجل(30) . و يدخل ضمن ذلك إيماننا بامتلاك بعض الحقائق الثابتة كتقمص لدور الأب العارف و القوي. و قد تعلمنا أن الذكاء هو القوة الأفعل، لكننا في الواقع نخطئ إن نحن نظرنا إليه كأداة مجردة بمعزل عن الحياة العاطفية و النفسية الفاعلة في آلياته، فالذكاء البشري يعمل بكفاءة عندما يكون بمنأى عن النوازع العاطفية القوية، و إلا فإنه يتصرف كأداة في خدمة الإرادة و الاعتقاد، يستخرج من البراهين و النتائج ما يكون في مصلحة الإرادة، و في الواقع فإن أذكى الناس يتخلون عن ذكائهم فجأة، و يتصرفون كالحمقى بمجرد أن يتواجد ذكاؤهم في مواجهة مع مقاومة عاطفية، أي يصطدموا برغبات مكبوتة، و بمجرد أن يتغلبوا على هذه المقاومة، فإنهم يستعيدون الحدة التي كانت لذكائهم(31) .
و يبدو – كما يرى فروم – أن للمجتمع وظيفة أخرى غير الوظيفة القامعة للميول العدوانية و الجنسية و الغريزية فقط، إن له وظيفة إبداعية، إن طبيعة الإنسان و عواطفه، و أحوال قلقه، هي نتاج ثقافي، و في حقيقة الأمر، فالإنسان ذاته هو أهم إبداع و إنجاز للمجهود البشري المتواصل، الذي ندعو تدوينه تاريخاً. رغم أن هذه الحفزة التصعيدية للمجتمع لم تكن دائماً إيجابية الطابع.
فهناك، على سبيل المثال، عادة يسير عليها نمط التفكير الاجتماعي، قائمة على تكريس المعلومات، و محاولة إلقائها بسرعة كسلاح يخفف عبء الشعور بالتوتر والضغط أمام المحاور، و بشكل عام نجد أن المؤلفات العربية لا سيما الجامعية هي كقارئها، قائمة على تكديس للأسماء و المراجع و الحواشي، وفي تلك الأكداس من المعلومات العشوائية، يخفي الكاتب عدم تمكنه، فهو كالمقيد نفسه بنفسه، يخاف الحرية و الجزم، فيلجا للآخرين كي يقرروا عنه، و يكتفي هو بجمع الشتات، و إدراج الملخصات بدل التأمل النقدي و الجدلي لهذه النصوص (32). و يحاول النظام التعليمي عموماً تدريب الناس على الحصول على المعارف و امتلاكها بشكل يتناسب قدر الإمكان مع ما يُنتظر أن يحصلوا عليه في حياتهم من مسؤوليات، و بعضهم يُعطى قدراً إضافياً من المعارف للترف الفكري الثقافي، ليزيد عنده الإحساس بقيمته، فيتحول التفكير من محور معرفة الذات إلى إثباتها التعسفي بإدعاء امتلاك المعارف لا تحليلها، متناسين أن القيمة الحقيقية لكل فكر هي ليس بما يملك، بل بما يُعطي، و لعل وعينا بالمعرفة، يوازي رغبتنا الكبرى بالتملك، بل و تدمير ما نريد معرفته، فنحن نفتخر بامتلاك معارف، فنقتل الحيوان و نشرحه لكي نعرف وظائف جسده، نقطف زهرة نتفحصها، دون أن نعرف أننا نقتلها، إننا نبحث عن الحقائق من خلال تمزيق أوصال الكائن الحي، ففي أسلوب التملك ينصت الطلاب مثلاً للمحاضرة، يسمعون الكلمات، يفهمون بناءها، لكي يحفظوا ما يكتبون و يجتازوا الامتحان، دون أن يصبح المحتوى الفكري للمعارف جزءاً لا يتجزأ من نظامهم الفكري الفردي، يغنيه و يوسع آفاقه، إنهم عوضاً عن ذلك، يحولون الكلمات إلى تجمعات فكرية، و نظريات ثابتة تُخَزن، حيث يظل الطلاب و محتوى المحاضرات غريباً كل منهما عن الآخر، فيصبح كل طالب مالكاً لمجموعة من العبارات الصيغ التي توصل إليها شخص آخر، فنجدهم يشعرون بنوع من الاضطراب تجاه أي أفكار و آراء جديدة تثار حول أي موضوع، لأن الجديد يثير التساؤلات حول الكم الثابت من المعلومات التي حصلوا عليها(33).
و عموماً يبدأ قمع الفكر النقدي باكراً، فقد يتبين لطفلة في الخامسة من عمرها مثلاً عدم صدق أمها، عندما تتحدث دوماً عن المحبة و المودة، و تكون بالفعل باردة و أنانية، حيث تشعر الطفلة بالتباين، و مع ذلك، و لاتكالها على الأم التي ليس من شأنها أن تسمح بأي نوع من النقد، لا سيما مع افتراض وجود أب ضعيف، فإنها تكون مكرهة على قمع بصيرتها النقدية، و بسرعة شديدة لن تلاحظ عدم صدق أمها، و سوف تفقد القدرة على التفكير نقدياً ما دام يبدو أنه من الميئوس منه و الخطير، أن تحافظ على هذه القدرة حية، و من جهة أخرى يستفز الطفلة المثال الذي يوجب أن تصدق أمها بأنها صادقة و محتشمة و حنونة، و أن زواج أبويها سعيد، و ستكون مستعدة أن تتقبل تلك الفكرة على أنها فكرتها(34).
و قد عرض باشلار تصور هام للتربية العلمية حيث يقول: " إن المبدأ الأول للتربية العلمية يبدو لي في الملكوت الفكري، إنه هذا الزهد الذي هو التفكير المجرد الذي وحده يستطيع أن يقودنا إلى سيادة المعرفة الاختبارية، لذلك لا بد من التأكيد على ضرورة إجراء تحليل نفساني للمعرفة الموضوعة على اعتبار أنه حتى في ملكوت العلوم الصحيحة لا سيما الفيزياء، يعتبر خيالنا إعلاءً و تسامياً و تصعيداً، و هذا الأمر مفيد، لكنه يمكن أن يخدع طالما أننا لا نعرف ما نمجد و كيف نمجده، و هذا لا يكون صالحاً إلا بقدر ما نحلل مبدأه نفسياً، و نفسياً لا توجد حقيقة بدون خطأ مصحح و إن سيكولوجيا الموقف الموضوعي هي تاريخ أخطائنا " (35) فكيف يمكن للمعلم أن يواجه تلاميذه و أن يقوم بعملية التعليم ؟ كيف يمكن مثلاً، لمعلم الكيمياء أن يعطيهم حقائق هذا العلم ؟ لكي يفعل ذلك، فإن عليه أن يقوم بعملية مزدوجة، جانب منها سلبي، هو هدم المعارف القديمة، و آخر إيجابي، هو بناء المعارف الجديدة، ذلك لأن التلاميذ لا يأتون إلى الفصل بأذهان خالية، و كأنها صفحة بيضاء يخط عليها المعلم كما يشاء، بل هي تأتي مُثقلة بتلك المعارف الخاطئة التي اكتسبها من الإدراك الحسي عن طريق الملاحظة و المشاهدة، و معنى ذلك أن العقل البشري، يأتي دائماً مثقلاً بمعارف و معلومات لا حصر لها، و أساتذة العلوم على سبيل المثال، يتصورون أن في استطاعتهم جعل التلاميذ يفهمون برهاناً أو نظرية علمية، بأن يكرروها مرة و مرة، و لكنهم يتجاهلون بذلك واقعة بالغة الأهمية، هي أن المراهق، بل و حتى أي متلقي، الذي وصل إلى الفصل و جلس يستمع إلى درس الفيزياء، إنما وصل إليه و هو مثقل بمعارف و تجارب سابقة، تؤثر فيه منذ تشكل أناه الواقعي، و من ثم، ليس من المطلوب في هذه الحالة تحصيل نتائج تجريبية، و إنما المطلوب تغيير ثقافة تجريبية، عن طريق تقويض العقبات التي كدستها الحياة اليومية التربوية و الاجتماعية و العائلية من قبل، فأي معرفة مهما كانت، هي بالضرورة معرفة ضد معرفة أخرى، و تغيير المعارف يعني أن يتبنى المرء معرفة ضد معرفته السابقة، فالمعرفة إنما تعني هدم معارف تكونت تكويناً خاطئاً، و معنى ذلك أن كل معرفة علمية أو ثقافة علمية – كما يقول باشلار – لا بد أن تبدأ أولاً بعملية تطهير عقلي، ثم تقوم بعد ذلك بالمهمة الأكثر صعوبة، و هي أن نجعل الثقافة العلمية في حركة مستمرة، و أن تستبدل بالثقافة المغلقة الساكنة، ثقافة مفتوحة متحركة، و أن تجعل جميع المتغيرات التجريبية جدلية، و أن تعطي للعقل أخيراً مبررات التطور و النمو و النماء.
- ما نستنتجه هنا هو أن الإنسان لغز بالنسبة لنفسه، و يتضح لنا الأمر إذا نحن أخذنا بالاعتبار افتقاره إلى وسيلة للمقارنة الضرورية لمعرفة نفسه، فهو يعرف أن يميز بين نفسه و غيره من الحيوانات، من جهة التشريح و الفيزيولوجيا، لكنه من حيث هو كائن واعٍ مفكر يتمتع بهبة الكلام، فإنه يفتقر إلى جميع العبارات اللازمة لتقدير نفسه، هو ظاهرة فريدة على هذا الكوكب، لا يستطيع أن يقارنها بأي شيء آخر، فإمكانية المقارنة لمعرفة نفسه، لا تنهض إذا استطاع إقامة علاقات مع ثدييات شبه بشرية تسكن كواكب أخرى.
و قد قال جوته " علينا أن نعتبر المفاجأة الناجمة عن صورة جديدة أو عن تركيب صورة جديدة، أهم عناصر تقدم العلوم الفيزيائية، لأن الدهشة هي التي تثير المنطق، و المنطق بارد إلى حد ما، فترغمه على إضافة اتساقات جديدة، لكن علينا أن نبحث عن سبب هذا التقدم ذاته، سبب المفاجأة ذاتها في قلب حقول القوى التي خلقها التخيل بارتباطات صور جديدة التي تمثل استطاعتها مقياس سعادة العالِم الذي عرف كيف يؤلفها "




