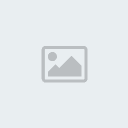
“الرب كالجبار يخرج. كرجل حروب ينهض غيرته”
إشعيا 42: 3
"أنا هو وليس إله معي… إذا سننتُ سيفي
البارق وأمسكتْ بالقضاء يدي، أُسكر سهامي
بدمٍ ويأكل سيفي لحماً من دماء القتلى والسبايا"
التثنية 32: 39-42
عندما بحثنا في الدراسة السابقة عن الأصل التاريخي للعبرانيين، ونسبناهم إلى جماعة من العابيرو قصدت مصر كيَدٍ عاملة مأجورة في مشاريع البناء التي كان يقوم بها الفرعون رمسيس الثاني في منطقة الدلتا، ثمّ جرى ترحيلها بعد الانتهاء من هذه المشاريع، لم نكن نقصد إلى إسباغ الطابع التاريخي على قصة الخروج. فهذه القصة تبقى بعد كل شيء ملحمة أدبية قامت على موروث غامض ومشوّش في ذاكرة إحدى الجماعات التي استوطنت منطقة المرتفعات الفلسطينية في عصر الحديد الأوّل، وهي الجماعات التي تشكّلت منها في عصر الحديد الثاني مملكتا إسرائيل ويهوذا. إلا أنّ أهمّية هذه الملحمة التي تشغل الأسفار المركزية الأربعة في الكتاب، تنبع من كونها مصدراً للعقيدة التوراتية، وشاهداً على ميلاد إله جديد سوف تقوده مسيرته الطويلة لأن يكون وراء مفهوم «الله» في الديانات التوحيدية اللاحقة.
كان آخر ظهور للإله التوراتيّ في سفر التكوين عندما خاطب يعقوب وحثّه على الالتحاق بيوسف هو وجميع أهله: “لا تخف أن تهبط إلى مصر لأني سأجعلك أمة عظيمة هناك.” (التكوين 46: 3). وبعد ذلك غاب عن مسرح الحدث نحو أربعمائة سنة، كان بنو إسرائيل خلالها قد وقعوا تحت نير العبودية بعد وفاة يوسف. وعندما ازداد أنينهم تحت أثقال عمل السخرة المرهق: “صرخوا وصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أنينهم فتذكّر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب.” (الخروج 2: 23-24). ثم إن اختيار الربّ قد وقع على موسى لينقذ شعبه من خلاله، فتجلى له وهو يرعى غنم حميه يثرون عند جبل حوريب في نار عليقة كانت تتوقد بالنار دون أن تحترق وقال له: “أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه إذ خاف أن ينظر إلى الله”. وهنا نلاحظ كيف يدمج المحرر الهويات الإلهية الثلاث في شخصية واحدة مثلما رأينا في سفر التكوين. فهو الربّ/يهوه: “فلما رأى الربّ أنه مال لينظر”. وهو الله/إيلوهيم: “ناداه الله من وسط العليقة”. وهو إله العائلة: “أنا إله أبيك، إله إبراهيم..”.
في الخطاب اللاحق مباشرة هناك هوية جديدة تُضاف إلى هذه الهويات الثلاث، وهي إله شعب بذاته. فالإله القديم لم يعد إلهاً لعائلة صغيرة كما كان في عصر الآباء، بل إلهاً لشعب كبير سيكون تعداد رجاله وحدهم عند الخروج من مصر ستمئة ألف، وهذا العدد يقارب المليون إذا أضفنا إليه النساء والأطفال. وقد اختار يهوه هذا الشعب من بين كل الشعوب ليكون خاصة له ويكون له إلهاً، وأخذ على نفسه عهداً بتحريره من العبودية وقيادته إلى الأرض الموعودة:
“فقال الربّ: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأُصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً… فالآن هلمَّ فأرسلك إلى فرعون وتُخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أُخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أنّي أرسلتك. حينما تُخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل… ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيدٍ قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم. وأُعطي نعمةً لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين.” (الخروج: 3).
من هذا الخطاب الذي استهل العلاقة بين يهوه وشعبه، نستطيع ملاحظة عنصرين تميزت بهما ديانة إسرائيل عن بقية ديانات الشرق القديم هنا:
1- اختيار الإله لشعبه وليس العكس كما جرت العادة.
2- وجود بداية في التاريخ لهذه الديانة.
فيما يتعلق بالعصر الأول نجد أنه للمرة الأولى في تاريخ أديان المنطقة يقوم إله ما باختيار شعب له يعبده، بينما القاعدة هي أن الناس يختارون آلهتهم ويغيرون ولاءاتهم الدينية متى شاؤوا أو متى رحلوا إلى مكان جديد، لأن آلهة الشرق القديم كانت آلهة أمكنة لا آلهة شعوب بعينها. فالإله إنكي مثلاً كان إلهاً لمدينة إيريدو على شاطئ الخليج العربي منذ بداية تأسيسها قبل الألف الثالث ق.م، وبقي كذلك رغم ما حصل في المكان من تغييرات ديموغرافية أدت إلى تبدلات في الذخيرة السكانية. وإنليل كان إلهاً لمدينة نيبور وفيها مسكنه الدائم، وسن كان إلهاً لمدينة أور.. وهلم جرا. فإذا عُبد الإله في أكثر من مكان أُضيف اسم المكان إلى اسم الإله، كما هو حال الإله الكنعاني بعل، الذي نعرفه تحت أسماء شتى تبعاً لأماكن عبادته، فهنالك بعل صافون وبعل فغور وهلم جرا. وفي الحقيقة فإن اللغة الأكادية، ومثلها الكنعانية بلهجاتها، لا تحتوي مفردة بمعنى شعب أو أمة. وكلمة نيسو (= الناس) التي تترجم عادةً إلى شعب، تعني أُناس الأرض وسكانها الذي يمكن أن يتغيروا من الناحية الإثنية دون حدوث تغيير في الآلهة المعبودة، لأن القادمين الجدد سوف يعبدون بعد استقرارهم إله المكان الجديد لا آلهتهم السابقة. في ظل هذا الوضع كان الإله مالكاً للأرض ويدير ملكيته من خلال الملك الذي ينظم شؤونها، ومن خلاله كان ينفذ قراراته ويمارس سلطانه. وعلى عكس ذلك كله فقد ارتبط يهوه منذ البداية بشعب لا بمكان، وهو ليس مالك أرض بعينها ولذلك فقد كان عليه أن يقاتل إلى جانب شعبه من أجل طرد شعوب من أراضيها وإيجاد موطئ قدم لشعبه في عالم مزدحم بالشعوب، وموطئ قدم له في سماء حافلة بالآلهة.
وفيما يتعلق بالعنصر الثاني فإن يهوه وديانته قد نشئا في سياق تاريخي، أما بقية ديانات الشرق القديم فمتجذرة في الأزمان الميثولوجية الأولى، وآلهتها قد ولدت مع بداية الزمن وخروج الكون المنظم من الشواش البدئي السابق عليه. وهذه الآلهة لا تمارس فعلها في التاريخ، ومعظمها مرتبط بالحركة التكرارية وغير التاريخية للأجرام السماوية: شمس، قمر، زهرة…الخ، أو بدورة الفصول الروتينية كما هو حال آلهة الخصب. أما يهوه فيفعل في التاريخ، وفعله هذا لم يقتصر على البداية فقد عندما حرر العبرانيين من العبودية في مصر، بل استمر بعد ذلك محركاً للأحداث حتى نهاية القصة التوراتية. ويتصل بهذه الميزة التاريخية لديانة يهوه ميزة أخرى، فهي نتاج مؤسس واحد معروف وموصوف وله سيرة حياة ترويها الموروثات، وهذا أمر غير معروف في ديانات الشرق القديم التي لم تعرف لها مؤسساً مثلما لم تعرف لها بداية محددة في التاريخ.
على أنه تعهد يهوه لشعبه بقيادتهم إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً قد جعل منه بالضرورة أمير حرب. فهذه الأرض ليست ملكاً له من ناحية وليست خالية من السكان من ناحية ثانية. وهو يُعدد لموسى من سكانها: الكنعانيين والآموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين (الخروج 3: 8)، وهؤلاء لا بد من طردهم أو إفنائهم. وستكون هذه هي مهمته بعد أن لبس عدة الحرب، وهذا وجه جديد للإله التوراتي، لم نصادفه في قصص الآباء. فإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان إلهاً مسالماً لم يشنّ حرباً على أحد، ولم يستشره أحد قبل الدخول في حرب أو يشكره على نصر بعدها. فعندما جاء الملوك الأربعة وحاربوا مدينتي سدوم وعمورة وغنموا كل ممتلكاتهما وأخذوا لوطاً أسيراً مع كل مواشيه، لحق إبراهيم بهم فأدركهم وهزمهم وحرّر ابن أخيه وعاد، دون أن نسمع للربّ رأياً في هذه المسألة. ولم يكن إبراهيم من شكر الربّ على النصر وإنما ملكي صادق ملك شاليم الذي أعاد إليه إبراهيم أيضاً أملاكه المسلوبة: “وأخرج ملكي صادق ملك شاليم خبزاً وخمراً لأنه كان كاهناً لله العلي (= إيل عليون بالعبرية)، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، وتبارك الله العلي الذي دفع أعداءك إلى يدك.” (التكوين 14). وعندما شن أولاد يعقوب حرباً على مدينة شكيم انتقاماً لأختهم دينه وقتلوا كل ذكر فيها، لم يكن للربّ يد في ذلك ولا هو حضّ على هذه الحرب أو شجب.
ولكن إله الخروج هو غير إله إبراهيم، وقد صار الآن عازماً على خوض حرب تبدو بلا نهاية، وممارسة العنف الإلهي في أكثر أشكاله هولاً. والقوة التدميرية العمياء التي يملكها سوف يجري توظيفها في المهمة التي اضطلع بها، وهي المهمة التي أخرجته من مجال الطبيعة وأدخلته في مجال التاريخ. إن دوره في المعارك المقبلة لن يقتصر على قيادة بني إسرائيل وتقوية عزيمتهم في المعارك، بل سيتعدى ذلك إلى النزول بنفسه إلى الميدان والالتحام المباشر مع العدو كما فعل عندما طارد فرعون وجنوده بني إسرائيل بعد أن غادروا مصر: “وكان في هزيع الصبح أن الربّ أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع دواليب مركباتهم حتى ساقوها بمشقة. فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأنّ الربّ يقاتل عنهم.” (الخروج 14: 24-25). ومنذ الآن سيكون اللقب المحبب لديه هو لقب ربّ الجنود، وكذلك رجل الحرب. وبهذا اللقب الأخير يفتتح موسى تسبيحته للربّ بعد عبور البحر الأحمر: “هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. الربّ رجل الحرب اسمه. مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر… الخ” (الخروج 15: 2-4).
قبل أن يبدأ يهوه ملحمة القتل الكبرى في المصريين، أراد أن يوقع في نفس موسى رعباً لن ينساه وينقله بعد ذلك لأجيال بني إسرائيل، رعب الموت الماثل أبداً يأتي الربّ به من شاء ومتى شاء وأنى شاء دون مساءلة. فعندما كان عائداً من مديان إلى مصر تنفيذاً للأمر الذي تلقاه بالدخول على فرعون، ظهر له الربّ في استعراض مهيب للقوة وطلب أن يقتله، وذلك في القصة التي أوردناها سابقاً، والتي يبدو لنا من سياقها أن السبب في عقوبة موسى كونه لم يختتن هو وابنه بعد. ولكن المشكلة في هذا التفسير هي أن شريعة الختان لم تكن قد نزلت بعد مع بقية الشرائع، وموسى قد تجاهل أمراً لم يكن قد صدر إليه. ولذلك فإن ما تريد القصة قوله عن الربّ هو أنه لا يحتاج إلى ذريعة من أجل تبرير قضائه، فهو سيد الحياة والموت وصانع الخير مثلما هو صانع الشر، وعلى حد قوله في سفر التثنية: “أنا أميت وأحيي. سحقتُ وإنني أشفي، وليس من يدي مخلِّص.” (التثنية 32: 39)، ولذلك ما على الإنسان إلى قبول القضاء خيره وشره من الربّ. وقد كان أيوب واعياً لهذه المسألة، فعندما قالت له زوجته بعد الكوارث التي أنزلها به الربّ دون سبب: “العن الله ومت(1). فقال لها: تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات. أَالخير نقبل من عند الله والشرّ لا نقبل؟” (أيوب 2: 9-10). ولكن لماذا يتوجب على الربّ أن يكون شريراً؟ ولماذا يتوجب على المرء أن يقبل منه الشرّ؟
على أنّ نجاة موسى من الموت قتلاً على يد إلهه لم تكن سوى نجاة مؤقتة، والربّ سوف
يقتله في النهاية هو وهارون رغم من كل ما قدما له، وذلك بسبب خطيئة
طقسية ارتكبها موسى من غير عمد وفي لحظة إحباط ويأس أثناء قيادته للشعب في
سيناء. وكان أن أصدر الربّ حكمه بالموت على هارون بعد الإقامة الطويلة في
سيناء (العدد 20: 20)، أما موسى فقد جرى إمهاله حتى وصل بقومه إلى ضفة نهر
الأردن، حيث أصعده الرب إلى قمة جبل نبو وهناك قتله (التثنية 32: 49-53).
قبل أن يصل موسى إلى مصر خرج هارون للقائه بوحي من الربّ، فقد كان عليه أن يكون ساعده الأيمن ووسيطاً بينه وبين الشعب نظراً لفصاحته وطلاقة لسانه: “فمضى موسى وهرون وجمعا شيوخ بني إسرائيل، وخاطبهم هرون بكل الكلام الذي كلم به الرب موسى، وصنع الآيات على عيون الشعب، فآمن الشعب. وإذ سمعوا أن الربّ قد افتقد بني إسرائيل ونظر في مذلتهم خروا وسجدوا.” (الخروج 4: 27-31).
ولكن هل آمن الشعب فعلاً بإله موسى وقبلوا أن يكونوا شعباً له؟ وهل كانوا على استعداد لدفع ثمن الحرية؟ إن مسار الأحداث اللاحق هو الكفيل بالإجابة على ذلك. فقد دخل موسى وهارون على الفرعون وقالا له: “كذا قال الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي لكي يعبدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب فأسمع لقوله وأُطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب، وإسرائيل لا أطلقه.” وبعد أن صرفهما أمر الفرعون مسخري الشعب أن يزيدوا من أثقالهم، فصاروا في شقاء أكثر من الأمس. وقال رؤساء الشعب لموسى وهارون متذمّرين عليهما: “ينظر الربّ ويحكم عليكما لأنكما أفسدتما أمرنا عند فرعون وعند عبيده وجعلتما في أيديهم سيفاً ليقتلونا” (الخروج: 5). أي إن الشعب لم يكن مستعداً لدفع ثمن الحرية. ولسوف نسمعهم مراراً بعد ذلك يقولون إنهم نادمون على ترك مصر وراغبون في الرجوع إليها.
بعد ذلك تندلع الحرب بين يهوه والفرعون. ففي كل مرة يدخل فيها موسى وهارون على فرعون طالبين إطلاق بني إسرائيل، كان يهوه يقسي قلب الفرعون لكي لا يقبل طلبهما فيُنزل به وبشعبه كارثة ماحقة تتردد أصداؤها في كل مكان. فهو لم يكن راغباً في نصر سهل في فاتحة حروبه هذه، بل في نصر سوف ترويه الأجيال اللاحقة: “ادخل إلى فرعون فإني قد أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك ما فعلتُه في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم. فتعلمون أني أنا الربّ.” (الخروج 10: 1-2).
وهكذا فقد أرسل يهوه في المرة الأولى كارثة الدم الذي ملأ نهر مصر وينابيعها، ثم الضفادع التي راحت تسرح بأعداد لا حصر لها في الحقول والبيوت، ثم البعوض، ثم الذباب، ثم أوبئة فتكت بجميع المواشي، ثم الدمامل والقروح والبثور، ثم البَرَد انهال من السماء مع نار وأهلك الناس والبهائم، ثم الجراد الذي التهم كل ما تركه البرد سليماً، ثم الظلام الذي خيم على الأرض ثلاثة أيام (الخروج: 7-10). وأخيراً نزل الربّ بنفسه وأمر موسى أن يذبح كلُّ بيت حَملاً من الضأن أو الماعز ويجعلون من دمه على الباب علامة لكي يميز بيوتهم عن بيوت المصريين فيعبُرَ عنهم في الضربة الأخيرة التي يعدها للمصريين، وتكون لهم هذه المناسبة عيد فصح (أي عبور) على مر الأيام. ثم إن الرب اجتاز في وسط مصر ليلاً وقتل كل ولدٍ بكرٍ في أرضها من بكر الفرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة. وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. أما بيوت العبرانيين فقد عبر عنها بعد أن رأى علامة الدم. فدعا الفرعون موسى وهارون ليلاً وقال: قوموا واخرجوا من بيت شعبي جميعاً واذهبوا اعبدوا الرب. فحمل الشعب متاعهم وكل ما لهم مع ما استعاروه من آنية فضة وآنية ذهب وثياباً، وارتحلوا من مدينة رعمسيس إلى سُكُّوت نحو ستمئة ألف ماشٍ من الرجال عدا الأولاد. وصعد معهم لفيف كثير أيضاً مع غنم وبقر ومواشٍ وافرة جداً. وأما إقامة بني إسرائيل في مصر فكانت أربعمائة وثلاثين سنة. (الخروج: 11-12).
وهكذا حقق يهوه انتصاره الأول على أعتى قوة في ذلك الزمن. وعلى ما جرت عليه عادة المنتصر من استيلائه على أموال وممتلكات المهزوم، فقد استولى يهوه على ممتلكات المصريين التي زين لهم إعارتها لبني إسرائيل والتي حملوها معهم في خروجهم. ولكن إذا كانت هذه الغنائم التي تقرها قوانين الحرب القديمة مشروعة بالنسبة ليهوه، إلا أنها ليست مشروعة لبني إسرائيل لأنهم لم يشاركوا في الحرب بل الرب هو الذي حارب عنهم وهم يتفرجون. لذلك فإن ما قاموا به لا يمكن وصفه إلا بالسرقة. وهذا هو التعبير الذي استعمله محرر السفر عندما قال: “وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين” (الخروج 12: 36).
هذه السرقة التي قام بها بنو إسرائيل مع الحدث الذي افتتح تاريخهم، بمباركة من يهوه الذي حضهم عليها، هي التي ستجعل فيما بعد أموال الأغيار من غير اليهود حِلاً لهم. ولسوف تكون وسيلتهم المفضلة لذلك هي الإقراض بالرِّبا الفاحش ثم الاستيلاء على أملاك المقترض العاجز عن السداد. وقد أوضح لهم يهوه أن الإقراض سيكون وسيلتهم للسيطرة على الأمم: “إذا سمعت لصوت الرب إلهك… يقترض منك أمم كثيرون وأنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرين وهم لا يتسلطون عليك.” (التثنية 15: 5-6). ثم أوضح لهم أن الإقراض بربا سيكون محصوراً بإقراض الأجانب: “ولا تقرض أخاك بربا بل الأجنبي إياه تقرض بالربا. وأخاك لا تقرضه بالربا لكي يبارك الرب إلهك جميع أعمالك”. (التثنية 23: 19-20).
بعد طقس الفصح وهو أول الطقوس في شريعة يهوه، ومع البهجة الغامرة بالتحرير، أخذ بنو إسرائيل يشعرون بوطأة هذا الإله الغريب، عندما كشف عن طبيعة الميثاق الذي فرضه عليهم. فهم بقبولهم أن يكونوا شعبه الخاص وقبولهم التحرير على يديه قد باعوا أرواحهم له إلى الأبد، وذلك من خلال الطقس الثاني الذي استنّه لهم عندما قال لموسى: “قدِّس لي كل بكر، كل فاتح رحم، من بني إسرائيل، من الناس والبهائم. إنه لي.” (الخروج 13: 1-2). أي إن الأبكار من مواليد الشعب ومواليد بهائمهم يجب أن تُقدّم قرباناً له على المذبح. ويبدو أن هذه الممارسة كانت شائعة لدى الجماعات التي عبدت يهوه في البوادي ومنهم جماعة عابيرو الخروج، ثم عفا عليها الزمن بعد استقرار هؤلاء في الأرض. وهذا ما نصت عليه شريعة الفداء اللاحقة حيث يخاطب يهوه هارون باعتباره الكاهن المسؤول عن طقوس القرابين قائلاً: “كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك. غير أنك تقبل فداء بكور الإنسان.” (العدد 18: 15). ومع ذلك فإن الفقرة التشريعية الرئيسية التي تقضي بتقديم بني إسرائيل بكور أولادهم للرب، سوف تبقى أمامهم تذكاراً بأنه هو المتحكم بالأرواح والقادر على حفظها أو على سلبها متى شاء. ولسوف نرى فيما بعد أن عادة تقديم الأولاد محارق على المذبح بقيت سائدة في مملكة يهوذا حتى أواخر أيامها.
هامش:
1- وردت هذه الجملة في الترجمات العربية: “بارك الله ومت”، أما في الأصل العبري فهي: “إلعن الله ومت” وكذلك في الترجمات الإنكليزية




