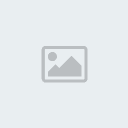
هل يصح الكلام على مجتمع من المعتقلين السياسيين السابقين في سوريا؟ بتحفظ شديد فقط. فقد آلت سياسات النظام العنيفة إلى تمزيق المجتمع السوري ذاته، وعزل الناس عن بعضهم، وحراسة العزلة هذه بالخوف والريبة. وبعد عشرين عاما من الخوف والعزلة آلت شبكات العلاقات الأفقية بين سكان البلاد إلى الاضمحلال، فيما أضحت السلطة، وأجهزة الأمن في قلبها، الممر الإلزامي لأية علاقات بينهم، حتى “الحميدة” منها. من باب أولى، إذن، ألا نتوقع نظاما من علاقات متنوعة يربط بين أفراد الفئة التي مثلت في أعين السوريين المصير الذي يسعون إلى تجنبه ما استطاعوا.
يضاف إلى مفعول الخوف المبعثِر والمولِّد للعزلة حاجة المعتقلين إلى إعالة أنفسهم وأسرهم من أجل استعادة احترامهم لذواتهم وإحياء الثقة بقدراتهم الشخصية. يعود أكثر الطلاب الجامعيين لمتابعة دراستهم، ويبحث أرباب الأسر عن أعمال تتيح لهم دخلا يعتاشون منه ويعيلون أسرهم. يندمج المحظوظون في مشاريع عائلية، أو يلقون دعما ماديا قويا يمكنهم من الوقوف على أقدامهم بسرعة. في كل الحالات يستهلك هذا الجهد وقتا كبيرا، يكون في الغالب على حساب الاهتمام بالشؤون العامة، وخصما من بناء علاقات جديدة والتعرف على أشخاص جدد. يعزز من هذا الشرط أن معظم من حافظوا على درجة من التماسك الشخصي من المعتقلين السياسيين السابقين يتملكهم شعور بضرورة إنجاز أكثر ما يمكن في الوقت المتاح لهم.
هذا بدوره يقصّر الروابط حتى مع زملاء السجن السابقين، دع عنك تجريب التعرف على أوساط جديدة.
على أن الملاحظة المؤكدة تثبت أن السجناء اليساريين السابقين أقرب إلى تشكيل “مجتمع”، أي شبكة علاقات شخصية تتيح لجميع المنخرطين فيها الاشتراك في خبرات سابقيهم ومعلوماتهم، وتمد القادمين الجدد إليه (من أفرج عنهم متأخرين) بأنواع من الدعم الاجتماعي والمعنوي الضروري. فالأمر هنا كما في السجن: من يأتي متأخرا يستفيد مما راكمه السابقون من خبرات ومعارف عملية وحلول للمشكلات المتواترة. ويعود تمايز السجناء اليساريين في هذه النقطة إلى عاملين: أولهما، أنهم يتمتعون بدرجة أكبر من الأمن قياسا للمعتقلين الإسلاميين أو المنتمين إلى البعث الموالي للنظام العراقي، ما يوسع من مجال حركتهم وتنوع معارفهم. ثانيهما، إن عددا يقدر بالعشرات منهم مشاركون نشطون في الحياة العامة خلال السنوات المنقضية من هذا القرن: كتاب، مترجمون، ناشطون حقوقيون وسياسيون..، الأمر الذي يعطيهم درجة من الحصانة، ويوسع أكثر شبكات علاقاتهم. ولعل مقياس الحصانة النسبية هذه يتمثل في انه لم يتكرر اعتقال أي معتقل يساري سابق خلال السنوات الخمسة ونصف السابقة، رغم مساهمتهم المهمة في حركة المعارضة، باستثناء رياض الترك بين عامي 2001 و2002، ومحمد حسن ديب الذي قضى ثمانية شهور معتقلا[1]، لأنه كان يصور وينشر مقالات ونشرات معارضة في مكتبته في بلدة سلمية وسط البلاد (أفرج عنه في شهر كانون الأول 2005). ولم يعتقل إسلاميون مفرج عنهم ثانية في حدود علمي، ولكن لأن الحجر السياسي عليهم محروس بصرامة مفرطة.
على أن اليساريين أنفسهم يتوزعون إلى أكثر من عالم حسب الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها. كان هناك تنظيمان شيوعيان اعتقل أكثرية أعضائهما في ثمانينات القرن الماضي. وشبكة التفاعلات الداخلية بين معتقلي كل من التنظيمين، أكثف من شبكة تفاعل كل منهما مع الأخرى أو مع شبكات أخرى. أي أن تبادل العون والمعلومات والخبرات وشراكة أوقات التمتع.. أقوى بين أفراد كل من المجموعتين.
Imageبالمقابل، لا تكاد تكون ثمة علاقات بين المعتقلين السابقين اليساريين والمعتقلين الإسلاميين. أحد الأسباب القوية لذلك تباعد أنماط الحياة والأذواق وطرق قضاء أوقات الفراغ ونماذج السلوك والأزياء. من غير النادر أن يسهر سجناء يساريون معا، وهم يتناولون مشروبات كحولية، وبرفقة نسائهم أو صديقاتهم. فيما لا يتذوق الإسلاميون الخمر، ويراعون الفصل بين الجنسين بقوة. من أسباب ذلك أيضا قوة الرقابة الأمنية على الإسلاميين مقارنة باليساريين، علما أن هؤلاء بدورهم مراقبون ويتعرضون لأشكال متنوعة من التقييد والضغوط. لقد أعاد اليساريون بناء أحزابهم، وغيروها أو أعادوا بناءها في بعض الحالات (الحزب الشيوعي - المكتب السياسي عقد مؤتمرا في نيسان 2005، وغير اسمه إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري)، ما يعني أنهم دشنوا لأنفسهم تاريخا جديدا. وهم ينشطون علنا أو بصورة نصف علنية دون أن يعيد النظام اعتقالهم[2]. وأعاد يساريون أيضا صلتهم بالميدان العام عن طريق الكتابة السياسية والأدبية، التي تنشر في الانترنت أو في الصحافة العربية واللبنانية، أو عن طريق النشاط الحقوقي. فيما عزل الإسلاميون عزلا محكما عن المجال العام وتقطعت عمليا روابطهم بغير أسرهم وأوساط ضيقة حولهم. ومن المحتمل أن يواجه تنظيم الإخوان المسلمين السوريين مشكلات سياسية في المستقبل حين يتاح لقيادات التنظيم خارج البلاد أن تعود، لأنه لم يتح لهم ما أتيح لليساريين من تمرس بمشكلاتهم ومحاولة التغلب عليها.
على أن الإسلاميين يجدون تعويضا عن الانخراط في الشأن العام بسهولة استئناف حياتهم الاقتصادية والعثور على فرص عمل. يميل الناس إلى منح فرصة عمل إلى سجين إسلامي سابق لأنه “أمين”. لا يقال إن اليساريين غير أمناء، لكن يفضل كثيرون نموذجا من الأمانة يألفونه ويرتاحون إلى سنده الديني. والواقع أن السوريين عموما يحترمون “أصحاب المبادئ”، وبالخصوص أخلاقياتهم، وإن لم يشاركوهم شيئا من مبادئهم.
ثمة استثناءات لعلاقات مفتوحة بين إسلاميين سابقين ويساريين سابقين. لقد ذللت السجون عند البعض من الطرفين الحواجز الإيديولوجية والفوارق بين أنماط الحياة، لكن خطوط التواصل ظلت محدودة ونادرة بالفعل.
أصناف المعتقلين السابقين
يختلف تصنيف المعتقلين السابقين وفقا للمعايير التي يمكن أن نعتمدها. سأعتمد هنا خمسة معايير، تترتب عليها خمسة تصنيفات تقريبية:
- علاقتهم بالشأن العام؛
- علاقة المعتقلين بأسرهم؛
- علاقتهم بالمرأة /علاقتهن بالرجل؛
- حياتهم العملية وكيفية تحصيلهم للمعيشة؛
- علاقتهم مع أنفسهم وتعاملهم مع صورتهم.
أشرت للتو إلى أن فرصة المعتقلين اليساريين، وغير الإسلاميين بصورة أعم، في الانخراط في العمل العام السياسي والثقافي أوسع من فرصة الإسلاميين. غير أن التمعّن في الأمر يكشف تلوينات أغنى.
إن نسبة من أظهروا درجة من الاهتمام بالشأن العام بين الشيوعيين كانت متدنية جدا بين المفرج عنهم في نهاية عام 1991. هنا أيضا لا مجال لإعطاء نسب دقيقة لغياب أية معطيات موثوقة. كذلك لأن التنظيمات المعنية لا تزال اليوم، مطلع 2006، تعمل بصورة غير شرعية قانونيا. وبين يدي قائمة بأسماء معتقلي الحزب الشيوعي - المكتب السياسي (حزب الشعب الديمقراطي حاليا) غير مكتملة، ترد فيها أسماء 217 معتقلا، وحافلة بالأخطاء فوق ذلك.
كان ثمة من حرصوا على قطيعة تامة بكل ما يذكرهم بماضيهم السياسي. وهناك زملاء سجن لي قضيت معهم سنوات، ولم أرهم أو أسمع عنهم أي شيء بعد إطلاق سراحي متأخرا عنهم بسنوات. كانت التنظيمات تلك مطلع التسعينات منهكة، إن لم نقل منهارة. وهي تاليا غير قادرة على دعم معتقليها المفرج عنهم، وكان كثير من هؤلاء غير راغبين في الاتصال برفاقهم السابقين، سواء لأنهم غيروا أفكارهم، أو بالخصوص لأنهم يخافون تبعات أي اتصال. ومن الشائع أن تروى طرائف مأساوية عن أشخاص سلكوا دربا آخر لأنهم لمحوا عن بعد زميل سجن قادما باتجاههم. لقد حولوا خوفهم من السلطات إلى موقف معاد لكل ما من شأنه تذكيرهم بالاعتقال والتعذيب والسجن.
ومن يُحتمل أنهم شاركوا في نشاط الأحزاب المحدود فعلوا ذلك بصورة بالغة السرية. واستمر هذا الشرط كذلك حتى أواخر التسعينات. لكن نسبة أعلى من أولئك الأفراد أنفسهم الذين ابتعدوا عن المخاطر في التسعينات اقتربت من الأنشطة العامة المتاحة بدءا من عام 1998، وبالخصوص بعد عام 2000. وحتى من آثروا الابتعاد عن أحزابهم صارت مواقفهم أكثر إيجابية حيالها وحيال رفاقهم الذين مارسوا نشاطا علنيا.
على أن العديد من المعتقلين اليساريين، يتعلق الأمر بإجمالي يتعدى ألف رجل وبضع عشرات من النساء، استأنفوا العمل العام بطريقة مختلفة: تحولوا مثلا من السياسة إلى الثقافة، أأو من الحزب السياسي إلى منظمة لحقوق الإنسان. ومن العائدين من لم يغيروا في أنفسهم شيئا، ومنهم من تغير فكريا وسياسيا، ومنهم (قلة) تحولوا إلى أعداء ألداء لأحزابهم السابقة.
أشرنا، فيما يخص الإسلاميين، إلى الدور الحاسم لعنصر التضييق الأمني في الحد من مشاركتهم في الشأن العام. بالفعل، لا نكاد نجد أي معتقل إسلامي سابق شارك في الحراك المستقل والديمقراطي الذي شهدته البلاد أثناء “ربيع دمشق”. إن ربيع دمشق، وهو كناية عن حيازة هوامش أوسع في حرية الكلام والتعبير عن الرأي وفي التجمع الطوعي المستقل، نتاج علماني محض، أسهم معتقلون سياسيون سابقون بقسط وافر فيه[3] ما يصعب تقديره هو نسبة المعتقلين الإسلاميين السابقين الذين يمكن أن يشاركوا في النشاط العام في ظروف آمنة، ونسبة من يتقبلون الشراكة مع علمانيين، ونسبة من يأخذون موقفا عدائيا ضد العلمانيين.. وبخصوص بعض الإسلاميين، قد يكون هناك عنصر إيديولوجي خلف ابتعادهم عن الأنشطة العامة، أعني رفضهم المشاركة في نشاطات يهيمن عليها علمانيون. ولا ريب أن بعضهم يرفض، مثل النظام البعثي تماما، فكرة مجال عام مفتوح لمختلفين على قدم المساواة فيما بينهم.
التنظيم البعثي الموالي للنظام العراقي السابق تحلل بفعل مزيج من سبب أمني (حظي بالمعاملة الأسوأ بعد “الإخوان المسلمين” بين التنظيمات السورية المعارضة)، ولسبب إيديولوجي يتمثل في تراجع الفكرة القومية العربية التي كانت إيديولوجية التنظيم، وتدهور طاقتها التعبوية. وأخيرا انهيار النظام الذي كان يسند الجناح البعثي السوري المعارض. علما أن الجناح هذا كان دوما متورطا في لعبة العلاقة السيئة بين النظامين البعثيين.
العلاقة بالأسرة
طوال شهورا عانى ص. ع، الذي قضى 15 عاما في السجن، من صعوبة في التفاهم مع ابنته اليافعة التي كانت بلغت الخامسة عشر من عمرها حين أفرج عنه عام 1998. كانت أم الفتاة حاملا بها حين اعتقل الأب؛ الأم ذاتها اعتقلت لوقت قصير مع الزوج عام 1983. وكان الرجل الذي خرج من السجن وهو في أواسط أربعينيات عمره والفتاة المراهقة يتنازعان الأم ويغاران من بعضهما عليها، حسب رأي الأم نفسها.
وواجه ف.م الذي قضى 10 سنوات حالة معاكسة. فقد أفرج عنه عام 2000، وكان سمع عن المصاعب التي يواجهها زملاؤه الذين سبق أن أفرج عنهم مع أبنائهم. لذلك تعمد أن لا يتدخل في حياة ابنه البالغ من العمر 17 عاما. بعد عامين، شكا الابن الكتوم من أن والده لم يكن مباليا به، ولا مهتما بمعرفة ما يفكر فيه وما يحتاجه. أما ابنته، وكانت في الثالثة عشرة، فقد كانت تنكمش حين يضع أبوها يده على كتفها، وظلت لبضعة أشهر تتصرف حياله بتحفظ، فلا تخلع شيئا من ثيابها أمامه. لكن حالتي ص. ع و ف.م كانتا مخففتين قياسا إلى حالات كثيرة أصعب.
أخفق م.د، وكان عضوا في حزب يساري، في ترميم علاقته مع ابنته البالغة 12 عاما حين أفرج عنه بعد 8 سنوات ونصف سجنا. تقول الفتاة إنه لطالما تعامل معها كطفلة عمرها أربع سنوات، أي كما تركها قبل اعتقاله، ورغم ذلك لطالما نعى عليها وعلى أبناء جيلها أذواقهم وتصرفاتهم، وكان لا يمل من تذكيرها بأن جيله أفضل من جيلها. وتلخص موقفه حيالها: “يناقشني ككبيرة، ويعاملني كصغيرة”. ولأنها اعتقدت أنه كان يريد لحياتها أن تكون مثل حياته، جاهرته مرة بأنها تتمنى له أن يعود إلى السجن. في السادسة عشر من عمرها بلغ ضيقها من أبيها حد أنها أخذت حبوبا منومة بِنيّة أن تنتحر، لكنها بدلا من أن تموت نامت 20 ساعة متواصلة. وهكذا قررت أن تستمر في أخذ الحبوب لتنام أوقاتا طويلة، وكي تكبر وهي نائمة دون أن تحس بالوقت، ودون أن ترى الأب البغيض. وكم استمتعت وهي تراه يأخذها من طبيب إلى آخر ويجري فحوصا مكلفة: تحاليل لوظائف القلب والدماغ، رنين مغناطيسي MRI، تصوير طبقي محوريCT scan وغيرها، لتفسير سبب نومها المستمر. تقول: “كنت سعيدة وأنا أراهم يتعبون بي”. انقضى شهران طويلان قبل أن ينكشف سبب النوم، وخلالهما، شيئا فشيئا، أخذ يتكون بين الفتاة وأبيها “تواصل روحي” حسب تعبيرها، وأخذت تحبه كثيرا دون أن تكف أحيانا عن كرهه كثيرا. “اكتشفت”، تقول، “أن حب الأب يأتي بالمعايشة والمشاركة وليس من تلقاء نفسه”. “ليس لأبي وجود في ذاكرتي السابقة، لقد حضر فجأة، وكان والدي و... فقط”.
قد لا يكون صحيحا أو دقيقا كل ما تقوله الفتاة التي تبلغ الآن الثالثة والعشرين، وترى أن أباها أضحى الآن صديقا لها، لكنه يلقي ضوءا على صورة جانبية للآباء في عيون أولادهم الذين كانوا صغارا وكبروا في غيابهم واعتادوا عليه.
بعض الأزواج لم يتمكنوا من استئناف حياتهم الزوجية. يرتطم تعبان، تعب الزوجة المنتظرة والتي كانت تعيل الأسرة في غياب الزوج وتعب الزوج الذي قضى سنوات طوال حبيسا، فيتولد عن ارتطامهما حياة شقية أو طلاق. خلال تلك السنوات، كبرت الزوجة، وذبل جمالها، وصارت تريد أن توسد رأسها ذراعا قويا. وبعد غيابه يريد الزوج حبا ورعاية وعملا، وقلما تتسنى تلبية هذه المطالب بسهولة. الزوجة التي قاست الكثير خلال سنوات قد تغدو شخصا قاسيا لا يلين، وقد لا تسمح للزوج أن يتدخل في نظام البيت وكيفية التعامل مع الأولاد. وهؤلاء أنفسهم قد لا يتقبلون هذا الدخيل الذي شبوا في غيابه ولا يشعرون بأي التزام حياله، فكيف إن حاول فرض سيادته في البيت، كما يحصل كثيرا!
في روايتها “كما ينبغي لنهر” تصور منهل السراج، الروائية السورية من مدينة حماة التي شهدت مذبحة فظيعة في شباط 1982، عسر العلاقة بين أحمد الذي كان صغيرا “بال في ثيابه” حين اعتقل، وقضى عشر سنوات في سجن تدمر المرعب، وبين شقيقته فطمة: يحاول أن يفرض تفضيلاته وقراراته عليها وعلى البيت الذي يعيشان فيه. كان عدد من إخوة فطمة وأحمد قد اعتقلوا ولم يعودوا[4].
لم يحدث أن كان زوجان معتقلان سابقان، وأفرج عنهما في الوقت نفسه. فعلى العموم قضت النساء مدة أقل في السجون، وخرجن قبل أزواجهن. كانت ف.خ على وشك أن تطلق زوجها الذي قضى 8 سنوات ونصف في السجن، بينما قضت هي أربع سنوات. لم يتمكن زوجها، ب. ج، من تأمين عمل يدر دخلا كريما. لكن الأهم أن ف. التي كانت في الثالثة والثلاثين حين أفرج عن الزوج، وهذا الذي كان في التاسعة والثلاثين، لم يعرفا كيف يتواصلان، وكيف يشرحان لبعضهما ما يتوقعان من بعضهما، وكيف يحبان بعضهما. اليوم وبعد عشر سنوات من الإفراج عن الزوج يتمتع ب. وف. بعلاقة ممتازة. تأسف ف. لأنها لم تنجب أطفالا، لكن زوجها المحب يسهل الأمر عليهما.[5]
ويسهّل الأمر أيضا أن ب.، وهو مهندس، حصل على عمل يدر دخلا محترما نسبيا. وبعد جهود مضنية حصلت ف. التي تحب الأطفال كثيرا على عمل كمعلمة في مدرسة غير حكومية حيث تعلم أطفالا فلسطينيين في السادسة من أعمارهم (تفاصيل أوسع أدناه).
العلاقة بالجنس الآخر
يتزوج سجناء كثيرون بسرعة بعد الإفراج عنهم. إن حاجات عاطفية وجنسية ضاغطة تدفعهم إلى الارتباط بأول من تلاطفهم تقريبا. هذا لأن السجناء قلما يميزون في الفترة الأولى التالية للإفراج عنهم بين امرأة وامرأة: كلهن لطيفات وحنونات وجميلات... بل كلهن أمهات رقيقات للطفل الذي خرج لتوه من ذاك الرحم الفظ: السجن. لكن في الغالب تكون الزيجات السريعة غير موفقة. كذلك يميل بعض السجناء السابقين إلى استغلال ما ينالونه من تعاطف وتقدير بعد خروجهم من السجن لإقامة علاقات جنسية متعددة تروي لديهم عطشا معذّبا للحب والأمن.
أما النساء بين السجناء فتكون معاناتهن أشد: يفضل الرجال امرأة حديثة كرفيقة وصديقة وربما كشريك جنسي، لكن قليلين منهم يقبلونها زوجة. بوصفهن العنصر الأضعف، تتحمل النساء الوطأة الأشد للأوضاع الأقسى. فقدت بعضهن فرصهن في الزواج، أو كان ثمن زواجهن الاستسلام للأعراف المستقرة في مجتمعاتهن المحلية. وقد تكون المعاناة الأقسى هي معاناة امرأة غير متزوجة اعتقل حبيبها سنوات طوالا. انتظرت ه.غ حبيبها 11 عاما، كانت تزوره خلالها بانتظام، لكن ما إن أفرج عنه حتى أبلغته أنها قررت الرهبنة واعتزلت في دير.
أما السجينات الإسلاميات السابقات فإن العازبات منهن تزداد فرصهن في الزواج، بدل أن تقل. إن السوريين بعامة محافظون في اختيار زوجاتهم، ولذلك يتوفر بسهولة أكبر زوج لامرأة محافظة. وفي مجال أخلاقيات الزواج والعلاقة بين الجنسين، تهيمن بقوة اكبر الأخلاقيات الدينية، لا فرق تقريبا بين الطوائف، ولا فرق مهماً بين علمانيين ودينيين.
يفاقم من صعوبات السجناء المفرج عنهم حديثا والذين قضوا وقتا طويلا في السجن حقيقة أن نسبة عالية منهم فقدت أبا أو أما في غيابهم. كانت والدتي قد توفيت بعد اعتقالي بعشر سنوات، ثم تزوج أبي بعدها، وعاش مستقلا، وكذلك أخوي الأكبرين وأختي الوحيدة. وكان اصغر أخوتي الثمانية في الرابعة والعشرين وقت خروجي. وهكذا وجدت نفسي بعد ثلاثة أسابيع من الإفراج عني وحيدا تقريبا، في بيت بلا نساء، كان قبل السجن يعج بالحياة دوما. ولعل هذا ما زاد من احتياجي للمرأة حدة. كنت أتضور جوعا لعطف أنثوي لا ينتهي، ولا أعرف كيف أطلبه، ولا كيف أحافظ عليه.
العمل وتدبير العيش
على أن المشكلة الأكبر التي يتعين على السجين السابق حلها هي تدبير المعيشة. على العموم لم تمانع السلطات في عودة طلاب الجامعة إلى كلياتهم. كان مشهد رجال في ثلاثينات أعمارهم أو حتى في أربعيناتها مألوفا في جامعة حلب حين عدت إلى الدراسة فيها بين 1997 و2000. كنت أكبر من زملائي في كلية الطب بـ16 عاما. لكن كان في صفي عام 1997/1998 خمسة آخرين قضوا بين ست سنوات و12 عاما في السجن.
وخلال سنوات الجامعة يعتمد السجين على دعم أسرته، أو يعمل ويدرس معا.
كان تعامل السلطات مع السجناء الذين كانوا موظفين عشوائيا لا يخضع لقاعدة مطردة. أعيد بعضهم إلى وظائفهم ونالوا تعويضاتهم، فيما لم يعد بعض آخر. ومنعوا من الحصول على عمل في جهاز الدولة الإداري أو الإنتاجي، و، بالطبع، التعليمي الذي تم تبعيثه بالكامل منذ أواسط سبعينات القرن العشرين.
يعتقد م. ب (انظر أدناه) أن نسبة المعتقلين الإسلاميين الذين أمن أهاليهم لهم عملا لا تكاد تبلغ 20%. أما الباقون فقد “ابتدءوا من الصفر” كما فعل هو. توجه نصفهم نحو أعمال إدارية في القطاع الخاص: مدير صالة بيع، كاتب قبّان، مراقب دوام عاملين... أما ن.د، وقد اعتقل وهو في السادسة عشر من عمره بتهمة العضوية في تنظيم “الإخوان المسلمين”، وقضى 12 عاما بين سجني تدمر وصيدنايا، فيقول إن من لم تمكنهم أسرهم، لعدم قدرتها، من انطلاقة قوية في عالم العمل، “تلوّعوا”. يبدأ احدهم بمشروع صغير، ورشة خياطة مثلا أو تجارة مفرق، لكن كثيرين منهم “أكلهم” التجار الكبار بسهولة.
ويسهم تكافل العائلة الواسعة بدور بالغ الأهمية في مساعدة السجناء بعد الإفراج عنهم سواء عبر منحهم مبالغ مالية أو عبر المساعدة في تأمين عمل. وهي في ذلك تمد يد العون إلى الأسرة الصغيرة أو النووية. ولا يستطيع عموم المتعاطفين تقديم الدعم لأن كل أشكال الروابط الصنعية والطوعية مقيدة بشدة، فيما الروابط الأهلية، العائلة الواسعة والعشيرة، أكثر حرية ولا مجال لتقييدها.
معظم من تسنى لهم السفر إلى أوربا قبل عام 2000 فضلوا، حيثما تسنى لهم ذلك، اللجوء السياسي هناك، كذلك فعل بعض من سافروا بعد عام 2000. كان من سوء حظهم أن قوانين اللجوء في بلدان أوروبا كانت تزداد صرامة. قضى بعضهم سنوات في ظروف بالغة القسوة في معسكرات خاصة، قبل أن يتم قبولهم. ولا ريب في أن دافع الأمن امتزج لدى معظمهم مع دافع التخلص من شروط معيشة قاسية في بلادهم. لكن ظروف عيشهم في أوروبا لم تكن دوما أحسن. وربما أساء إلى أوضاعهم أن سوريين آخرين كانوا في الواقع لاجئين اقتصاديين، دون أن يسبق لهم أن عانوا من اضطهاد سياسي يتخطى ما يعانيه مواطنوهم جميعا. ليس هناك معطيات يمكن الاعتماد عليها عن عدد اللاجئين السياسيين السوريين في أوروبا ممن سبق أن كانوا معتقلين، تخمينيا ربما مئة أو أكثر.
بين المعتقلين السابقين عدد غير قليل ممن يعيشون مما تعلموه في السجن: الترجمة، وخصوصا من اللغة الانكليزية، الكتابة الأدبية والصحفية والفكرية، وفي حالات أخرى قليلة التفرغ للعمل السياسي في أحزابهم التي تعمل في شروط نصف سرية. إن عددا من أهم المترجمين في سوريا كانوا معتقلين سابقين، من أغزرهم إنتاجا ثائر ديب الذي قضى أكثر من أربع سنوات في السجن. وهو اليوم يعمل في وزارة الثقافة السورية متخليا عن ممارسة ما تعلمه في الجامعة، الطب. على أن الأمر يتعلق بعدد محدود، عشرات قليلة، جميعهم تقريبا معتقلين يساريين.
المعتقلات السابقات اللاتي لم يتزوجن يواجهن مصاعب العمل والعيش بحدة أكبر. تقول حسيبة عبد الرحمن، وهي روائية وناشطة سياسية، أوقفت ثلاث مرات وقضت سبع سنوات في السجن، إنها ظلت طوال سنوات “اسماً محروقا”، لا يقبل أحد بتشغيلها خشية اجتلاب غضب أجهزة الأمن على نفسه. ولم تكن حتى قادرة على وضع اسمها على عمل تكتبه حتى أواخر التسعينات حين نشرت روايتها الأولى[6]. هذا ينطبق على أخريات، ويتفاقم مع الزمن ومع تقدمهن في السن.
علاقة المعتقل السابق بصورته
حتى أواخر سبعينات القرن العشرين كانت صورة المعتقل السياسي في سوريا محفوفة بالهيبة والندرة والأسطورة. بعد ذلك أخذ يغمرها الابتذال لكثرة عدد المعتقلين السابقين ولخروج كثيرين منهم “مكسورين”. مع ذلك ثمة درجة من السحر والأسطورة تحيط بصورة المعتقل السياسي، بالخصوص الذي يعود إلى الانخراط في العمل العام. وهو ما ينطبق على اليساريين. وللأسف، هنا أيضا، لا أملك معلومات موثوقة عن السجناء الإسلاميين. لكن م. ب الذي سأورد معلومات أوسع عنه في ما يأتي يرصد أنه وأمثاله “من التيار الإسلامي يحظون بثقة عالية واحترام كبير” بين عموم الناس، “ولا سيما في الأيام التي يبرز فيها أثر فساد النظام وتشتد الضائقة على المواطنين”.
بيد أن السحر ذاك مقصور على دوائر محدودة نسبيا ويتصف بسهولة التبدد. يخرج المعتقل من السجن حاملا “رأسمالا رمزيا” مهما، لكنه ضعيف المرونة: يتبدد فور استخدامه، وشرط بقائه هو أن لا يُستخدم. فالمعتقل الذي يستخدم رأسماله لنيل أفضليات خاصة، مادية أو عاطفية، سرعان ما تتدهور قيمة رأسماله. والمعتقل الذي يتوقع أن تحبه النساء، أو يبيح لنفسه الاستفادة من رأسماله الرمزي لصيد النساء، يتبهدل بسرعة. والمعتقل الذي يكثر من الكلام على ما قاساه في السجن يجازف بأن يثير نفور الناس منه.
والواقع أن هناك دافعا غير مدرك عند المعتقلين السابقين كافة لتطلب رعاية خاصة من الآخرين أو للاستفادة من وضعهم كمعتقلين سابقين. السجن في أحد وجوهه رحم حنون يلقى السجين فيه عطف وعناية أسرته وتقدير معارفه إن كانت الزيارة ممكنة (وفي وجه آخر هو رحم يابس لأم قاسية، يخنق السجين ويضغط عليه، وقد يقتله). لذلك، كل سجين دون استثناء، يحمل نزوعا لا شعوريا للبقاء في السجن أو للاستفادة من ميزات الحياة السجنية المناظرة للحياة الرحمية. قد يتجلى ذلك في تذكير مستمر بأنه كان في السجن، أي في مبادرة السجين إلى سجن نفسه في صورة السجين السابق. لسان حاله يقول: أحبوني! اهتموا بي! اعتنوا بشؤوني! “احترموا نضالي”! لقد قضيت كذا سنة في السجن! ولقد تعرضت لكذا وكذا من التعذيب! ثمة شيء من الطفالة في ذلك، يمنع السجين من أن يكبر. كأنه يرفض الخروج من السجن، أو يحتج على هذا الخروج. إن الشخص الذي يختزل نفسه إلى سجين سابق يفشل بالفعل في أن يعيد تأهيل نفسه لحياة جديدة وتاريخ جديد. وكم هو شائع في أوساطنا، نحن معشر السجناء السياسيين السابقين الناجين، الحنين إلى أيام السجن التي تكتسب شيئا من البريق بعد أن تنأى عنا[7].وقد يبدو غريبا، إذن، أنه، رغم انشدادهم إلى السجن، لم يكتب السوريون سجنهم. هذا ربما لأنهم لم ينفصلوا عنه، أو لا يريدون الانفصال عنه. فلكي نكتب عن السجن لا يكفي أن نخرج منه، ينبغي أن نتحرر نهائيا من الحنين إليه ومن دافع الاستفادة منه كما قد يستفيد مريض من مرضه. إننا لا نكتب السجن، ما يقتضي أن ننفصل عنه، لأنه لا يزال مشروعا نفسيا أو معنويا، أو حتى ماديا، رابحا. ولعل الانفصال عن السجن غير ممكن دون أن ينال السجناء حريات وحقوقا مادية ومعنوية تساعدهم على إدارة ظهورههم للسجن. إن المعنى السياسي لذلك هو انطواء صفحة النظام السياسي الحالي، المحروس بالسجن، واقعا وفكرة ومنعكسات شرطية.
ليست قليلة، أخيرا، نسبة السجناء السابقين “المتحررين من الأوهام”، أي الذين ينظرون إلى ماضيهم السياسي بسلبية أو حتى بازدراء. بعد خروجه من السجن، لم يكتف غ. خ بقطيعة مطلقة مع رفاقه السابقين وكل ما يذكر بنشاط شبابه، بل قاطع شقيقته التي أحبت ثم تزوجت معتقلا سياسيا سابقا. بعض المعتقلين السابقين جعلوا من موقفهم هذا قضية عامة و“رسالة” شخصية لهم، وأخذوا يهاجمون أحزابهم أو النشاط المعارض ككل، ساعين إلى كسب أناس آخرين لهذا الموقف.
مبادرات حقوقية
رغم أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة الحقوق المدنية إلى المحرومين منها بنود ثابتة على أجندة العمل الديمقراطي في سوريا في السنوات الأخيرة، بل منذ أضحت قضية الاعتقال السياسي قضية وطنية في أواخر السبعينات، إلا أنه ليس ثمة نشاط منظم أو هيئة مستقلة معنية بقضايا المعتقلين السياسيين السابقين في سوريا. ثمة مبادرات، تُقصِّر عن مخاطبة القضية في وصفها قضية سياسية ووطنية ومستقبلية، وليست محض قضية إنسانية تتصل بمعالجة مظالم جرت في الماضي. بل نميل إلى الاعتقاد بأن الحضور الحقوقي البحت لقضية المعتقلين السابقين ما انفك يحجب الحاجة إلى مقاربتها معرفيا ومعالجتها سياسيا.
من أهم المبادرات تلك عريضة وقع عليها 387 معتقلا وملاحقا سابقا، قدمت إلى السلطات في عام 2005، تتضمن المطالب التالية:
1- “إلغاء آثار الأحكام الصادرة عن كافة المحاكم بحقنا وإعادة الاعتبار لنا.
2- التعويض المادي لكل منا حسب سنوات اعتقاله، سواء كان موظفاً أم غير موظف عند اعتقاله. وحساب سنوات السجن وما بعدها سنوات خدمة فعلية، على أن يشمل ذلك المفصولين من عملهم بعد إطلاق سراحهم.
3 ـ إعادة من لم يعد إلى عمله الذي كان له قبل الاعتقال، وإيجاد عمل للسجناء الذين لم يكن لهم عمل عند الجهات الحكومية قبل الاعتقال، ويرغبون في ذلك.
4 ـ اعتبار سنوات الملاحقة الأمنية بمثابة سنوات اعتقال ومعاملتها بالمثل.
5 ـ إلغاء قرارات السوق إلى الخدمة الإلزامية الصادرة بحق كل سجين اعتقل أو أجلت خدمته دون إرادته، وتسريح من سبق سوقه إلى الخدمة من هؤلاء.
6 ـ منح جوازات سفر لكل السجناء السياسيين السابقين، وإزالة جميع إجراءات منع السفر والمغادرة الصادرة بحق أي منهم، وإلغاء الإجراءات الأمنية التي تمنع ذلك”[8].
إن الأسماء الواردة في قائمة الموقعين على العريضة هي لسجناء أو ملاحقين سابقين لحساب تنظيمات شيوعية أو ناصرية أو التنظيم البعثي الموالي للعراق. وهي تخلو من معتقلي الإسلاميين، وقد كانوا أكثرية المعتقلين السياسيين في سوريا. وقد يكون هذا، وطغيان الطابع الحقوقي على حساب الطابع السياسي والوطني للقضية، هو السبب في امتناع معتقلين يساريين آخرين عن التوقيع على العريضة. وجدير بالذكر أن المعتقلين السابقين الذين قضوا خمس سنوات فما فوق لا يستدعون إلى الخدمة العسكرية في سوريا. وكان معتقلون قضوا أقل من 5 سنوات قد نالوا تأجيلا إداريا متكررا من الخدمة العسكرية ايضا، لكن بعضا منهم استدعي خلال عام 2005، وسيق إلى الجيش، وبعضهم في أربعينيات أعمارهم. جدير بالذكر أيضا أن بعض المعتقلين السابقين لم يحصلوا على جوازات سفر، فيما حصل عليها آخرون، دون أن يكون ثمة قاعدة مطردة دوما وراء هذا التمييز.
وكانت اللجنة التي صاغت العريضة السابقة قد تلقت وعودا بحل المشكلة قبل أيلول من عام 2005، لكن شيئا من ذلك لم يحصل. ويبدو أن القضية ماتت، بعد أن كانت اللجنة قد ظنت أنها حصلت على وعد برفع الحرمان عن الحقوق المدنية عن المحرومين، وأشيع وقتها أن السلطات وعدت بمنح كل منهم 100 ألف ليرة سورية (أقل بقليل من 2000 دولا أميركي) عن كل عام قضوه في السجن، كمساهمة منها في إعادة تأهيلهم من جهة، وعملا على طي الملف من جهة أخرى.
ولم يحلّ بعد مكان هذه المبادرة نشاط آخر متمحور حول العون المتبادل والتوجه إلى المجتمع، لحل المشكلة بدلا من التوجه إلى السلطات. وقد يكون السبب المهم وراء ذلك هو الصراعات والمنافسات الحزبية التي لطالما كانت مصدر إفساد وتسميم للعمل العام في سوريا. كذلك افتقار السوريين إلى تقاليد وتجارب في التكافل الاجتماعي غير الخيري وغير القائم على أسس دينية. بالنتيجة، بقي الجانب العام من قضية المعتقلين السابقين محتكرا من قبل أحزابهم غير القادرة على مساعدتهم فعليا. أما الجانب الخاص فلا يزال واقعا على عاتق أسرهم. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام سعيهم إلى البحث عن حلول شخصية كيفما اتفق.
في كتاب مفتوح وجهه إلى رئيس الدولة في مطلع عام 2006 الحالي، يقول معتقل سابق، اسمه جابر سلمى، مكث في السجن فترة ما بين 1987 و1994، وجرد من حقوقه المدنية على يد محكمة أمن الدولة العليا التي مثل أمامها بعد خمس سنوات من توقيفه، وحكمته ست سنوات، يقول: “أتوجه إليك يا سيادة الرئيس بإعطاء الأوامر لهم [مديرية التربية في محافظة اللاذقية] ليسرعوا في إعادتي إلى عملي عملا بقاعدة إن كنت مظلوما لرفع الظلم عني، وان كنت مسيئا فرأفة بأسرتي وأطفالي. وكلي ثقة انك لن تخذلني وشكرا سلفا”. قبل اعتقاله كان سلمى معلما. وكي يقنع الرئيس بسلامة طويته، يبلغه: “يهمني يا سيادة الرئيس أن أوضح أن كأس عرق عندي أهم من كل سياسة الأرض، وأن وضعي اليائس يدعوني إلى التفكير في الانتحار”. ويؤكد انه ترك الحزب اليساري الذي كان ينتمي إليه منذ عام 1984، أي ثلاث سنوات قبل اعتقاله. ويبدو أن سلمى اهتدى إلى هذا الحل لأنه لم يجد غيره. يقول: “ومع أنني وضعت نفسي تحت تصرف مديرية التربية إثر خروجي من السجن إلا أن الحكم [حكم محكمة أمن الدولة عليه بالسجن 6 سنوات] حرمني من العودة إلى عملي مثل رفاقي الذين لم يحكموا. منذ ذلك التاريخ بدأت غربتي داخل وطني، فلقد بعت كل العقارات التي أملكها في قرية القنجرة [التابعة لمحافظة اللاذقية] من اجل تسديد نفقات أسرتي ومنهم من أصبح جامعيا، وعملت بعدها عامل حفريات مياوم، ومن ثم عامل حفر في تمديد مجاري الصرف داخل قريتي، ولا أزال أعمل يوميا عامل حفريات، رغم كبر سني، حتى كتابة هذه السطور”. سلمى من مواليد [9]1958.
هذه شكوى رجل خرج من السجن منذ عام 1994. وهو ليس استثناءا. إن من لم يسمح لهم بإكمال دراساتهم العليا أو بالحصول على وظيفة أو بالسفر خارج البلاد هم أكثرية المعتقلين.
ثمة عدد محدود جدا من الحالات نالت دعما من منظمة العفو الدولية للقيام بعمليات جراحية مكلفة أو لعلاج باهظ الثمن (أورام خبيثة بصورة خاصة). على أن النسبة لا تكاد تذكر. بالمقابل تلقى عدد محدود أيضا دعما ماليا من رفاق لهم خارج البلاد. لكن النسبة أيضا لا تكاد تذكر، ولعلها كذلك لا تستند إلى معايير الحاجة الحقيقية.
[1]كتبت هذه المادة في مطلع عام 2006. وبعد كتابتها تغير الأمر. ففي شهر أيار اعتقلت السلطات عددا من المعتقلين السابقين: فاتح جاموس الذي سبق له انه قضى 18 عاما في لسجن (أفرج عنه في تشرين الأول 2006)، ميشيل كيلو الذي سبق له أن اعتقل في مطلع الثمانينات لمدة تنوف على عامين، علي العبد الله، خليل حسين، محمود عيسى، علي الشهابي... ولا يزال كيلو وعيسى والشهابي معتقلين اليوم، أواسط شهر تشرين الثاني 2006.
[2] لعل بعض السبب في ذلك يعود إلى أنهم تعرضوا لقمع غير متناسب على الإطلاق مع “جرائمهم” ضد النظام: لم تنزف قطرة دم واحدة من أهل النظام أو من عموم السوريين على يد سجناء يساريين، فيما قضى مئات منهم سنوات طوال في السجون، وتعرضت أكثريتهم للتعذيب، وقتل بعضهم تحت التعذيب. جدير بالذكر أن جميع من أعيد اعتقالهم من المعتقلين السابقين (الهامش السابق) لم يكن السبب المباشر لاعتقالهم تجدد نشاطهم الحزبي.
[3]أكملت السلطة إعادة احتلال حيز التجمع العلني والمستقل بالكامل في أيار 2005 حين أغلقت منتدى الأتاسي، ونزعت إلى الإجهاز على حيز التعبير الحر عن الرأي في أيار 2006 حين اعتقلت عشرة من الموقعين على إعلان بيروت - دمشق، وآخرين..
[4]منهل السراج: كما ينبغي لنهر، الطبعة الأولى، الشارقة، 2004. والرواية ممنوعة الطبع والتداول في سوريا، وقد استعنت بنسخة إلكترونية منها.
[5]بالمناسبة، ليس قليلا عدد السجناء السابقين الذين لم ينجبوا لارتفاع نسبة الإصابة بدوالي الحبل المنوي، وهو من أهم أسباب العقم لدى الذكور.
[6]من مشاركتها في حلقة برنامج “أدب السجون” الذي بثته قناة “الجزيرة” في أواخر عام 2005. ونشرت روايتها الأولى، “شرنقة”، عن حياة سجينات يساريات في سجن “دوما” عام 1999.
[7]على أنه لا “يحن” إلى السجن إلا من لم تحطمهم تجربة السجن. حنينهم هو احتفال مقنّع بنجاحهم في تحمل السجن والنجاة منه. وفيه جرعة من رياء.
[8]http://www.rezgar.com//debat/show.art.asp?t=0&aid=31306
[9] نشرة “كلنا شركاء” الإلكترونية all4syria.org، 17/1/2006. موقع النشرة محجوب في سوريا، لكنها تصل إلى مشتركين في البريد الإلكتروني.
العلاقة بالشأن العامFONT>FONT> DIV>




