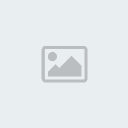
تبدو
فرضية فصل الإسلام عن حركات الإسلام السياسي مغرية٬ لأنها تمكّننا من سحب
البساط المزيّف من تحت أقدام هؤلاء الذين يهدفون إلى السطو على المعتقد
الديني للشعب٬ بنوع من نزوة التملّك القريبة إلى الخصخصة التمثيلية لسلطة
الفقه والفقهاء بدل سلطة الدولة. فعندما تبني حركة سياسية وجودها انطلاقا
من الدين٬ فهي تتمكن من السيطرة على امتياز ثقافي اجتماعي ديني يجعلها في
وضعية المالك للرأسمال الديني الثقافي والاجتماعي الشعبي٬ وبالتالي فهي
بشكل أو بآخر تشبه الكنيسة التي تمنح وصمة المؤمن والكافر٬ كما تمنح
التوبة وصكوك الغفران بمعنى محاصرة وإرهاب الآخر من نفس الدين وغيره
كمختلف٬ أي كسؤال وفكر نقدي أو كاثنية وطائفية ومذهبية…وعزل هذا الآخر
بلغة فساد الزمان في زاوية التمييز والتكفير٬ بلغة العنف الرمزي والمادي٬
كإلغاء وإقصاء ليس فقط من الوضعية الاندماجية المجتمعية٬ بل أيضا إلغاء
كينونته الإنسانية٬ إذ يحلّ دمه لأنه ببساطة كفر وابتداع أنتجه تدهور
الزمان وانحداره٬ فهو شرّ تستوجب الفريضة والواجب الديني التخلص منه. لكن
هذه الفرضية تبدو من جهة أخرى هشّة حين نستحضر الواقع كاجتماع وتاريخ٬ أي
أنّ هذه الحركات الإسلامية تتوالد بنفس الطريقة المنتجة للدين الإسلامي
كتركيب ديني ثقافي اجتماعي تاريخي بين الوثنية واليهودية والمسيحية٬
وكتراث إبراهيمي متنوّع ومتعدّد الروافد. نعم الشيء نفسه بالنسبة لحركات
الإسلام السياسي التي تناسلت عبر التاريخ العربي الإسلامي٬ كولادات مركبة
توفيقية من الأرضية الثقافية الإسلامية٬ حسب شروط وظروف تطوّرها وتلقحها
بمعطيات الشعوب الأخرى٬ الفارسية والبيزنطية والفرعونية والأوربية…وصولا
إلى العصر الحديث والمعاصر٬ حيث جدلية الإضافة والتعديل والحذف تفعل فعلها
التاريخي. فكانت كل حركة سياسية إسلامية تنظر إلى نفسها كتركيب سلفي شرعي
نهائي٬ بما يقارب مفهوم ختم النبوة بمعنى أنّ ما يسمّى بختم ونهاية النبوة
أخذ امتداده وتبلوره في نظر كل حركة إلى نفسها باعتبارها الحدّ النهائي
والختم المطلق للحقيقة الوحيدة الصحيحة والنهائية٬ وما عداها مجرّد حركات
إسلامية تحريفية مشبوهة من السنّة والشيعة والخوارج…دون الحديث عن باقي
الأحزاب العلمانية واليسارية.
وهذا المعطى
التاريخي الاجتماعي يجعلنا أمام طبقات من الإسلام بصيغة الجمع٬ كتنوّع
وتعدّد واختلاف. كل مرحلة تاريخية تناقض ما قبلها٬ وكأنها تؤسس وجودها
بناء على وهم الشرعية التاريخية والدينية٬ تمثلا بما حدث في أسطورة
السردية الدينية الإسلامية لمرحلة النبوة وما تسميه الخلافة الراشدة. وقد
خرج رجل في قومه وهو الأمين العام لحزب النهضة معتمرا عمامة ومرتديا رداء
أشبه بلباس خلفاء المسلمين قائلا: «يا إخواني أنتم الآن أمام لحظة
تاريخية، أمام لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة في الخلافة الراشدة
السادسة إن شاء الله، مسؤولية كبيرة أمامنا والشعب قدم لنا ثقته، ليس
لنحكم لكن لنخدمه». حركات سياسية تنكر ما بعد هذه المرحلة باعتبارها
انحرافا عن التجربة الذهبية٬ في حين ترتكب حماقة تناقضية وهي تقرأ أو تنظر
وتحلم بالماضي الذهبي٬ من خلال ما أسسه تراث المابعد حول المرحلة المجهولة
والمعتمة من تاريخ الإسلام. المتلقي أو الأتباع هنا مطالبون بالإيمان
/الطاعة وهم يستمعون إلى الأسرار الإلهية فيما يشبه الوحي، فالرجل يدرك
أنه منذور للخلافة السادسة في هذه اللحظة التاريخية الربانية.
قليلا
ما يتم الانتباه في مسألة فصل الدين عن الدولة إلى أن المطلوب هو فصل
الإسلام عن الإسلام السياسي٬ بمعنى أن الصراع الإيديولوجي مع حركات
إيديولوجيا الإسلام ملزم بالاحتياط واليقظة من الصراع اللغوي الاجتماعي
الإيديولوجي٬ لأن هذه الحركات تتكئ كثيرا على المسألة اللغوية في فهمها
وتفسيرها ورؤيتها٬ فهي تشترط في أدبياتها القديمة والحديثة التمكن اللغوي
لاستحقاق جدارة العلم والفقه والثقافة والاجتهاد. لذلك فإن أغلب المعارك
التي تكسبها هي بالأساس لغوية خطابية٬ وليست اجتماعية سياسية واقتصادية٬
أي تستعمل تحليلها اللغوي الإيديولوجي كمطية سهلة في إتقان بيان الإعجاز
لتحريك القلب وليس برهان العقل. فطرح القوى السياسية والمعرفية الثقافية
النابعة من حركة تطور الواقع التاريخي الاجتماعي، مثلا مسألة فصل الدين عن
الدولة، تتخذها ذريعة لتمييز المواطنين إلى مؤمنين بشرع الله٬ أو بتعبير
ابن تيمية ولاية شرع وإلى الكافرين به المناصرين للقانون الوضعي البشري٬
أي ولاية حرب٬ وفي ذلك تكمن سياسة التخويف بتهمة الكفر٬ وما يترتب عنها في
المجتمع المسلم. إنها سمسرة خبيثة تمسّ العمق الإنساني بالمتاجرة السياسية
في ما يعتبره الإنسان حميما وخاصا٬ أو في الإجهاز على حق المواطنة للآخرين
وللذين يسمون أيضا بالمسلمين وليس المؤمنين. وليس صدفة أن يركز أركون في
بحوثه ودراساته للفكر الإسلامي على المقاربات اللغوية والألسنية
والسيميائية٬ والشيء نفسه بالنسبة لنصر حامد أبو زيد الذي يرى في القران
نصا لغويا أدبيا٬ فالباحثان المفكران يدركان خطورة سطو المقدس على
التاريخي الاجتماعي في اللغة وتوحيد الفكر والدين٬ وبالتالي انتصار
المتعالي الإلهي كشكل سياسي اجتماعي على حساب الدنيوي الإنساني٬ بمعنى أن
يكون السيف / السلطة السياسة تابعا للكتاب/ العلماء الذين يعتبرون أنفسهم
أعظم الناس وأشرفهم، لأنهم حاملون للعلم الحاكم كما يقول الشاطبي. ومن ثمة
فأساس الشريعة الإسلامية هو حكم الله. فالمسلم يجد نفسه مورطا في صراع
يقمع رأيه بالمرصاد ولا يترك بصيص أمل لأفق انتظار المتلقي النقدي إزاء
حديث مثلا لابن عباس أو ابن هريرة أو عائشة…متبوعا بعبارة (رضي الله عنه
أو عليه السلام )،هذه العبارات صارت إيمانية قدسية كوحي منزل في اعتقاد
المسلم فتلغي أي تعامل عقلي نقدي تساؤلي وتفرض القبول والطاعة والإخضاع
والإكراه. فلغة المسلم اليومية مسكونة بالمقدس في الجلوس والحوار والبيت
والمدرسة وفي أدب الطعام والنكاح والتبرز…
يرى
هيدجر بأن اللغة مأوى الإنسان ومسكنه، وإذا كانت شعوب العالم تسكن لغتها
فإن المسلم الذي يعرف بأن إلهه الذي علّم آدم الأسماء كلها٬ ليس كمثله
شيء٬ ولا حيز له في المكان والزمان٬ قليلا ما ينتبه إلى أن إلهه يسكن لغته
فيبدو الإنسان مشردا شريدا لا وطن له. إنه في وضعية اللاجئ الذي هجر قسرا
من بيته٬ فهو في وضعية المطرود على عتبات المكان وفي تخوم فساد الزمان
المنحدر. في وقت تسكن الشعوب لغتها أوطانها٬ فالمسلم يسكنه إلهه يقف على
حافة اللسان عوض أن يسكن الإنسان إليه. فإذا كانت اللغة مؤسسة اجتماعية
تاريخية بتعبير اللسانيين٬ فهي عندنا دينية وقفية لاهوتية تقصي الواقع
والإنسان٬ وتبعده من دائرة الكينونة والفعالية الوجودية في العيش والتفكير
والإبداع والاجتهاد (لا اجتهاد فيما فيه نص)…كشكل سياسي اجتماعي تاريخي
للتحكم في الدنيا باسم الله٬ كصراع سياسي معرفي فقهي للسيطرة على السلطة
السياسية٬ بالتغلب أو بما يسمى المعرفة العلمية الفقهية أو بهما معا. إن
مسالة فصل الدين عن الدولة لا ينبغي أن تناقش بشكل مجرد٬ فالمتورط هنا في
هذه الإشكالية هو طرف سياسي يستغل المعتقد الديني الإسلامي لأغراض سياسية
دنيوية٬ مندسا وراء ما يسميه الهوية والمرجعية٬ وولاية الشرع جاعلا من
تفكيره وسلوكه ونشاطه الختم النهائي لمطلق الحقيقة الإلهية الضامن للحل أي
الإسلام. من هنا تبرز ضرورة النضال الإيديولوجي للفصل بين الدين وهؤلاء
الذين يسمون أنفسهم إسلاميين٬ بنوع من الوحدة الواحدية القريبة من التوحيد
الإلهي كاستبداد شمولي بشري٬ والملغية للتعدد حتى داخل نفس المعتقد بين
الشيعة والسنة…وعندما نتأملهم محليا وعالميا نجدهم كحركات سياسية تعد ولا
تحصى٬ مما يجعلنا أمام تراث من التشتت والتشرذم والفرق الناجية والقبلية
السياسية الدينية كفعل طبيعي لإسلامات التاريخي والاجتماعي٬ فتسقط بذلك
مفاهيم الوحدة والانسجام والتناغم المتضمنة قسرا في قولنا الإسلام
السياسي٬ بمعنى أننا إزاء إسلامات سياسية متناقضة ومتقاتلة فيما بينها عبر
تاريخ المجتمع العربي والإسلامي.
وبحثنا
عن هذا الفصل بين قوى الإسلام السياسي والإسلام٬ كغيره من المعتقدات
الدينية٬ يشكل المدخل لضرورة دراسة سيكولوجية الانفصال التي تعاني منها
قوى إسلامات السياسي٬ كنوع من فوبيا الحياة التي نجد أساسها فيما يمكن
تسميته بنظرية التعلق بين المسلم ونصوصه المقدسة كمتخيل أسسته المصادر
العربية الإسلامية. فالديانات التوحيدية خاصة الإسلام تؤسس لنوع من التعلق
بين الإنسان والإله٬ هو أشبه بالتعلق الحاصل بين الطفل والأم٬ الشيء الذي
يجعل المسلم يعيش قلق الهجر النفسي الذي يؤثر سلبيا على استقلال الإنسان٬
ويجعله في وضعية تبعية عبودية احتلالية لوطنه- لغته- يستحيل أن يعيش حريته
وانطلاقته الوجودية كحياة بشرية (إن ولادة الحرية وتبلور مقولتي الحرية
والتفكير الشخصي غير الإملائي ليست مكتسبات سهلة المنال بل هي معطيات
عسيرة التبلور لأنها رهينة بتحولات سوسيولوجية وبتحولات فكرية عميقة. تمثل
فكرة الحرية واستقلالية الفرد عمليتين عسيرتين وطويلتي الأمد. ويتزايد عسر
وعناء هذه العمليات عندما يتعلق الأمر بمجتمع لا يتطور ذاتيا وتلقائيا بل
بفعل قوى ومؤثرات خارجية يختلط فيها التحول بالرضة وتعاش فيها الحداثة
كصدمة وتقترن فيها صدمة الحداثة بصدمة الاستعمار مع ما يتولد عن ذلك من
ردود فعل ذاتية وانبعاث قوى التقليد. فكرة الحرية الشخصية هذه لم يكن من
اليسير تقبلها من طرف الثقافة العربية الحديثة إذ فهمت الحرية الفردية على
أنها مروق واستهتار وخروج عن المقدسات (محمد سبيلا)، لذلك نفهم عسر انبثاق
الديمقراطية من داخل هذه الحركات لأنها – أي الديمقراطية – كسيرورة صارعت
ضد العبودية والرق والاستغلال طويلا ولا تزال عبر التاريخ الإنساني
انطلاقا من التجربة في أثينا إلى اليوم. فكيف لنص ديني كمرجعية إلهية لا
تحرم العبودية والرق أن تؤسس لولادة الإنسان كحرية ومساواة وديمقراطية ؟
فحياة المسلم ملغمة بالكثير من عناصر الخوف والتسلط والاستحواذ والتملك في
الصحة والمرض، وفي الحياة والموت والغنى والفقر…وفق مفاهيم لاهوتية تحرمه
الفعل والإرادة والاستقلالية والمسؤولية والتحكم في المصير، كمشكلات
سياسية اجتماعية تؤسس للحرية السياسية والحرية الدينية…يجد نفسه تحت
عذابات وضعية القهر والهجر النفسي، فهو ملزم بإعلان ولائه وعبوديته لله
والتنكر لحقه في الحياة (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم). وحرمانه من
الاستقلال والحرية والكرامة الإنسانية، وذلك خوفا من غضب الله، وخوفا من
الطرد والنبذ والهجر٬ وبالنتيجة السخط والعقاب المادي والمعنوي في الدنيا
قبل الآخرة كمرتد وكافر وجاحد لنعم الله. إنه لا يستطيع أن يخطو خطوة بدون
ضغط قلق الهجر الذي يفجره النص الديني كسردية دينية منذ آدم. وبالتالي فهو
في متخيله النفسي الديني يعيش هذا العذاب كجهاد اصغر في سبيل الله ضد
الأخر، أو كجهاد اكبر ضد نفسه وذاته وجوارحه التي تتآمر ضده وتتحالف مع
عدوه الشيطان. إنه في وضعية طوارئ قصوى لجعل ولاية الحرب تابعة لولاية
الشرع، أو بعبارة أخرى جعل الدنيا السيف تابعة للدين الكتاب، أي سلطة
الفقه والفقهاء الممثلون لحكم الله. فرغم أن النص الديني يتضمن صراحة
تكسير الجسور بين السماء والأرض، ونهاية تواصل الرسالات، إلا أن لغة
النهايات ليست من طبيعة قبلية كتجربة تأسيسية في مكة والمدينة، بل هي من
طبيعة إمبراطورية المتجاوزة للتشتت القبلي، مما يجعلها قريبة إلى حد ما من
المرحلة الأموية والعباسية. وهي وإن كانت تحمل معاني لاهوتية، فإنها تجد
نفسها إزاء التاريخ البشري كتعبير شمولي كلياني، باسم المقدس لإعطاء شرعية
للسطو على الأرض كواقع اجتماعي سياسي، من خلال الانفراد بالحقيقة الصحيحة
والناجزة والنهائية. فلغة النهايات لا تكف عن تفجير قلق النهاية كموت أو
كقيامة، الشيء الذي يزيد من تعمق قلق الهجر الذي تعرض له الإنسان في
السردية الدينية لخلق الكون والإنسان٬ باعتباره المذنب المطالب بالتوبة
كتأثيم ذاتي يرهق الإنسان المسلم أمام تناقضات الاجتماعي والسياسي
والتاريخي كحياة بشرية لا يمكن أن تكون مثالية كالجنة٬ فهي ليست أكثر من
دار العيب والغرور والفتن كلذة وملذات في الدار العاجلة المؤهلة للدار
الخالدة الحقيقية والمعقولة. فمسؤولية الإنسان في النص الديني ليست سوى
عقاب على الخطيئة التي اقترفها٬ فهي مسؤولية مولدة لعقدة الذنب والهجر أي
قلق السفر في الحياة. وهذا ما يفسر حالة من الخوف العميق من الحداثة ومن
الفرد والانطلاقة الرحبة في الحياة على مستوى اللباس والسكن والثقافة
والعادات والتقاليد والطقوس والفرح والضحك…وهذا ما ينتج ثقافة الرعية
والجمهور التي تتمثل صورة الأب والمسؤول والله، كحاكمية بحكم الله أو بما
انزل الله، لا فرق بين تعبيرين تختبئ فيهما قوى الإسلام السياسي(احتمينا
بالنصوص فدخل اللصوص بتعبير حسن حنفي). وفي هذا السياق ليس صدفة أن ينتج
التراث الإسلامي مفاهيم الخلافة وظل الله في أرضه، والعلماء ورثة
الأنبياء، والإمام المعصوم، والمهدي المنتظر…حاكمية تحقق التوازن المؤقت
النفسي والاجتماعي الهش، وتزيل الاضطرابات الانفعالية وتوترات النبذ
والهجر بشكل مؤقت. لأن للتاريخي والاجتماعي قوانين وديناميات سرعان ما
تنزل بثقلها كتناقض مجتمعي إنساني في وجه التدبير النفسي الثقافي والسياسي
الاجتماعي للمجتمع المسلم٬ من خلال المقاربة اللاهوتية، مما يؤدي إلى
إعادة إنتاج وضعية قلق الهجر كوسواس قهري يطحن ويسحق الإنسان بطريقة لا
رحمة فيها. إن الإنسان المسلم هو ضحية أنا أعلى ساد ومرعب وقاهر ومولد
لعقدة الذنب وجلد الذات والهجر بناء على جدلية الطاعة / العقاب حيث الطاعة
تفترض القرب والولاء والرعاية والحماية والحق في الغنيمة والجنة…أما
العقاب فهو نتيجة الشك والإبداع والسؤال والرفض والتمرد…
فالأرضية
الدينية الثقافية الإسلامية تشتغل بمفاهيم الخوف، وبآليات القوة كمعاني
ودلالات أنتجها شرط اجتماعي تاريخي٬ يرى في العزم والحزم والفحولة نوعا من
القوة المستبدة المدعمة لعملية تنفيذ الفكرة والرأي والقرار. من هنا ولد
تراث أدبي سياسي يمجد مفهوم المستبد العادل الذي لا يكتفي بفرض قراره
بمنطق العقل، بل يسنده منطق القوة بحد السيف. لذلك سادت في التجربة
الإسلامية السياسية مفاهيم الشوكة والعصبية والغلبة…
قلق
الهجر عند المسلم يضاعف من مأزم التعلق بالماضي وبالقوة الإلهية، إلا أن
استحالة التواصل مباشرة معها يدفع نحو تشكل ذهني إيماني ثقافي بضرورة
المستبد العادل- الزعيم والإمام والبطل والقائد… - القادر على رفع الظلم
والحيف٬ ونصرة الضعيف وحماية الفقير والاعتناء بالمريض…وفي هذا التبلور
الذهني والبناء لشخصية المسلم تبرز إوالية المسلم الضحية٬ فهو يشعر طوال
حياته بأنه مستهدف من الطبيعة ومن الآخرين. لغته اليومية لا تكف عن حشره
في زاوية الأشياء العمياء حيث يتحول إلى مجرد الشيء الضحية الذي يعتدى
عليه من طرف = المطر والثلج والتكنولوجيا وحوادث السير والشياطين والجن
وعيون الناس والنصارى واليهود وجميع الكفار…وبالتالي المسلم الضحية لا
يخطئ ولا يعرف أخطاءه التي تتطلب التصحيح والنقد، لأنه ببساطة ليس مسؤولا
في حياته عن حياته وتقرير مصيره، فهو متروك للقضاء والقدر والمكتوب
ولعقوبة سجود السهو في المسجد والبيت والمدرسة…كتكرار قهري. فهل يمكن
الحديث انطلاقا من الأرضية الثقافية الإسلامية عن الفرد والحرية والاختيار
؟ (أن نمارس حريتنا هو أن نعمل على تفكيك آليات عجزنا لتغيير قواعد اللعبة
بتشكيل عوالم ومجالات وابتكار أساليب ولغات أو اختراع وسائل وأدوات أو خلق
موارد وفرص تحدث تحولا في الفكر وتسهم في تغيير الواقع بقدر ما تملك هي
نفسها وقائعيتها . علي حرب. )
لذلك نرى أن
الإنسان المسلم مسكون بهاجس ورغبة العيش٬ في كنف المستبد العادل الذي يخاف
الله رب العالمين (المشروع المجتمعي الأخروي الذي قدمته النهضة التونسية…)
أو بتعبير أدق يخاف من الحساب العسير، المتمثل في الجحيم كضمانة لصلاح
الدنيا ونيل النصيب المستحق منها. وهل يمكن لثقافة الخوف أن تنظم
المجتمعات وتكون ذهنية وشخصية سوية واعية ومسؤولة تملك حريتها كتحديد ذاتي
تحترم وتطيع وتعاقب نفسها أمام القانون الذي شاركت في صنعه، أي تحكم
بنفسها كصورة مصغرة للديمقراطية، وتصنع مصيرها ومستقبلها أم أن النتيجة
مجرد إنسان في صورة شيء٬ عبارة عن ضحية ومستهدف ومعتدى عليه ومتآمر ضده من
قبل الطبيعة والآخرين والشيطان…؟ وتلك الثقافة الدينية كإوالية تزيينية
تجمل له واقعه البئيس، كامتحان وابتلاء من الله أو كعقاب على ابتعاده عن
التعاليم الإسلامية. فبنية التعلق بين المسلم وربه تفجر قلق الهجر، من هنا
تكتسب مفاهيم نفسية دينية ثقافية – الغربة (بدأ الإسلام غريبا وسيعود
غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء…) والهجرة…- عمقها الوجودي والاجتماعي
السياسي، كأرضية ثقافية إسلامية لا تكف عن الهجرة في سبيل الله، بتجليات
مختلفة كجهاد أو دعوة أو هروب من اللعنة التي مست الإنسان ومكان عيشه
بفساد الزمان. فلا داعي للإشارة إلى هذا التراث الثقافي والاجتماعي المبجل
والمقدس للغربة والهجرة، كعشق جنوني ديني في السيطرة والحكم والتحكم
بالسيف من وراء شرع قيل عنه حكم الله…هل يمكن القول إننا أمام هاجريين
جدد؟ كما قال الخليفة الأمين العامّ «حضور الأخت من فلسطين هذه إشارة
ربانية، من هنا ينطلق بعون الله فتح القدس إن شاء الله، من هنا بدأت
الثورة العربية ومن هنا انتصر الشعب التونسي ومن هنا الفتح بعون الله،
تأكدوا إخواني». لعل الاستشراق الانجلوسكسوني الجديد الذي تناولته آمنة
الجبلاوي في كتابها الإسلام المبكر كان يقصد هؤلاء الهاجريين الجدد الذين
لم تعد مكة في نظرهم تحتاج إلى فتوحاتهم لذلك يلتقطون الإشارات الربانية
وينفذون وعد الله، إن وعد الله حق




