الإسلام السياسي العربي شحنات سالبة تستوجب التأريض؟
الاحد 15 كانون الثاني (يناير) 2012
بقلم:
عماد يوسف
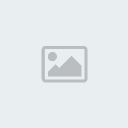
التاريخ
حركة متبدّلة، لا تقف عند حدود الواقع. بل تتجاوزه إلى حدود اللاممكن في
بعض الحالات. فحركة التاريخ قد تُفاجئنا في لحظة ما تصنعُ فيها تحوّلات
دراماتيكية عنيفة. فينقل مجتمعات، أو دول، من حالة ستاتيكية مُفرطة، إلى
حالة من الحركة المتجددة. قلّما جانبت التاريخ يوماً حقيقة النظرّيات
الكثيرة التي حاولت تفسيره أو إعطاءه مدلولات لصيرورته واستمراريتها، سوى
ما تحَّدث منها عن المطلقات الغيبية، والكونية. فيما عدا ذلك، نجد أن
التاريخ لم يُنصف ماركس وكذّبه في نظريته الشهيرة. ولاحقاً دحَضَ نظرية
فوكوياما في إعلانه نهاية التاريخ. فالتاريخُ متبدّل، متغيّر، ومتحوّل.
وهذه يُمكن توصيفها بأنها مُطلقات.
تزيد التطوّرات العلمية
المعاصرة، "أهمها ثورة المعلوماتية"، حركة التاريخ وتقوّيها. فهذه الأخيرة
ترتبط بالنهاية بالواقع المجتمعي، والاقتصادي، والثقافي لحياة البشر
بتنوعها الغنيّ. كما تعمل على تسارع هذه الحركة، فتؤثر فيها، وتزيد
فعاليتها لجهة تأجيج التناقضات المستنبطة في الواقع وتعريتها. وصولاً إلى
وضعها تحت المجهر لقراءتها والتصدّي لها، أو تغييرها، بما يُسمى انقلاباً
"جذرياً" على واقع بعينه، وهنا تتجلى حركة التاريخ قوية، وعميقة. ما يُثبت
تسارع هذه الأخيرة، المتمفصلة مع إيقاع التطور المعاصر العابر حتى
لمقدّرات العقل البشري الطبيعية، هو ما حصل، ويحصل في العالم العربي من
ثورات. كان للفيس بوك والأنترنت، العامل الحاسم في كشفها وولادتها، هذا في
الجانب التقني. أمّا التدخل العسكري السريع في ليبيا، والقضاء على حكم
القذافي، فهو تعبيرات عن هذا التسارع المتزامن مع التطوّر الصناعي المذهل.
إذاً؛ ما كانت تحققه حركة التاريخ في غضون قرون من الزمن فيما مضى. أضحت
تحققه اليوم في عقود، وربّما يتحقق غداً في سنوات ..!
الإسلام
السياسي في العالم العربي، حركة استولدها السياق التاريخي لأنظمة شمولية
ذات باع طويل في الالتفاف على مكنونات الفكر والعقل العربيين، وتجريدهما
من أدواتهما. لاشك، بأنَّ هذا الإسلام كان حيّاً يُرزق قبل هذه الأنظمة،
ولكنه كان دون روح سوسيولوجية، وابستمولوجية. حيث كان يفتقد الحوامل التي
تشكّل رافعة لتشييد بنائه الاجتماعي والسياسي. لكن مع تفريغ التربة
العربية من صخورها الصلبة، أصبحت الحفرة مهيأة للتأسيس لهذا البناء.
وخصوصاً، مع انعدام التنافس على هذه المقاولة السياسية، والاجتماعية
بامتياز.
إنَّ الهوّة الواسعة التي تشكّل حلقة مقطوعة بين
الإسلام، "كفكر، أيديولوجية، تصوّر، منظور اجتماعي ومعرفي"، ترجّح فكرة
فشل هذه الفلسفة في مواجهة تحدّيات العصر الراهن. ففي تركيا مثلاً؛ عندما
غلبَت النزعة الدينية الإسلامية على تصورات السياسة الإقليمية لحزب
العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، بمعنى تحوّل المنظور التركي من سياسي
إلى ديني، نجد أنَّ تركيا خسرت الكثير من حلفائها في المنطقة. وانتهت إلى
ساحة من الصراعات مع جيرانها مفتوحة على كل الاحتمالات. حصل هذا مع
إسرائيل، سوريا، العراق. إيران، وغيرها بتجلّيات أقل. يُثبت هذا قصوراً في
المقدرة على الفصل بين الديني والسياسي. فالعقيدة الدينية، في سمتها
الأساسية، هي مطلقة، بينما العقيدة السياسية هي في جوهرها، متبدلة،
ومتحوّلة، وتكتيكية. لذلك نجد الأولى تنتصر في صراعها على الثانية. ورغم
أنَّ الشرط التاريخي الذي أدى إلى تكوّن تركيا العلمانية، يصعب أن يتكرر
في عالمنا، لكن مع ذلك سنرى ربّما في المنظور القريب فشلاً سياسياً كبيراً
لما يُسمى الإسلام السياسي في تركيا ممثلاً بحزب العدالة والتنمية.
في
العالم العربي، يفتقد الإسلام السياسي الكثير من الشروط التي تؤدي إلى
إنتاجه كمشروع تغيير يطرحه تصحّر الساحة العربية من المشاريع اليسارية
القومية والتنويرية، وحتى الليبرالية والعلمانية. لكنه، وبالرغم من
افتقاده لهذه الشروط، فقد وجد نفسه وجهاً لوجه أمام استحقاق تاريخي انتظره
منذ عقود، وبمباركة شعبية واسعة، أتت عبر صناديق الاقتراع الديمقراطية.
الإسلام السياسي العربي، أمامه تحدّيات لا يُستهان بها اليوم. فالمطلوب
منه استعادة ما تم إضاعته من فرص لشعوب نُكبت بأنظمة استبدادية لم تترك
خلفها سوى الخراب في المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي. لكنّ هذا
الإسلام يبني فرضياته على رُكام الماضي وأخطائه. فينتقي منها ما يُمكن
معالجته في اجتزاء شبه كلّي لمشروع تغيير بنيوي عميق لا ترقى إلى استيعاب
أدواته هذه الفئة الملتبسة في عباءة تاريخية مطرّزة بأنظمة كمبيوتر،
وثقافة عولمة عابرة لكل الانتماءات، وأهمها الدينية. فكيف ستؤدلج مفاهيمها
في منظورات السياسة من بوابة الدين الحنيف.؟!
فشِلَ
الإسلام الأفغاني الطالباني بوصفه مشروعاً دينياً محضاً، لا يُشبه بحال من
الأحوال بنية الدولة ودلالتها السياسية. أمّا في دول آسيا، ماليزيا،
أندونيسيا، وغيرها. فقد بقي الإسلام لاحقاً لمفهوم الحياة الدنيا ومُضافاُ
لها لتحقيق التوازن الإنساني في البعدين، الاجتماعي والروحي للناس. ولم
يكن هذا الإسلام يوماً مؤسساً ثابتاً ومُطلقًا، أو منطلقاً لتعبيرات
الحياة وقوانينها الوضعية، أو شكّل بديلاً عنها. لذلك نجد أنه يمضي في
سيرورة تتشابه مع لغة العصر، ومدلولاته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية،
التي تتناغم مع المدلولات الروحية الذاتية. فتكون بذلك موازناً لها، وليس
العكس.
الإسلام السياسي العربي، ينتمي إلى كل تلك المدارس آنفة
الذكر، مُضافاً إليها المدرسة السلفية. يتمفصل كل هذا مع صراع متناقضات
هائل أنتجته البنى السياسية التي سبقت، وفي كل المستويات، التعامي عن هذه
الحقائق كارثة. ووصول الإسلام السياسي إلى سدّة الحكم قد يكون تراجيديا
محققة. وقد يكون العكس. لكن، وبالرغم من كل شيء، فإنَّ هذا الإسلام الذي
تشكّل بسبب من شحنات سالبة عبر سنوات طويلة، يستوجب التأريض بأداة السلطة،
حتى يتم تفريغه، بالكامل .




