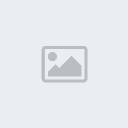
من حسنات "الأوان" أن أجد فيها محاورين أكفاء سأسعى لذكر بعضهم في موضعه،
على أنّي أودّ الآن أن أتفاعل مع الأستاذ ماهر مسعود والذي خصّ أطروحتي
بمقالين نقديين؛ أحدهما بعنوان "مستقبل الأوهام" (الأوان 14 آذار/مارس 2010)، ويحمل الثاني عنوان "من الفلسفة إلى الدين.. من الدين إلى الفلسفة" (الأوان 13 حزيران/ يونيو 2010). لن أساجله في أقواله لكني فقط سأحاوره عسانا ندرك سوية ما لم يكن يدركه كلّ واحد منّا على انفراد.
وبدءا يدعوني واجب الحوار إلى الاعتراف بأنّي لا أرى ما يعيب الأطروحة
المضادّة والواضحة للأستاذ ماهر مسعود سوى أنّها لا ترى لنفسها حاجة إلى
أيّ تنسيب في الأحكام، ما يجعل طريق الحوار غير منبسطة ابتداء، إلاّ أنّ
الإصغاء إليه قد كشف لي أنّ في بعض آرائي ثغرات أغفلتها وعثرات كان عليّ
أن أزيحها قبل أن أمضي في خطواتي الباقية. وتلك مزيّة أن يكون لي محاور
بذكاء ماهر مسعودومروءته.
لقد صرت الآن مدركا لبعض نقائصي والتي عليّ تداركها ما وسعني ذلك. وعلى هذا الأساس أبسط الاعتراف التالي :
حين أقول إنّ الإسلام منفتح على أفق الإلحاد، أو أنه على وجه التقريب
"ديانة ضدّ الدين"، فلعلي أنسى أو أتناسى بأنّ القرآن رسالة مقدّسة لا
تبقي لنا من خيار سوى أن نأتمر بأوامرها وننتهي عن نواهيها إلى يوم
يُبعثون!
وحين أقول إنّ الإسلام ديانة متمحورة حول الوجود العرضيّ، فلعلّي مرّة
أخرى أنسى أو أتناسى بأنّ القرآن يعدنا بجنّات خلد خالدين فيها أبدا
وينذرنا بعذاب لا ينتهي!
فما القول في اعتراضات قرآنية كهذه قد تبدو بيّنة بذاتها وناسفة لأطروحتي الأساسية؟
ليست من عادتي أن ألوي عنق النص بحثا عن التأويلات التي قد ترضيني لكنها
تكلف القارئ متاهات والتواءات يبدو معها الجهد التأويلي أكبر حجما من
النتائج الحاصلة.
على أنّي، انسجاما مع الأسلوب التواصلي الذي أنتهجه، سأولي وجهي شطر
الهدف وأمضي إليه عبر اختزال المسافات، ومن دون أن أترك شبهة التسرع في
الوصول. أو هكذا سأحاول.
نحن والقرآن : حين نتحدث عن الخطاب القرآني، فعلينا أن ننتبه إلى أننا لا نتحدّث عن رسالة واحدة وإنما عن رسائل متعدّدة تبعا لتعدّد المرسل إليه.
قد لا نختلف حول مسلّمة أنّ المرسل يظلّ واحداً في كلّ أحواله، لكنّ
المرسل إليه يختلف اختلافا شديدا، وأحيانا فهو يختلف من آية لأخرى، ويظل
مفعول الرسائل بعد كلّ هذا منحسرا في زمن وجود المرسل إليهم.
فالآيات التي تخصّ الرسول بمفرده، إما أمرا أو نهيا أو نصحا أو تأنيبا،
هي رسائل مفعولها محدّد بحياة الرسول. وعلى سبيل المثال فمن العبث أن
نعتبر الأوامر الإلهية إلى الرسول من قبيل (لا تحرّك به لسانك لتعجل به)
أو (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا)، تدخل بدورها ضمن الأوامر الموجّهة إلى
عموم الإنس في كلّ زمان، بما في ذلك اعتبارها أوامر موجّهة، هنا والآن،
إلى شيخ الأزهر ومفتي الديار السورية وإلى طلبة الكتاتيب القرآنية في
باكستان.
فالرسائل إياها تخصّ الرسول وينتهي مفعولها بنهاية وجود المرسل إليه.
وكذلك القول في الآيات التي تخصّ نساء الرسول على وجه التخصيص أو
الاستثناء، فمفعولها منته بانقراض نساء الرسول. وكذلك القول أيضا في آيات
هي رسائل مخصوصة إلى قريش أو الأوس أو الخزرج أو إلى طوائف معينة من أهل
الكتاب أو نحوهم.
والسؤال الآن صار واضحا :
ما هي الآيات التي تعنينا كمرسل إليهم نحن مسلمي القرن الواحد والعشرين؟
ربما أستطاع جورج طرابيشي أن يبيّن كيف أنّ القرآن خطاب بلسان عربيّ إلى
العرب غير الكتابيين، لكي يغدو لهم بدورهم كتاب ويصيروا كتابيين، كما
تبيّنه الآية المحورية (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمّ القرى
ومن حولها) (من النبيّ الأمّي إلى النبيّ الأمميّ، الأوان 22 آيار/ مايو
2010).
وقصدي أن أضيف بأن الخطاب القرآني، وحتى في حدود حصر مجاله في نطاق العرب
غير الكتابيين، فإنّ المرسل إليه يتعدّد وينحسر تباعاً وتبعاً للسياق
التواصلي. ورفعا لكلّ التباس، فإنّ الوظيفة الأسمى للقرآن تظل وظيفة
تأسيسية وليست توجيهية.
ذلك أنّ وظيفة القرآن ليست أن يأمر الناس وينهاهم في كلّ الأزمنة، وإنما
تتحدّد وظيفته الأسمى في تأسيس أنطولوجية جديدة، قائمة على التوحيد
والتعالي، ولا تتمحور بالضرورة حول العناصر الأربعة التي تقوم عليها
الكثير من أنماط اللاهوت ومن بينها اللاهوت المسيحي الغربي : الخطيئة
والشرّ والخلاص والخلود.
وبذلك يكون الإسلام ثمرة حراك إصلاحيّ اعتمل داخل الديانات السابقة وعلى رأسها العقيدة المسيحية.
ومحصلة القول أنّ معظم آيات القرآن رسائل لا تهمّ زماننا هذا الذي نحن
فيه، وإنما تهم أزمنة يصدق عليها قول الآية (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
ولكم ما كسبتم ولا تُسأَلون عما كانوا يعملون).
البعث والوجود العرضي :
حين نقول إنّ الإسلام ديانة زوال الأديان وأفولها، فذلك لاعتبار أنّ
الانطولوجيا الإسلامية تقوم على المصالحة مع الوجود العرضي. لكن ما القول
في أنّ القرآن يتضمن وعداً بنعيم خالد ووعيداً بعذاب أبدي؟
هنا أودّ التنبيه إلى ثلاث ملاحظات أساسية :
أولا؛ لم يسبق أن كان هناك إجماع بين المسلمين القدماء حول مسألة وجود
حياة خالدة بعد الموت، وحول دلالات خلود ذوات غير إلهية ولا تنتسب إلى
الذات الإلهية. ومن ذلك أنّ جهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف وصدر
المتألهين الشيرازي وغيرهم كثيرين، كانوا ينفون بوضوح أن تكون صفة الخلود
لأيّ وجود آخر غير وجود الله، ومن ثمّة نفيهم لأيّ خلود واقعيّ وفعليّ بعد
الموت. ولعلهم في ذلك المنحى كانوا أكثر وضوحاً في التعبير عن الأنطولوجيا
الإسلامية القائمة على مبدأ الوجود العرضي (كلّ من عليها فانٍ)، و(أحصى كل
شيء عددا)…
ثانيا؛ لم ترد حكايات العالم الآخر في القرآن بصيغة أفعال المستقبل وإنما
نراها ترد دائما بصيغة الماضي وأحيانا بصيغة الحاضر : (ونفخ في الصّور)،
(وجاءت كلّ نفس معها سائق وشهيد)… وهذا يعني أنّ القرآن لا يحكي عن العالم
الآخر من باب الوعد المستقبلي وإنّما من باب القصص والحكايات التي لا ترد
بدورها، كما يرى الزمخشري في تفسيره، سوى من باب ضرب المثل (ويضرب الله
الأمثال لناس لعلهم يتفكرون)، وفي آية أخرى (لعلهم يتذكرون)… ومع ذلك فإنّ
التعاطي العامي مع تلك الأمثال غير محبّذ قرآنيا، ولذلك يقول القرآن (وتلك
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون).
ثالثا؛ من الناحية القرآنية دائما فإنّ الوجود الأخروي، حتى لو افترضنا
تجاوزاً أنه وجود فعليّ واقعيّ، فإنه لا يفيد بالضرورة معنى الوجود
الأبديّ، والآيات التالية واضحة :
( لابثين فيها أحقابا ).
( قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ).
( وأما الذين سُعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ).
وبعد هذا تظل هناك عبارة قرآنية قد يُحتج علينا بها للقول بإمكانية
الوجود الأبدي : (خالدين فيها أبدا). إلاّ أنّ احتجاجا كهذا نراه يعاني من
مشكلة جدية. ذلك أن أبدا في اللغة العربية غالبا ما يتم استعمالها للدلالة
على النفي القطعي، فنقول "أبدا" حين ننفي ولا نقولها حين نثبت. وهي في تلك
الوظيفة التداولية تستعمل بخلاف الأبدية والتي تدل على الديمومة والدوام.
وبالطبع فلست أثير مثل هذه القضايا سوى من باب حوار تفاعليّ يضيء لي
عوارض الطريق أو ما بقي منها، لأنّي مقتنع ابتداء ومقتنع في الأخير بأنّ
الأنطولوجيا الإسلامية من أكثر الأنطولوجيات تحرّرا، وأنّ العنف والإرهاب
والتكفير في ديار الإسلام ليس أكثر من تعويض عن ذلك التحرّر والذي يعتبره
الكثيرون من باب الهشاشة التي تستدعي استنفار حراس المعبد.
الضفدع والتأويل : ليس الدين مجرّد أخبار نصدّقها أو نكذّبها، ليس مجرّد أوامر ننفّذها أو
نفنّدها، وإنما هو تمثّلات تشكّل الوعي وتؤثّث الخيال الذي يعدّ بدوره أحد
أهمّ أجزاء الوعي. الدين تمثّلات لا يمكننا أن نفرغها من الوعي مثلما نفرغ
النفايات في الحاويات. لكنّها تخضع في المقابل لمنطق اقتصاد إعادة
التدوير، فيما نصطلح عليه بالتأويل، وتحديداً تأويل النص الديني.
كتب الأستاذ ماهر في مقاله الثاني يقول :
"إذا كنت ضفدعا فسترى العالم ضفدعيا، ما يعني بالمحصلة نسبية الحقيقة".
قول بليغ. لكن السؤال :
إذا كان عليك أن تعمل على تغيير رؤية الضفادع إلى العالم، فكيف ستتصرف؟ وتحديداً : ما العمل؟
لأنك مثقّف فلن تتحوّل ضفدعا، لكن، ولأنك أيضا مثقف، فبوسعك أن تخطو خطوة
أخرى في الذكاء البشري، فتحاول أن تتمثل الرؤية الضفدعية للعالم، ومن هنا
تغدو قادرا على تغيير الرؤية الضفدعية من الداخل.
ملخص ما قصدته، أنّه ثمّة قواعد واضحة في عملية تدبير تغيير الوعي : ذلك
أنّ تغيير الوعي لا يكون إلا من داخل الوعي وتمثلاته، وعبر دعم المواقف
الأكثر إيجابية داخل تلك التمثلات. لأننا وقتما نقول باستحالة التغيير من
الداخل، وبعدم وجود أية مواقف إيجابية على وجه الإطلاق، فإننا نكون بذلك
قد انتقلنا من مرحلة الوعي الإصلاحي إلى مرحلة الوعي العدمي.




