[center]
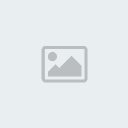
لا يخفى على أحد اليوم أن هناك هجمة حادّة وشرسة تشنّها قوى دينية ضدّ المفكرين الأحرار وضد إنتاجات الحداثة. وهذه القوى الدينية الظلامية تستغلّ أرقى ما أبدعه العقل الإنساني لمصارعة العقلانية والعلمانية والإلحاد. إن هذه الهجمة الحثيثة المحتدمة، والمتصاعدة على جميع الجهات وعلى مختلف الأصعدة، في الشرق والغرب، غالبا ما يدور رحاها على مواقع انترنت بشكل مباشر وحينيّ. لقد برزت الآلاف من المواقع الدينية في أوروبا وأمريكا والبلاد الإسلامية، كلّها مُنشغلة بالمُنافحة عن دينها، والترويج لمعتقداتها، والتهجّم على الملل الأخرى. لكن هذا لا يكفي، يجب الخروج للدعوة والتجهّز لغزو دار الحرب وإخضاعها بالقوّة.
ودار الحرب في عرف الجهاديّين من أهل الملل الآن، هي كل المواقع ذات التوجهات العلمانية التنويرية. ومن المحتمل أن قوى الظلام هذه، إن لم تكن وليدة مبادرات شخصية هامشية، فهي مستندة على مؤسسات وتجمّعات دينية مدعومة بقوة مادية قاهرة. فبِفضل الابداعات التقنية للعقل البشري، الذي يُمرّغه أهل الظلام في الوحل، أصبحوا الآن قادرين على التصدّي لكل ما يُنشر من مقالات وآراء وأبحاث على الشبكة العنكبوتية، والوقوف بعنف ضدّ كل ما لا يتماشى مع نسقهم الديني ولا ينسجم مع مسلمات إيمانهم. وقد تكون هذه الهجمات المتواصلة والمكثفة هي تحقيق لأجندة معيّنة، وتعبير عن قصدية يقع التلميح إلى أغراضها أو يُعلن عن أهدافها من حين لآخر: الرّصد والمتابعة والهجوم على كل كتّاب المواقع التي تَفسح المجال لنقدَ الأديان، وتدعّم حرية الفكر، والعلمانية، مع التشنيع على كلّ من نادى بالخروج من الدين والتخلي عنه، وكل من رفض الخنوع لإله الأديان واختار نهج الإلحاد.
وبما أن عديد المواقع العلمانية أو الإلحادية، تؤمن بحرية الرأي وتضمن حق الإختلاف، بل تجعل من مبدئها المؤسس عدم الرّفض المسبق لأي رأي مخالف مهما كان مأتاه، فإن قوى الظلام ـ (هم الذين لا يؤمنون إلاّ بدين واحد، ولا يعتقدون إلاّ في حقيقة واحدة، ويُسفهون ما عداها) ـ تسلّلوا من هذه الفرجة، واستغلوها استغلالا فاحشا، لكي يُحققوا مُبتغاهم. تَقنيتهم مزدوجة: الترهيب والترغيب. الترهيب هو السباب والشتم والقذف وإلقاء أبشع النعوت على المفكرين الأحرار والعلمانيين والملحدين؛ الترغيب هو التظاهر بالدخول في اللعبة، والالتزام (ظاهريا) بقواعد الحوار العقلاني، ولكن الهدف هو إحداث البلبلة وتهميش القضايا، سواء على المستوى اللغوي أو المفاهيمي، واعتماد السباحة في العموميات، أو تجنيد بعض مقولات الفلسفة الحديثة، أو الإرتكاز على عدمية بعض مفكري ما بعد الحداثة الغربيين، والذين تمّ نقضهم في الغرب ذاته. ولكن اللعبة مكشوفة، لأنهم هم أنفسهم في الأخير، بعد اللف والدوران، والتقيّة المستمرة، يُفصحون عن أغراضهم المبيّتة، ويُظهرون وجههم الحقيقي. ففي البداية يتفادون قدر جهدهم ذكر الدين، ويتعلّلون بالموضوعية العلمية، بالدفاع حتى عن العقلانية، بالتجرّد الفكري، ويُنادون بحرية المعارضة والنقد، وبالحق في الإختلاف. ولتدعيم هجمتهم التديّنية يُقدّمون أمثلة لمفكرين متعاطفين مع الدين وغير ناكرين لوجود الإله، وتُرفَع رايتهم وكأنها حجّة ثابتة ضد الإلحاد.
المؤمنون الذين ما فتؤوا يُنافحون عن ركام من الأساطير والخرافات، والتي أفلست وانهارت أمام التقدّم الباهر للعلم الحديث وأصبحت جثة هامدة، مستعدّون، للتحالف حتى مع الشيطان ولاستخدام كل الوسائل، بما فيها استيعاب ما كانوا قد كفّروه من قبل. ألم يقل البابا راتسنغر أن العود الأبدي النيتشوي يمكن أن ينسجم مع بنود المسيحية؟ فالمتديّنون بارعون في عملية الإختراق والإحتواء: لا شيء ينبغي أن يستقل بذاته، أو يأخذ مساره الطبيعي، لا الدنيا ولا الآخرة. كل شيء: العلوم والفلسفة والعقل والايمان والدولة والدين، كلها يجب أن يُستحوَذ عليها، وتُدجّن وتُساق لتدعيم مقولاتهم الدينية. حتى أكثر الأساطير إذلالا للعقل وأبعدها عن الحس الإنساني السليم، يجب أن تُزجّ عنوة في بوتقة المعقول كي تحوز على مكانتها ومشروعيتها.
إن هذه القوى الظلامية التي، كما قلت، تستغل العلوم والتقنية المعلوماتية الحديثة، وهي إبداعات إنسانية متعالية على الألوهية والدين، تعمل جاهدة للإجهاز على مقومات العقل والنكوص بالبشرية إلى أحلك عصور الظلمات. الانجيليون الأمريكان، أشدّ الناس تعصّبا في العالم وأكثرهم تشبّثا بالأساطير، يُروّجون، في شبكاتهم، لفكرة المصمّم الذكي، يعني لفكرة وجود إله خالق حكيم، ويحاولون فرضها على المؤسسات التعليمية لطمس نظرية التطوّر. الإسلاميون لا يختلفون معهم قيد أنملة، ويروّجون هم بدورهم إلى معتقدات بالية مذلة للعقل ومستمدة كلها من أساطير العهد القديم، والتي هي بدورها آتية من أساطير بابلية وإيرانية تعود إلى غياهب العصر البرونزي.
إنّ هذه الأساطير المهينة للعقل، يُعاد الآن شحنها، وصقلها وتطهيرها ثم ترويجها في وسائل الإعلام وكأن لها مصداقية تضاهي مصداقية أي منظومة عقلانية. إن الغرض الأساسي من الأتعاب التي يتجشمونها، كما يتراءى من محاولاتهم اليائسة، هو توطيد الدين الذي يعتقدون أنه الدين الحق المهيمن على جميع الأديان. الإسلاميون، بعد السجالات والتمويهات، والكر والفرّ وحمل الأطروحة والنقيض، يُنزلون قناعاتهم الدائمة الراسخة: الإسلام هو دين الفطرة؛ الأديان التوحيدية الأخرى هي فاسدة؛ كتبهم ليست بالكتب المقدسة، بل هي محرّفة؛ القداسة هي للقرآن فقط، وهو كلام الله؛ محمد هو النبي الحق وما يُروى في التوراة عن موسى وفي الأناجيل عن عيسى هي أساطير وكفر. القرآن عقلاني والكتب الأخرى لا عقلانية؛ التكفير والإقصاء هو أمر ضروري لسلامة المجتمع، الملحد هو إنسان شاذ، مارق، كافر ولا مكان له في العالم الإسلامي، وإن وُجد فعلا يجب أن يُقام عليه الحدّ، كما كان يُقام على أجداده من المرتدّين والزنادقة.
دون أن أطيل على القارئ: أحاول في هذا البحث وما يليه، أن أبرهن على أن أفكار هؤلاء المنافحين الجُدد ليست صادمة، ولا مُقنِعة، ولا هي بالأصيلة. وسأثبت بالنصوص أنها كانت دائما عُملة رائجة حتى في الغرب، الذي يجعلونه الآن قدوتهم فقط في ما يخص اللاعقل أو التدين. ومهما فعلوا من محاولات لتجنيد أسماء من قبيل هايدغر وريكور وغادامير ودريدا وفوكو، فلا يستطيعون أن ينتشلوا نسقهم الأسطوري، أو ينقضوه من الإتلاف، لأنه مفلس بلا رجعة. وسأبرهن على أن الإلحاد، هو خيار مشروع، بل إنه الخيار الأنسب والأصح والأصدق. وأن أهل الأديان، والمؤمنون ككلّ، بعيدون عن أن يكونوا قدوة في الإنسجام العقلاني أو النقاء الأخلاقي الذي يزعمونه، إذ يكفي لتبكيتهم التعمّق في مبادئهم وسبرها على محكّ العقل، لكي ندرك مدى تهافتها المنطقي، ومدى فسادها الأخلاقي، وكيف أنها لا تعيش إلاّ في السفسطة والعنف، وبالتالي فهي الوبال على البشرية جمعاء، وأنهم مهما فعلوا لتزوير الوقائع، وتطهير سيرتهم، لا يُمكنهم أن يُنسُونا أبدا تاريخهم الطويل المُسطّر بالحروب والدماء.
1 - عود على بدء. استحالة الإنسان الملحد:
منذ بضعة أسابيع وخلال زيارة له إلى إنجلترا خطب البابا بندكت قائلا: «إنّ استبعاد الله والدين والفضيلة من الحياة العامة يؤدي إلى نظرة مبتسرة للإنسان والمجتمع، وبالتالي إلى رؤية دونية إلى الشخص ومصيره». إن أبشع التهم التي يمكن أن تُلقى على شخص في الغرب هي أن يُقال بأنه نازي أو ذو نزعة فكرية نازية، العديد من المؤمنين يطلقون هذا اللقب على الملحد، والبابا بندكت واحد منهم. هناك من أقصى الملحد من مملكة الإنسانية العاقلة، وهناك من أخرجه تماما من مملكة الإنسانية ورماه في حضيرة الحيوان. في القرن التاسع عشر قال أحد العلماء الفرنسيين: «الإنسان الملحد لا يمكن أن يكون إلاّ مجنونا أو مارقا (1)». فيكتور هوغو: «ملحد! ماذا يمكن أن يعنيه؟ كائن في صورة إنسان، يستحق أن يتبوّأ مكانه بين الدواب!». إن رفض الأولوهية هو بحد ذاته أمر شنيع أخلاقيا، فضلا عن أنه خلف منطقي: «كيف نتصوّر هذا، أن يكون ممكنا عدم الاعتراف بالعقل الأسمى في حضرة كون حيث يشعّ فيه العقل». هكذا يزعم مونسينيور ماينان (Meignan). أما الأب موانيو فهو بدوره يتساءل مستنكرا: «إنه أمر لا يمكن تخيّله؛ لا أحد يتردد في إرجاع الساعة إلى الساعاتي، الأكلة إلى الطباخ، ولكن يُرفَض إجلال المهندس السامي لهذا الكون البديع». أحد الخطباء يصعّد من النبرة: «إن التربية بدون الله، تلك التي تحرم الإنسان من نقطة انطلاقه ومن نقطة وصوله في الحياة، والتي تنزع عنه هدفه، تنتهي أخيرا بدحره عنوة في صفوف الدواب». بول دي كاسينياك (P. De Cassagnac) «رعب لا يوصف للمادية ... هؤلاء الناس، العميان بالولادة، يرفضون سر الإله لأنهم لا يستطيعون إدراكه».
الإنسان الملحد لو أنه أصغى إلى صوت الطبيعته وعاد وانغمس في ذاته، لاعترف بالإجماع العام للبشرية على وجود إله، وهذا الإجماع نابع من غريزة أودعها الله في طبيعتنا. وعلى الرغم من محدودية عقل الإنسان وقصوره في سبر حقائق الطبيعة والكون يبقى اقتناع واحد صامد أمام الشكوك، يقول الأب رابان، ألا وهو حقيقة وجود الله. إنها الحقيقة الأكثر إشعاعا والأكثر شمولية للبشرية: «كل الأزمان وكلّ الأمم، كل المدارس متفقون على هذه الحقيقة. أفلاطون وأرسطو أكبر العلماء، اعترفا بهذه الحقيقة، من خلال ظلمات الوثنية. كلاهما أعطى براهين تُقبّلت من الخلف. أفلاطون برهن على وجود كائن أسمى من فكرة صانع العالم، الذي هو صنعة عقل، مثلما نبرهن على وجود المهندس من القصر الذي صمّمه. وأرسطو برهن على وجود إله بضرورة وجود محرك أوّل. إنها واحدة من البراهين التي اعتبرها ابن سينا الأكثر وضوحا عند أرسطو ... إن أعظم العباقرة القدماء، فيثاغورس، أبقراط، سقراط، ثيوفراسطس، جالينوس، الذين درسوا الطبيعة بأكثر عناية، لم يستطيعوا فهم نظام وترتيب الأشياء، دون فهم الإله (2)».
كل هذه العوامل، يواصل الكاتب، تفرض معقولية هذه الحقيقة والتي لا تجد لها من معارض إلاّ في أصناف «عقول مخرّبة بالإحساسية، وبالغطرسة والجهل (3)». إن هذه الحقيقة تبدو في جلائها وقوّة إقناعها إذا قارنّاها بغطرسة المعتقد المضادّ لها، أي الإلحاد. فعلا « لا شيء أكثر وحشية في الطبيعة من الإلحاد: إنه تشويش في الروح متصوَّر في الخلاعة: لا يمكن أبدا لمن يزعم الشك في الدين أن يكون إنسانا حكيما، منظّما، عقلانيا». إن ذهن الإنسان الملحد هو ذهن بسيط منتفخ بذاك النزر القليل من الشهرة التي صادفته في العالم على حين غرة. فهو يعتقد جهلا أنه من الأجمل الشك في الدين عوض الخضوع له. وككل المؤمنين فإن الأب رابان لا يدّخر أي نعت تحقيري ضد الملحد: «إنه إنسان غاو، لم يكن لديه رأس حرّ بما فيه الكفاية، ولا العقل نقي للغاية، لكي يحكم بسلامة على أي شيء. إنه مبتدئ لم يَدرس شيئا في العمق، ولا يعرف إلاّ بعض الفصول من مونتاني، أو بعض الصفحات من شارّون. إنه حكيم مزيّف، لا يملك من الحصافة والتصرّف إلاّ لكي ينجّي ببراعة المظاهر، ويصنع شخصه، ويأدّي كوميدياه على أحسن وجه. إنه امرأة منسلخة المزيّة، منغمسة في ملذتها، ليس لها من عقل إلاّ ما كوّنته من تحرّرها. أخيرا، كل ما هناك من تخريب للأخلاق، من ضعف في العقل، وتشويش روحي في العالم، تقاوم ضد ما يعلمنا الإيمان عن الله ووجوده، بينما الاستقامة، الحس السليم، اعتدال وصلابة الحكم، تخضع لهذا المعتقد»
إن هذا الاجماع العامّ لكلّ الشعوب، والتي لم يوجد أي واحد منها على وجه الأرض دون الإعتقاد في إله، لهو غريزة طبيعية لا يمكن أن تكون خاطئة، لأنها كونية (4). ولذلك فإنه من البلاهة، يقول الأب رابان، أن نُصغي حول هذه المسألة لمشاعر اثنين أو ثلاثة من الملحدين، الذين نفوا الألوهية في كل الأزمان، لكي يعيشوا براحة بال في التفسّخ. هل من المعقول، يواصل الكاتب، أن يكون هذا الإحساس الكوني المجبول في الطبيعة، مجرّد وهم؟ ليس هناك من شكّ في أن هذه الحقيقة، ليست منفية إلاّ من طرف أنفس متفسخة بالشبقية، والأنفة. ماذا يستطيع الملحد أن يُقدّم من حجج لمعارضة هذا الإجماع عند كل الشعوب وفي كل الأزمان، ولتقويض هذا المعتقد؟ لا شيء، فهو لا يملك من حجة لاسناد كفره إلاّ الشك المحض، وكل أستدلالاته لا يمكن إلاّ أن تشكّل خليطا مشوّشا من الأفكار لا يقدر أن يتحمّلها إنسان ذو حس سليم. ذلك حينما يُزعم عدم الإعتقاد في ما يبدو قابلا للإعتقاد لكل الآخرين، فإن أحدهم يُحمل أحيانا على الإعتقاد في ما هو غير قابل للإعتقاد، «لأن قلب وروح الإنسان لا يشعران بأي شيء، كلما كانا لا مباليان إزاء هذا الإنطباع العامّ، أي الإيمان بالإله المغروس في الطبيعة (5)».
هناك اعتراض عملي يلزم الملحدين ويضعهم أمام مفارقة رهيبة لا يمكن الفكاك منها. وذلك حينما يُعمد إلى استخراج كل النتائج الممكنة من مبادئهم. فعلا، الملحدون إذا ساروا على هدي نسقهم فإن إرادتهم ستتعطّل وسيؤولون إلى التواكل والخمول واللامبالاة. أطروحة الملحدين هي أن الطبيعة علة كل شيء، هي كائن موجود من ذاته ومكتف بذاته، وتُسيّر العالم بحسب قوانين خالدة لا علم لها بها. «لا شيء ممكن إلاّ ما فعلته، وهي تنتج كل ما هو ممكن، وليس هناك من مجهود إنساني قادر على تبديل أي شيء، أو إعاقة أي شيء في سلسلة مفعولاتها؛ كل شيء يحدث بضرورة مقدّرة لا يمكن تفاديها؛ ولا شيء أكثر طبيعية من الآخر، ولا أقل ملاءمة لكمال الكون؛ والكون في أي حالة هو عليها فهو دائما ما يجب أن يكون وما يستطيع أن يكون؛ وأن الطبيعة هي أمّ تجهل أبناءها؛ وأنها لا تفضل أحدهم على حساب الآخر، وإنما تمنح لكل واحد الصفات والخاصيات التي يستحق ويمكنه أن يستحقها بحسب الأزمنة والأمكنة (6)».
الطبيعة في نهاية المطاف هي محايدة أمام أفعال الإنسان، بل وغير مكترثة بها كليا، ولا تفرض أي عقاب على ما يسمى أخلاق متفسخة، ولا أي ثواب على ما نسمّيه فضيلة. من الأكيد، يقول بيار بايل صاحب هذا الإعتراض، أن إنسانا أوصل استتباعات نسقه الإلحادي إلى هذا الحدّ يمكنه أن يذهب به إلى مدى أبعد: «يُمكنه أن يقتنع بأنه لا فرق بين أن يقوم بهذا الفعل أو ذاك؛ وأنه لا توجد حرية اختيار، وإنما كل شيء حادث بقدر أعمى لا محيد منه. إن شخصا من هذا القبيل يجب أن يبقى مكتوف الأيدي دون أن يهتمّ بشيء، دون أن يُستثار بأي شيء، ودون أن يستثير الآخرين؛ وإنه يجب عليه أن يُسْلِم كل شيء إلى فعل الطبيعة؛ بما أن الجهل والعلم، الكذب والحقيقة، الفضيلة والرذيلة هي بنفس التساوي نابعة من الكائن الأوّل، ضرورية كلها على حدّ سواء، من الخلف العمل على التربية الذاتية وعلى إصلاح النفس، أو الآخرين، وفي النهاية إذا أراد أن يفعل شيئا، يجب أن يكون لأجل جلب كل ملذات الحياة (7)». هذه ربما هي أقوى الاعتراضات ضد الملحدين، كما يقول بايل، وهذا هو المنهج المعتمد لكسر شوكة أي معارض، أي إيصال مبادئه إلى مداها الأقصى، وإذا اعترف بها حتى صوريا، تعتمد كقواعد جديدة للاتهام. وإذا رُفضت، تُنتهز الفرصة لكي تُقدّم كحجة تبرهن على فساد النسق بتمامه. ليس هناك من موضوع يجب أن تُغلّب فيه هذه المنهجية كهذا الموضوع.
2- شقاء الإنسان دون الله:
الملحدون والمُتردّدون، حسب باسكال، هم في حالة يُرثى لها، ذلك لأن الأولين يعيشون في شقاء دائم، الثانين تغلب عليهم السطحية وكلا الفريقين يتقاسمان الشقاء: «يجب أن يُرثى لحال الملحدين، لأن في حالتهم من الشّقاء ما به الكفاية ... يجب أن يُرثى لحال الكفرة الباحثين. ألا يكفيهم ما هم عليه من شقاء؟ ويجب تجريح من يتباهون بالكفر (8)». يجب تجريحهم لأنهم لم يتعمّقوا في ما يزعمون دحضه، حتى وإن صاحوا بأعلى صوتهم أنهم بَذلوا جهدهم للبحث عن الدين الحق في كل مكان، دون جدوى. لكنهم، في حقيقة الأمر، مغرورون، ذلك «لأنهم يعتقدون أنهم بذلوا جهودا عظيمة إذا صرفوا بضع ساعات في قراءة الكتاب المقدس أو سألوا أحد رجال البيعة عن حقائق الإيمان. فيتبجّحون بعد ذلك أنهم بحثوا دون ما جدوى في الكتب وعند الناس». إنه تهاون، يرد بسكال، و«هذا التهاون لا يطاق» لأن الأمر لا يتعلّق بمصلحة بسيطة شخصية «بل هو متعلّق بنا نحن وبذاتنا الكلية (9)».
أبشع أنواع البشر هم الذين يقضون حياتهم في لامبالاة تامة دون الإكتراث بمصيرهم الأخروي، هذا الإهمال للقضايا الهامة المتعلقة بالخلاص، يقول بسكال « لممّا يُهيّج فيّ السخط أكثر مما يُهيج فيّ الرفق، إنه لإهمال يُدهشني ويَهولني: وهو عندي، لوَحش مخيف (10)». أما الإنسان الشكّاك الذي يزعم بأنه لا يعرف شيئا عن يقين الآخرة، وعن حياة بعد الموت ويقول «يجب عليّ أن أقضي كل أيامي دون أن أفكّر في البحث عما سيحدث بي ... وأنني إذ أضمر الإحتقار لمن يعنون بهذا، أريد أن أذهب دونما احتراس ولا خشية، لأقتحم هذا الحادث الجلل، وأساق مستسلما إلى الموت وأنا في ريبة من الأبد ومن مصيري (11)». الشخص الذي يتحدّث هكذا، يقول بسكال، ليس جديرا بأن يُتخذ كصديق أو صاحب أو مُعَزّ. فعلا «من ذا الذي يرغب في صديق يتكلم هكذا؟ من ذا الذي يختاره ليوكل إليه أعماله؟ من يلجأ إليه في الأحزان؟». هذا الإنسان هو، حسب وصف بسكال، غبيّ، «وإنه لفخر للدين أن يكون أعداؤه رجالا أغبياء بهذا المقدار، وأن مناوأتهم له، فضلا عن أنها ضئيلة الخطر، فهي تساعد على إثبات حقائقه (12)». هذا الإنسان لا فائدة ترجى من ورائه ولا يمكن أن نثق به إطلاقا: «أي فائدة لنا، والحالة هذه، إذا سمعنا قائلا يقول لرجل إنه خلع النير، وإنه لا يؤمن بوجود إله يسهر على أعماله، وأنه لا يفكّر في أن يؤدي عنها حسابا إلاّ لنفسه؟». إنه عار على الإنسان يقول باسكال أن يفتقر إلى النور «ليس أدل على السخافة المتناهية من أن يجهل المرء مقدار تعاسته بدون الله. ولا أدل على رداءة قلبه من أن لا يتمنّى حقيقة الوعود الأبدية، وليس أجبن من الاجتراء على الله (13)».
بسكال مقتنع بأن الإنسان بدون الله هو في أتم الشقاء، كيف لا وهو المحدود من كل الجهات. وبعد فأي شيء هو الإنسان في الطبيعة؟ يتساءل بسكال. الجواب هو أنه «عدم تجاه اللانهاية (14)»، وهو عاجز، على حدّ السواء، عن أدراك أسرار ذاته والكون: «غاية الأشياء ومبادئها مصونة عنه اقتدارا في سرّ لا يُدرَك، وإن عجزه عن رؤية العدم الذي استُخرج منه كعجزه عن رؤية اللانهاية التي تغتمره (15)». الإنسان في عماء تام إزاء الطبيعة والكون، إنه «في يأس أبدي من معرفة مبدئها وغاياتها» وليس بمقدوره إلاّ أن يَلمَحَ بعض المظاهر وسط هذا الشواش الغامض. ومع ذلك فإن بسكال له قناعة (لا ندري من أين استمدها وما هي مستنداتها) ألا وهي أن «جميع الأشياء خرجت من العدم ودُفعت حتى اللانهاية. من يستطيع تتبّع هذه المراحل العجيبة؟ إن مبدِع هذه المعجزات لَيُدركها ولا يُدركها غيره أحد (16)».
كل علوم الإنسان، وكل طموحاته الفكرية وتطلعاته العلمية للإحاطة بالكون والطبيعة والغوص في معرفة لامتناهي الصغر ولامتناهي الكبير هي أتعاب ضائعة، بل هي في الأصل وليدة الغرور. إن كلام باسكال يُصادق عليه دون تردّد أي متدين، وأي مؤمن متشبّع بعدمية ما بعد الحداثة. يقول «إن البشر، لأنهم لم يتأملوا هذه اللانهايات، قد انطلقوا دون روية للبحث عن الطبيعة كأن ثمة وجها لأن يقيسوا أنفسهم بها. ومن الغرابة أنهم شاؤوا تفهّم مبادئ الأشياء والتخطّي منها إلى معرفة كلّ شيء بغرور يضاهي غرض تلك الأشياء في لانهايته، إذ لا شكّ في أن هذا القصد لا يتوخاه إلاّ من كان على جانب من الغرور أو كان يضاهي الطبيعة في لانهاية اقتدروها (17)». الفلاسفة توهّموا التقدم العلمي وتفاءلوا بقدرة العقل على الغوص في الطبيعة وسبر ماهية الأشياء. هذا غرور مضاعف لأن طبيعة لامتناهي الصغر (الذرة أو ما شابهها) هي أخفى عن البصر لكن الفلاسفة زعموا « أنهم سيدركونها. وهنا تعثروا جميعا (18)». لا يبقى للإنسان، للخروج من مأزقه الوجودي، إلاّ اللجوء إلى لله.
3 - لِمَ الإلحاد؟
لكن هناك سؤال ملحّ يطلب الإجابة: ما السبب في وجود الملحدين؟ لماذا الإلحاد أصلا؟ ما الشيء الذي دفع بشريحة واسعة من العلماء والفلاسفة والأدباء إلى نكران ما يسمّى بالإله؟
لقد افترض فولتير أن السبب في وجود الملحدين هو اللاهوت (علم الكلام)، وليس الفلسفة، لأن الفلسفة، حسب زعمه، حرّرت العقول من الإلحاد (19). يجب أن نطلب المعذرة للملحدين، يقول فولتير (وللتذكير، فولتير لم يكن ملحدا، كان يعتقد في قوة روحانية تسيّر العالم، لكنه ينكر خلود النفس)، ذلك لأن أولئك العلماء الذين من المفروض أن ينوّروهم، ويَهدوهم، زادوا في بلبلة أفكارهم وتشتيت إيمانهم. فعلا، لا واحد من اللاهوتيين اتفق مع الآخر حول طبيعة الإله وصفاته وأفعاله. علماء الكلام المسلمون اختلفوا في كل شيء بالنسبة لتحديد طبيعة الإله. وقد ذكر الأشعري، في مقالات الإسلاميين، أن هناك رهط من المسلمين يرفضون التعالي الإلهي ويعتقدون أن «الله يحل في الأشخاص وأنه جائز أن يحل في إنسان وسَبع وغير ذلك من الأشخاص، وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا: لا ندري لعلّ الله حالّ فيه (20)».
البعض الآخر يرى أن الله هو «جسم له نهاية وحدّ: طويل عريض عميق. طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لا يُوفى بعضه على بعض (21)» . آخرون زعموا أن الله هو« نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكان كالسَّبِيكة الصافية يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ... وزعموا أنه هو اللون وهو الطعم وأنه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بأن تحرّك البارئ فحدث المكان بحركته فكان فيه. وزُعم أن المكان هو العرش (22)». المتكلّم هشام ابن الحكم قال إن إلهه هو «جسم ذاهب جاء فيتحرّك تارة ويسكن أخرى ويقعد مرّة ويقوم أخرى، وأنه طويل عريض عميق لأن ما لم يكن كذلك دخل في حدّ التلاشي (23)».
يعني، أن أي كائن لا متجسّم ولا متحرّك، يُحسب في عداد اللاوجود، نظرا إلى أن هذا المتكلّم مقتنع بالتناسب بين الله والأشياء، حيث يقول: «إن بين الإله وبين الأجسام المشاهدة تشابها من جهة من الجهات، ولولا ذلك ما دلّت عليه (24)». وهناك من ذهب إلى أن الله هو سبب نفسه (causa sui)، كما قال ديكارت. بالنسبة لهذه الفرقة الله «لم يكن حيا ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا ولا عالما ولا مريدا حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعا وبصرا، فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا (25)».
فرقة مقاتل ابن سليمان يقولون «إن الله جسم وأن له جُمّة وأنه على صورة الإنسان: لحم ودم وشَعر وعظم. له جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين مُصمت، وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يُشبهه (26)». هناك فصيلة أخرى رفضت التشبيه، حيث يزعم أتباعها أن ربّهم «ليس بجسم ولا بصورة ولا يشبه الأشياء ولا يتحرّك ولا يسكن ولا يماس (27)».
وذهبت طائفة من المسلمين أن الله جسم وحجّتهم في ذلك، يقول ابن حزم «أنه لا يقوم في المعقول إلاّ جسم أو عرض، فلما بطل أن يكون تعالى عرضا ثبت أنه جسم. وقالوا: إن الفعل لا يصح إلاّ من جسم، والباري تعالى فاعل، فوجب أنه جسم، واحتجوا بآيات من القرآن فيها ذكر اليدين واليد والأيدي والعين والأعين والوجه والجنب (28)». المعتزلة قالوا إن الله ليس له أي صفات أزلية تنضاف إلى ذاته: الله ليس له «علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية، وزادوا على هذا بقولهم إن الله لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة (29)». النتيجة هي أن الله هو «بكل مكان، بمعنى أنه مُدبّر لكل مكان وأن تدبيره في كل مكان». البعض الآخر يرى أن الله «لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه (30)».
وذكر الرازي في كتاب الأربعين أن هناك مِن المسلمين من لم يستسيغوا التنزيه التام، أو تصوّر ذات لا يجري عليها التبدل في الزمان والمكان، معتقدين أن من هذه حاله فهو معدوم محض. واعترضوا على خصومهم بأن «لمّا أثبتّم ذاتا منزهة عن الجهات والأكوان والأوضاع، خرج هذا الإثبات عن العقل، وقرب من العدم المحض. ثم إنكم الآن لما أثبتموه منزها عن أن يَصدُق عليه قولنا: كان ويكون وهو كائن: فهذا تصريح بالعدم المحض. وإذا أدخلتموه تحت قولنا: كان ويكون وهو كائن اقتضى ذلك الحكم عليه بكونه متجددا متغيرا، فكيف الخلاص من هذه العقدة المحيرة. وقد نظم المعري هذا المعنى في شعر له. فقال: قلتم لنا صانع حكيم * قلنا صدقتم كذا نقول. ثم زعمتم بلا زمان * ولا مكان ألا فقولوا * هذا كلام له خبيئ * معناه ليست لنا عقول (31)». الرازي يقول إن هناك من ذهب إلى أن العقل يثبت أن الله «لا بدّ وأن يكون في حيّز وجهة... ذلك أن كل موجودَيْن لا بد أن يكون أحدهما ساريا في الآخر، كالعرض الساري في الجوهر، أو يكون مباينا عنه بالجهة، كالجسمين. والعلم بذلك ضروري. والثاني أن الجسم مختص بالحيز والجهة. وإنما كان كذلك لأنه قائم بالنفس. والله يشاركه في كونه قائما بالنفس، فوجب أن يكون مشاركا له في الحصول في الجهة (32)».
أهل الجهة هؤلاء يدعمون رأيهم بما جاء في القرآن (الرحمان على العرش استوى؛ وهو القاهر فوق عباده؛ يخافون ربهم من فوقهم). هذه الآيات ومثيلاتها جعلت من المؤمنين بحرفية النص يعتقدون بأن الله في جهة علوية من السماء. لكن الرازي يرد بأن هذا تضارب مع العقل وبالتالي يجب التعامل مع النص بطريقة أخرى. هناك مفارقة يقول الرازي محيّرة جدّا بين عالمين يُفترض أنهما في توافق وانسجام: «إذا رأينا الظواهر النقلية معارضة للدلائل العقلية. فإن صدقناهما معا، لزم رفع النفي والاثبات، وإن صدّقنا الظواهر النقلية، وكذبنا الشواهد العقلية القطعية، لزم الطعن في الظواهر النقلية أيضا لأن الدلائل العقلية أصل للظواهر النقلية. فتكذيب الأصل لتصحيح الفرع يُفضي إلى تكذيب الأصل والفرع معا». أمام هذه المفارقة، لم يبق من حل، حسب الرازي، «إلاّ أن تُصدّق الدلائل العقلية ويُشتَغل بتأويل الظواهر النقلية، أو يُفوّض علمها لله (33)».
علماء الكلام من الأشعرية يصوّرون الله على أنه طاغية لاعقلاني وشرّير، حيث إن له إرادة مطلقة في فعل كلّ شيء حتى القبائح والشناعات. الغزالي في كتاب "الإقتصاد" حوصل هذا المعتقد: «ندّعي أنه يجوز على الله أن لا يُكلّف عباده، وأنه يجوز أن يُكلّفهم ما لا يُطاق، وأنه يجوز منه إيلام العابد بغير عوض وجناية، وأنه لا يجب رعاية الأصلح لهم، وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية [...] ندّعي أن الله قادر على إيلام الحيوان البريء عن الجنايات، ولا يلزم عليه ثواب ... ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين، ولا يستحيل ذلك في نفسه ولا يناقض صفة من صفات الإلهية (34)». وبالجملة أمام هذا الطاغية اللاعقلاني كلّ الأشياء تستوي والمتضادات لا وجود لها بحيث إنّ «الله يستوي في حقه الكفر والإيمان والطاعات والعصيان فهما في حق إلاهيته وجلاله سيان (35)».
القاضي عبد الجبار شنّع على من تبنّى مثل هذه الآراء، ولم يتوان من وصف القائلين بها (وهم مسلمون ويسمّون أنفسهم أهل الحق) بأنهم كفار. قال إن القوم «قد جوّزوا على الله كلّ قبيح، ومَن جوّز هذا لزم أن لا يقول بربوبيّته ولا أن يعبده، وفي ذلك من الفساد والكفر ما لا خفاء به (36)». ومن بلغ في تجاهل ضروريات العقل إلى هذا الحدّ، يقول القاضي، «فهو عن حدّ الإسلام خارج»، لا بل إن البعض من أتباع الأشعري جوّزوا "عقلانيا" الكذب على الله، لكنهم زعموا أن السمع مَنع من الإعتقاد في هذا الأمر. هذا الاستثناء لا يستوي عقلانيا ودينيا، بل يسميه القاضي عبد الجبار، مكابرة، لأن التجويز بحد ذاته ينسف من الجذور حتى ثقتنا بالسمع. فعلا «ما الذي أمّنكم من أن يكون كاذبا فيما أخبر به في كتابه، وذكره على لسان رسوله؟ ويُبيّن ما ذكرناه أن إبليس لو بَعثَ إلينا رسولا وكَتبَ كتابا يقول فيه "أجيبوني وأطيعوني فإني لا أضِلّكم عن سواء السبيل، وأهديكم إلى السراط المستقيم" فإنا لا نثق بقوله ولا نعتمد خبره لتجويزنا كل قبيح عليه. كذلك كان يجب أن لا تقع لهم الثقة بالله عندهم، فإن حاله أسوأ حالا من إبليس (37)».
أما تكليف ما لا يطاق الذي انفردت به الأشعرية، فإن القاضي عبد الجبار يرى أن هذه الفكرة هي «خروج عن الإسلام وانسلاخ من الدين (38)». الأشاعرة جوّزوا ذلك مستدلّين بالنقل (فقال أنبؤوني بأسماء هؤلاء)، فالله حسب رأيهم كلّف الملائكة «الإنْبَاء مع أنهم لا يقدرون عليه (39)». إن هذه الآراء، حسب القاضي عبد الجبار، لهي تدمير للعقل وخروج عن أبسط البديهيات، ومن المستحسن، إذا وصل الاستهتار بمبادئ العقل إلى هذا الحدّ، أن نمسك ولا نتحاور معهم. «كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح تكليف الزّمِن بالمشي، وتكليف الأعمى بنقط المصاحف على وجه الصواب، والدافع له مكابر جاحد للضروريات. ومَن هذا سبيله فإنه لا يُنَاظَر. وعلى هذا فإن النّظّام لما ناظره مُجبّر وانتهى بهما الكلام إلى أن قال له المجبّري: ما الدليل على قبح التكليف لِما لا يُطاق؟ سكت النظام وقال: إن الكلام إذا بلغ إلى هذا الحدّ وجب أن نُضرب عنه رأسا (40)». وبالجملة، حسب المعتزلي عبد الجبار، الأشاعرة، بتجويزهم على الله فعل الشرور والقبائح، خرجوا عن إجماع الأمة، لأن المسلمين في رأي القاضي «من لدنّ النبيّ إلى اليوم لم يجوّزوا ذلك على الله (41)».
إذا انتقلنا إلى العالم المسيحي فإن الوضعية لا تختلف كثيرا. آباء الكنيسة الأوائل، حسب فولتير، يعتقدون أغلبهم أن الله متجسّم؛ البعض منهم سحبوا منه صفة الإمتداد، ولكنهم وضعوه في مكان ما في السماء. البعض يرى أنه خلق العالم في الزمان، البعض الآخر خلقَ الزمان. هناك من أعطاه إبنا مماثلا له، آخر رفض أن يكون الإبن مماثلا للأب، واختُلف في كيفية صدور شخص ثالث منهما. اشتدّ النقاش حول مسألة هل أن الإبن مكوّن من طبيعتين أم لا. وهكذا فإن المسألة كما يقول فولتير تزحزحت دون الشعور بذلك إلى مسألة «هل أن في الألوهية ثمة خمسة أشخاص إذا حسبنا اثنين للمسيح في الأرض وثلاثة في السماء؛ أو أربعة أشخاص، إذا حسبنا للمسح في الأرض واحدة فقط؛ أو ثلاثة أشخاص، إذا ما اعتبرنا المسيح إلاها (42)».
وقد احتدم النقاش، حول ولادته العذرية، حول نزوله للجحيم، حول الطريقة التي يؤكل بها جسد الإنسان ـ الإله، ويُشرب بها دمه، حول شفاعته، ومكانة قدّيسيه، وحول العديد من المسائل الأخرى. النتيجة، يقول فولتير هي أنه «إذا رأينا أن المقربين من الألوهية قليلا ما هم متفقون، ويتبادلون تُهم الكفر من قرن إلى قرن، ولكنهم يتفقون جميعهم على التعطش المشط للثروة والجاه؛ ومن جهة أخرى حينما نُلقِي بنظرة على هذا العدد المهول من الجرائم والمصائب التي استفحلت في الأرض، والتي تسببت في العديد منها نزاعات أسياد النفوس: يجب التصريح، بأنه جائز للإنسان العاقل الشك في وجود كائن غريب الأطوار، ويجوز لشخص رقيق المشاعر أن يتخيل أنّ الإله الذي صنع بمحض إرادته العديد من التعساء، هو غير موجود (43)».
في الحقيقة ليس اللاهوت فقط، بل ربما السبب الأوّل في الإلحاد يعود إلى الكتب "المقدسة" ذاتها. فعلا، ليس هناك من عاقل لا يشعر بالاشمئزاز من الأساطير الصبيانية المذلة للعقل التي تروى في الكتب المقدسة. هذه الحقيقة، يقول فولتير، بيّنة بذاتها وغير قابلة للشك، وهي مدعّمة بشواهد دامغة نابعة من الكتب يقدّسها أهل الكتاب. هؤلاء الناس يحاولون اقناعنا بأن أتانا (أنثى حمار) تكلّمت (سفر العدد 22، 26 ـ 30)؛ وأن حوتا ابتلعت رجلا ثم تقيّأته حيّا يُرزق بعد ثلاثة أيام (يونان 2، 1 ـ 11)؛ أن نبيّا سمع نملة تتكلّم؛ وأن طائر هدهد تحدّث بفصاحة وأخبر نبيا بأشياء لا يعلمها؛ يجب علينا أن نعتقد بأن إله الكون أمر نبيّا عبريا بأن يأكل «قرصا من خبز الشعير معجون ببراز الإنسان (حزقيال 4، 12)»، وإلى نبي آخر أمره إله الكون هذا بأن يتخذ له مومسا كزوجة، وأن يُنجِب منها أولاد زنى (هوشع 1، 2). إنها بالتحديد الكلمات التي جعلوا من إله الحقيقة والطّهر يتفوه بها. المؤمنون يصرخون في وجه البشرية العاقلة: اعتقدوا في مئات الأشياء التي هي «إما مقززة أخلاقيا أو مستحيلة رياضيا وإلاّ فإن إله الرحمة سيُصليكم في نار جهنم، ليس فقط لملايين المليارات من القرون، ولكن للخلود، سواء أكان لكم جسم أم لم يكن».
الكتب المقدسة لا تبخل أيضا بروايات ومشاهد عنيفة ووحشية، وربما هي المتسببة في الوحشية التي نراها بين الأمم المؤمنة والمتمسكة بقدسية تلك الكتب. أوّل أمم التوحيد التي وصفها القرآن بأن الله فضّلها على العالمين، سمحت لها السماء باقتراف أرذل أنواع المكر وأبشع أصناف الوحشية، كما يقول دولباخ: «الدين مقرون بالجشع والقسوة خنَقَ فيهم صيحات الطبيعة، وتحت قيادة زعمائهم اللاإنسانيين [موسى وهارون ويشوع] دمّروا الشعوب الكنعانية ببربرية تُقزّز كل إنسان لم تَقض الخرافات كلّيا على عقله بعد. إن حُنقهم المُملَى من طرف السماء ذاتها، لم يدّخر الأطفال في الثدي، لا الشيوخ الضعفاء، ولا النسوة الحوامل، في المدن التي حمل فيها هؤلاء الوحوش أسلحتهم المنتصرة. بأوامر من الله أو من أنبيائه، انتُهكت الإنسانية، خُرِقت العدالة ومُورست الوحشية (44)». مِن الواضح، يقول فولتير، أنه «من الأفضل عدم الإعتراف بأي إله بدل عبادة [إله] بربري تُضحّى لأجله الناس، كما قد حدث عند العديد من الأمم (45)».
الصورة التي يرسمها الكتاب المقدس لحركة التاريخ مثيرة للاشمئزاز والقرف. إن النبي موسى الذي ناجى الله وجها لوجه (أو خَلفَ حِجَاب)، أمرَ اللاويين بذبح ثلاثة وعشرين ألف من إخوانهم لأنهم صنعوا عجلا من الذهب؛ في واقعة أخرى، تم تقتيل أربعة وعشرين ألف لأنهم ارتبطوا بعلاقات مع فتيات البلد، ثم أبيد إثني عشر ألف رجل لأن البعض منهم أرادوا شد العرش الذي كاد أن يقع. أمام هذه الجرائم المقترفة بأوامر من الإله، يقول فولتير «يمكننا إنسانيا أن نقول، إنه كان من الأفضل لهؤلاء التسعة والخمسين ألف إنسان ... أن يكونوا ملحدين ويَحيوا، عوضا أن يُذبحوا باسم الإله الذي يعترفون به (46)».
أن يأتينا كتاب يدّعي القداسة وفيه يوصف الإله بأنه يتلذذ بحرق عباده، فهذا ما يقشعرّ له البدن ويفزع له الحس الإنساني السليم. أهل الأديان يعتقدون بأنهم يُدخلون التقوى بالرعب، لكن في الحقيقة لا يُولّدون في الأنفس إلاّ النفور والهلع. الإفلاطوني كالسوس في كتابه ضد المسيحية، سخر من أتباع تلك الملّة لأنها ضاقت بهم السبل ولم يجدوا بمن يشبّهوا إله هذا الكون إلاّ بطبّاخ. إنه اعتقاد مجنون، وهو أن «الله كما لو أنه طباخ (ωσπερ μαγειρος)، حينما يوقد النار، كل الجنس البشري سيُشوى، وهم الوحيدون الذين سيبقون أحياء (47)».
يعتقدون أيضا بأن أجسادهم ستبعث وأن الأرواح ستدخل فيها مجددا. «إلاّ الدّيدان، يقول كالسوس، يمكنها أن تغذي رجاءا من هذا القبيل! فعلا، أي نفس إنسانية يمكنها أن ترغب مجددا الدخول في جسم متعفّن». أساطير العهد القديم (حاضرة في القرآن) هي كلها لا عقلانية وقبيحة: اليهود يتحدثون عن امرأة تلد في شيخوختها، عن تآمر إخوة ضد إخوة، عن آلام أب، عن مكائد أمهات: والإله بصفة لاعقلانية هو دائما قريب منهم ليُباركهم جميعا ولكي يُغدق عليهم من خيراته (48). مَن الكافر يا ترى؟ مَن الذي يُحقّر من شأن الإله؟ أهم اليونانيون، أفلاطون وأرسطو وأبيقور أم مبتدعو هذه الخرافات؟ اليهود والمسيحيون، يقول كالسوس، يسندون إلى الله الغضب والوعد والوعيد، أي مشاعر إنسانية «ويقدّمون آراء كافرة تجاهه وهم في خطئ جسيم حينما يحاولون تعليلها (49)». أليس مُضحكا، يواصل كالسوس، « أن رجلا واحدا [تيتوس، ابن الامبراطور فيسبازيانوس]، غاضبا على اليهود، قتل منهم كل البالغين وأحرق المدينة، بينما الله، الأكبر (ο μεγιστος)، كما يُسمّونه، غاضبا ومُتحسّرا ومتوعّدا، أرسل أبنه كي يسام سوء العذاب؟ (50)».
إن هذه المعتقدات التي لا تُتصوّر في تهافتها واستهتارها، يُعلّق فولتير « تُفزع الأرواح الضعيفة والخائفة بقدر ما تفزع الأرواح الصامدة والحكيمة». وليس من المستبعد أن يقول البعض: «"إذا كان أسيادنا يصورون لنا الله على أنه الأكثر لاعقلانية وبربرية من دون الكائنات الأخرى، فليس هناك إذن أي إله"». أولئك الذين يقولون بإمكانية وجود مجتمع من الملحدين لم يُجانبوا الصواب أبدا. فعلا «عمّروا مدينة برجال مثل أبيقور، سيمونيد، بروطاغوراس، ديبارو، سبينوزا؛ وعمّروا مدينة أخرى بالجنسينيست (jansénistes) والمولينيست (molinistes)، في أي منهما تعتقدون أنه ستحدث أكثر الاضطرابات والنزاعات؟ (51)».
إن معظم العلماء يعيشون كما لو أنهم ملحدون: «كل من عاش ورأى، يدرك أن معرفة إله، حضوره، عدله، ليس لديها أدنى تأثير على الحروب، والمعاهدات، ومواضيع الطموحات والمصلحة ... لكن لا نرى أبدا أن [الملحدين] يخرقون القواعد الراسية في المجتمع: من الأفضل بكثير قضاء الحياة معهم، عوضا عن قضائها مع جهلة متعصّبين. أنا أنتظر، على الحقيقة، أكثر عدالة من ذاك الذي يؤمن بالله بدل من الذي لا يعتقد؛ لكنني لا أرى من المتدين الخرافي إلاّ مرارة واضطهادا». الملحد، يقول فولتير، حتى في خطئه، «يحافظ على عقله الذي يقطع له مخالبه، والمتعصب مصاب بجنون مستمرّ يشحذها (52)». ومهما كان الأمر فإن فولتير ينصح الإنسان الحصيف بأن يقول: "إن معلّمينا يسندون إلى الله حماقاتهم ووحشيتهم، إذن الله هو عكس ما يقولونه، الله هو حكيم وخيّر بقدر ما يقولون عنه أنه مختل وشرير". هذا ما ينبغي أن يقوله الحكيم. لكن، هذا لا ينجّيه من المتاعب وربما لا يمنعه من تعريض نفسه للخطر. فعلا «إذا سمعه إنسان متعصب، يشتكي به إلى قاض عبد للقسيسين؛ وذاك الجلاد سيُصْليه على نار بطيئة، معتقدا بأنه ينتقم ويُحاكي العظمة الإلهية التي انتُهكت».
4 - اليقين الإيماني ضد الشكّ العقلاني:
إذا لم يرفض العلماء وجود الإله، فإنهم يتردّدون في تعريفه، ويتحلّون بشيء من الحصافة في التحقق من طبيعته. أفلاطون نفسه قال بأن أب هذا الكون، صعب معرفته، وإذا وقع حدسه فإنه من الصعب التعبير عنه. لكن الموقف مغاير عند أهل الأديان، لأنهم لا يركنون إلى الريبية، ومقتنعون بأن الإله الذي يتردد الفلاسفة بالنطق به كشف لهم عن نفسه. ويبدو أن الرسول بولس، حسب رواية الأناجيل، عبّر عن هذه القناعة حينما وقف أمام الأثينيين وقال لهم بكل وثوق إن الإله المجهول الذي يُوقرونه كشف يسوع المسيح عنه في حقيقته. إن إصرار المتدينين واقتناعهم من أنهم وجدوا فعلا الإله الحق في الوقت الذي يتوانى فيه الفلاسفة عن الجزم في قضايا عويصة مثل الألوهية وصفاتها، لممّا يبعث على الحيرة. المؤمنون لا يكتفون بالتباهي بيقينهم من أنهم على حق، بل هم يَسخَرون من تردّد بعض الفلاسفة وتجهّمهم في البتّ في هذه القضية العويصة.
الفيلسوف الروماني شيشرون يروي حكاية سيمونيد مع طاغية صقلية هيرون حينما سأله أن يعطيه تعريفا للإله. لقد ماطل وراوغ لعدة أيام، وكل مرّة طلب تمديد المهلة كي يتسنى له النظر بعمق في هذه المسألة. لكنه في الأخير اعترف بعجزه وقال: « كلّما فكّرت أكثر كلما ظهرت لي المسألة أكثر غموضا» وشيشرون (على لسان المحاور كوتّا) يعلّق بأن سيمونيد الشاعر والحكيم نظرا إلى أنها تهافتت في ذهنه العديد من الإجابات الثاقبة والدقيقة، ونظرا إلى عدم قدرته على اختيار أيها الأصح «يئس من كل حقيقة (disperisse omnem veritatem)». لو أن الحكيم سيمونيد كان واثقا من نفسه وواثقا مما تلقنه في صباه لما توانى لحظة واحدة من الإجابة عن السؤال. لكنه ماطل لأنه من المحتمل أن أمام أي إجابة تصوّر اعتراضات مضادة ومحالات عويصة تمنعه من ترجيح إحداها على الأخرى ولذلك يئس، كما يقول شيشرون، من الحقيقة وانسل من اللعبة. لكن، يقول بايل « ذهنا ضيقا لن يتصرّف بهذه اللطافة» لأنه تربى على الحقيقة الجاهزة، وسيجيب مباشرة بكل اعتداد وحزم دون أن يختلجه أي شك في أن إجابته هي الأصحّ. في القرن الرابع، دار سجال بين السيناتور الروماني سيماخوس (Symmachus) وبين الأسقف المسيحي أمبروزيوس (Ambrosius). سيماخوس الذي بقي على دين آبائه، يقول لأمبروزيوس ما معناه بأن المَعبُود واحد ولكن طريقة العبادة تختلف من مكان إلى مكان ومن شعب لآخر، وبالتالي ليس من الحصافة ولا من باب التقوى أن تفرض، على من ليس هو بمسيحي، التخلي عن دينه والإعتقاد في إله آخر (53).
لكن الموقف الريبي الذي جعل من السيناتور الروماني حصيفا ومتريثا في أمور الألوهية يتقشّع عند الأسقف المسيحي لأنه مقتنع من أن دينه هو الأصحّ وإلهه أجاب عن كل شيء: « سرّ السماء قد علّمنيه الله نفسه، الذي خلقكم، وليس الإنسان، الذي يجهل حتى نفسه. إلى من أتوجه للإيمان بالله، إن لم يكن لله؟ كيف أستطيع أن أومن بكم، وأنتم تعترفون بأنكم تجهلون الذي تعبدونه؟ أنت تقول " لا يمكن أن نُدرك سِرّا عظيما بإتباع نهج واحد". ما تجهلونه أنتم، نحن نعلمه من كلام الله. وما تفترضونه أنتم، معروف عندنا من طرف الحكمة والحقيقة الإلهية (54)». القضية بالنسبة لأمبروزيوس محسومة مسبقا، ذلك لأن الإله الحقيقي الأوحد هو الإله المسيحي (est deum Christianorum) أما آلهة الوثنيين، كما يقول الكتاب المقدس، هم شياطين، وبالتالي بدون الإيمان بالإله المسيحي «لا يوجد خلاص أبدا».
الإنسان المؤمن يبحث عن اليقين التامّ، ولن توقفه بالتالي الشكوك المحرجة، ولن يتريّث لسبر المعضلات واستقصاء معانيها. اللاهوتي ترتليانوس هو مثال آخر لهذا الاعتداد الذي وصل إلى حدّ العنجهية. إنه يرى، على عكس ترددات الفلاسفة وشكوكهم، أن أي إنسان مسيحي بسيط قادر على إعطاء تعريف للإله. ما يفرّق المسيحيين عن الفلاسفة، حسب زعمه، هو أن هؤلاء الأخيرين الذين يصفهم بأنهم "مخادعون ومحتقرون (illusores et contemptores)" يموّهون الحقيقة ويخرّبونها (corrumpunt) وذلك لخدمة مصالحهم والبحث عن المجد، أما المسيحيون فإنهم «بالضرورة ينزعون إلى الحقيقة ويرغبون فيها ويعلنونها كاملة نظرا إلى أنهم يعتنون بالخلاص (55)».يعني أن المؤمنين والفلاسفة، يضيف ترتليانوس، ليسو سواسية «لا في العلم ولا في التعاليم». في الوقت الذي يتردد فيه الفلاسفة عن الاعلان عن حقيقة الله فإن «أيّ حِرَفي مسيحي قادر على الوصول إليه والبرهنة عليه، وبالتالي يؤكد أيضا بالفعل كل ما يبحث عنه بخصوص الإله (56)». ما الشيء الذي يجمع بين الفيلسوف والمسيحي؟ يتساءل ترتليانوس ـ لا شيء إطلاقا، فالبون شاسع «بين تلميذ اليونان وتلميذ السماء، بين من يرغب في الشهرة ومن يرغب في الحياة، بين محترف الكلمة وبين محترف الواقع، بين بانٍ ومهدّم، بين مُموّه الحقيقة وحافظها ، بين سارقها ووصيّها (57)».




