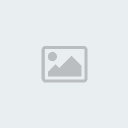
1. تعاسة الإنسان دون الله
المؤمنون، مِن أرقّهم مشاعر ومن أكثرهم أدبا وثقافة إلى أجهلهم وأكثرهم صلافة، يَسخرون من الملحدين ويَنعون لحظهم ولحياتهم التعيسة لأنها خالية من القيم الدينية، وغير مستندة على الإعتقاد في إله خالق. أخرجوهم من الجنس البشري، شبّهوهم بالدّواب، اعتبروهم خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع، تربّصوا بهم، اضطهدوهم ودَعَوا إلى إبادتهم.
فهذا الرياضي باسكال، يزعم أن الإنسان دون الله لا قيمة له، وهو غارق في التعاسة والبؤس، وليس الإنسان دون الله فقط بل البشرية قاطبة ترزح في حالة تعاسة رهيبة. ومن قبله بقُرون كتب إينوسانس الثالث كتابا عنوانه فقط يُحوصل محتواه: “في كره العالم (De contemptu mundi). أو في بؤس الحالة الإنسانية[1]”.
الغزالي بنفس هذه اللهجة يقول إن الدنيا هي العدوّ اللدود لله، وللمؤمنين والكفار على حد سواء. الدنيا «عدوّة لله وعدوّة لأولياء الله وعدوّة لأعداء أولياء الله[2]». إنها ورطة للجميع، ومع ذلك فقد خلقها الله على هذه الصورة. ولكنه بعد أن أوجدها من العدم، كأنه ندم على فعلته تلك، فتَركها في حالها «ولم ينظر لها منذ أن خلقها[3]». لأن الدنيا على حد قول الغزالي «قطعت الطريق على عباد الله». هذا على الرغم من أن المسلمين يعتقدون أن الدنيا هي بلاغ للآخرة، يعني أنها الشرط الذي بدونه لن يتحقق الخلاص الأخروي. وهم في الواقع يعانون شرخا نفسيا في حياتهم العملية والروحية، ووضعيّتهم هي أقرب إلى وضعية الإنسان المصاب بالفصام النفسي: منغمسون في الملذات الجسدية، أحلّ لهم الله التمتّع بالجنس واتّخاذ أكثر من زوجة، فضلا عن العدد اللامحدود من الجواري المسبيات، ثم وعَدهم في الجنة بجميع الملذّات، واتخاذ عدد كبير من النساء، حلال عليهم أن يملكوا الأموال وأن يستثروا دون حدّ، وفي مقابل هذه الإمتيازات واجب عليهم القيام بخمس صلوات في اليوم، يصومون شهرا كاملا في عز الحرّ، يقطعون مسافات طويلة للحجّ، يحملون السلاح، يُقتَلون ويَقتُلون لإدخال الناس عنوة في دينهم.
ومع ذلك تبقى الدنيا في أعينهم « ملعونةٌ، وملعون ما فيها»؛ جيفة متعفنة مرمية في القمامة أهون على الله من شاة ميّتة، بل هي لا تعدل جناح بعوضة. ويروى أن الله لما هبط آدم إلى الأرض قال له: ابْن للخراب ولِدْ للفناء. المسلم يجب عليه أن يختار بين شيئين متضادّين، إما الدنيا أو الآخرة ذلك لأنه: «لا يستقيم حبّ الدنيا والآخرة في مُؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد[4]». لا يجب أن نَبنِي شيئا في هذه الدينا أو نطمح إلى الاستقرار فيها وتَرك ميراث للأجيال الآتية بعدنا. فمَثَل الدنيا كمَثَل البحر: مَن هو المعتوه الذي يبني على موج البحر دارا؟ «تِلكُم هي الدنيا فلا تتخذوها قرارا» حسب قولة مأثورة للمسيح، أوردها الغزالي ولا ندري من أين استقاها. وقال أيضا لحواريّيه: ابغضوا الدنيا يَحبّكم الله. إن أكبر الكبائر هو حبّ الدنيا، على حدّ قولة للإله أوحى بها إلى موسى: يا موسى لا تَركُنَنّ إلى حبّ الدنيا فلن تأتِيَني بِكبيرة هي أشدّ منها[5]. المسلم، لكي يَصلُح حاله، عليه أن يَقوم بعملية مقايضة في اتجاه واحد ويعمل بنصيحة لقمان: «يا بنيّ بِع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تَبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا[6]». مالك بن دينار سمى الدنيا “سحّارة” وقال: «اتّقوا السّحارة فإنها تسحر قلوب العلماء». المسلم يجب أن يعيش في تعاسة طوال حياته، وهذه هي الحالة الطبيعية، لأن الحالة النقيضة، أي حالة السعادة، هي النشاز الذي ينبغي تجنّبه كما يتجنّب أحدهم «الجيفة إذا مرّ بها أن تُصيب ثوبه[7]». يجب عليه أن ينسى الفرح، والضّحك والإطمئنان والنصب: «عجبا لمن يعرف أن الموت حقّ كيف يفرح؟ وعجبا لمن يعرف أن النار حقّ كيف يضحك؟ وعجبا لمن رأى تَقلّب الدنيا بأهلها كيف يَطمئنّ إليها؟ وعجبا لمن يعلم أن القدر حقّ كيف ينصب؟[8]».
إن العلاج الوحيد من داء الدنيا هو «الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب». المؤمن إذا رأى «حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلّها وإن أعطِيَ ملك الأرض من المشرق إلى المغرب. وكيف وليس عنده من الدنيا إلاّ قدر يسير مُكدّر مُنغّص، فكيف يفرح بها أو يترسّخ في القلب حبّها مع الإيمان بالآخرة[9]». إذا احتقر المرء الدنيا بهذا الشكل فإنه سيحتقر حتما كلّ ما تَبِعها بما في ذلك فعاليات الإنسان الرّفيعة وخصوصا النظرية منها، ولن يبحث إلاّ عن الخلاص بالتعبّد، وأداء الفرائض التي تُوجبُها ملّته. الفلاسفة يقولون إن العلم المجرّد يرفع من مرتبة الإنسان ويكسبه نورا وسعادة لا يطمح بعدها إلى شيء آخر. لكن هذا الأمر، في نظر مَن يحتقر الدنيا، ويُعلي من شأن ما يسمّى بالآخرة، هو خطأ جسيم. النشاط النظري وحبّ الإطلاع، والنّهم الفكري لا تنفع في شيء ولا توصل إلى نتيجة صالحة، فالخلاص في العالم الآخر، يأتي من العمل، يعني التعبّد، أو كما قال الجُنيد من «رُكيعات رَكعناها في جوف الليل[10]». إن تقديم العلم النظري على العبادات هو بمثابة تقديم المشغلة على المنفعة. إنّك «لو قرأتَ العلم مائة سنة وجمعتَ ألف كتاب[11]» ـ يقول الغزالي في نصيحة لأحد تلاميذه ـ ولو «أحييتَ الليالي بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمتَ نفسك من النوم[12]» فلن تنال مرضاة الله ولن تفوز بالخلاص في الآخرة. إن العلم بلا عمل جنون والعمل بلا علم لا يكون، ومِن الأكيد جدّا أن العلم هنا هو الفقه بأصنافه، والعمل هو العبادات الإسلامية.
وهذا غير مستغرب لأن العلوم اليونانية هي العدوّ اللدود للمؤمنين. إنها فكرة قارّة عند الفقهاء منذ القديم وقد عبّر عنها الشافعي في هذه الأبيات القطعيّة: “كل العلوم سوى القرآن مشغلة .. إلاّ الحديث وإلاّ الفقه في الدين .. العلم ما كان فيه قال حدّثنا .. وما سوى ذلك وسواس الشياطين”. أيها الولد، يقول الغزالي بلهجة تهديد وزجر: « أيّ شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والطبّ والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف؟»، لا شيء، بمقياس ديني بحت. إن هذه العلوم هي في الحقيقة «تَضْييع للعمر بخلاف ذي الجلال[13]». النصيحة الوحيدة، على أنقاض هذه الغوايات الدنيوية التافهة، هي معرفة طاعة الله وعبادته. الطاعة والعبادة، يتركّزان فقط في «متابعة الشارع في الأوامر والنواهي، بالقول والفعل[14]».
إينوسانس الثالث في كتابه أعلاه (كره الدنيا)، يسخر هو بدوره من العلماء بصفة جدّ رهيبة. قال «إن الحكماء المحقّقون، يفحصون في السماء العالية، والأرض الممتدّة، وفي البحار العميقة، يناقشون كل شيء، يعلّمون ويتعلّمون. ولكن ما الشيء الذي يجنونه من هذه المهنة سوى المشقة والألم وعذاب النفس؟[15]». أحد الكتاب المسيحيين في عصر الغزالي، يُكرّر نفس النصائح التي أسداها الغزالي إلى تلميذه. قال: «أي شيء حاصل لك (quid prodest tibi) بالجَدل في عمق أسرار الثالوث، إذا كان يَنقصك التواضع، الذي بدونه لن تنال رضاء الثالوث؟ هذه هي الحال: الخطابات العميقة لا تُكوّن الرجل الصالح والعادل، لكن حياة فاضلة تجعل الإنسان قريبا من الله[16]». ثم يقول في لهجة شبيهة بلهجة الغزالي: «أُفَضّل الشعور بالمهانة بدل معرفة حَدّها.
العلم بالكتاب المقدّس كلّه، والعلم بأقوال الفلاسفة كافة، ماذا يفيدك دون رحمة الله ونعمته؟». كلّ شيء فاسد إلاّ محبّة الله وطاعته هو وحده (amare Deum، et illi soli servire). هنا تكمن أعلى مراتب الحكمة: التوق إلى مملكة السماء «باحتقار الدنيا (per contemptu mundi)[17]». ومرّة أخرى فإن نفس اعتراض الغزالي ضد العلم النظري نجده تقريبا على حرفيّته عند هذا الكاتب المسيحي: «إن حبّ المعرفة طبيعيّ في الإنسان: لكن ماذا تنفع المعرفة دون خوف الله؟ إن مُزارعا متواضعا هو أكملُ من عالِم مُترفّع يُهمِل نفسه لكي يَعتَني بالفحص في حركة الأجرام … مهما امتَلكتُ من معرفة بالمخلوقات، دون أن أكون في حالة رحمة، فلن تنفعني أمام الله الذي سيحاسبني عمّا فعلته». النصيحة هي هذه: اكبح جماح إرادة المعرفة (sciendo desiderio) لأن فيها كثيرا من أسباب الملهيات والخداع. الحقيقة هي أنه كلّما كان علمك «أوسع وأعمق، كلّما كان حسابك أعسر إذا لم تعش بنفس القداسة».
2. رهان باسكال
إن المؤمنين، نظرا لتعاستهم الظاهرة والمشقّة التي يجدونها في الالتزام بتعاليم دينهم، وتأدية الفرائض الثقيلة، يَميحون إلى ثلب الدنيا، والتهجّم على أمثالهم، ويحاولون أن يَجرّوا إلى صفّهم أكثر عدد من الأتباع. فكأنّ لسان حالهم يقول: لن نَدَع واحدا يعيش في سعادة أو يَطمح إلى تحقيق أسباب السعادة في هذه الدنيا. كيف لا ونحن معذّبون في أجسادنا، وضمائرنا تحترق في كلّ لحظة، وبؤسنا النفسي يتفاقم يوما بعد يوم، والآخرون يَنعمون بالرّاحة النفسية ويحققون السعادة في دنياهم. يجب توحيد البشرية على حالة واحدة، أي البؤس الديني والتعاسة وتعميمها على الجميع دون استثناء.
المؤمن باسكال بالغ في احتقار الدنيا، وأمعن في الازدراء بالبشرية. ولم يجد أمامه من تشبيه للوضع الإنساني إلاّ هذا التشبيه المفزع. قال تصوّروا عددا من الناس في سلاسل مَقضيّا عليهم بالموت جميعا «يُنحَر بعضهم على مرأى بعضهم الآخر، المُتأخِّرون منهم يَرون حالهم في حال أشباههم السابقين، يَنظُر بعضهم إلى البعض الآخر بألَمٍ ودون رجاء وينتظرون[18]». أظنّ أن لا أحد من المؤمنين يختلف مع باسكال مهما كانت العقيدة التي يتبنّاها، ومهما كانت صفات الإله الذي يتصوّره في ذهنه. لقد استعمل باسكال، كما هو الشأن في كل الأديان، تقنية الترغيب والترهيب. ودعا الناس إلى اتخاذ القرار والمراهنة، بين تعاسة دائبة أو نعيم لا يَنضب. إن الرهان محتوم «إذا ربحتَ فقد ربحتَ كل شيء، وإذا خسرت فإنك لا تخسر شيئا، فراهن إذن على أنه موجود ولا تتردّد[19]». وطبقا لذهنية الرياضي العبقري مكتشف حساب الاحتمال، يؤكّد باسكال أن من يراهن فإن حظ الربح عنده واحد، أما حظوظ الخسران، فهي لا متناهية، وبالتالي «لا مجال للتردد بل يجب بذل كل شيء. وعليه فمتى كنتَ مجبرا على اللعب وجب أن تجحد العقل لتحتفظ بالحياة عوض أن تخاطر بها في سبيل ربح غير متناه وشيك الحدوث كخسارة العدم[20]».
البشرية هي في خسران مُبين، وليس لها من مخرج إلاّ إذا أحبّت الله فقط، وإذا أحبّت الله فإنها حتما ستبغض ما سواه بما في ذلك نفسها؛ يجب أن نَنفر من كل شيء حولنا، أن نعيش في فرقة بيننا وبين العالم «كل ما يحملنا على التعلّق بالمخلوقات فهو شرّ، لأنه يَحُول دون أن نَخدم الله إذا كنّا نعرفه، أو دون أن نلتمسه إذا كنا نجهله». لكن طبيعة الإنسان مُخَرَّبة من الأساس، ونحن على أية حال «مُفعمون بالشهوة، ومُفعَمون بالشرّ، وإذن يجب أن نكره أنفسنا، وأن نكره كل ما يحملنا على الارتباط بغير رباط الله وحده[21]». هذه هي عصارة فيلانثروبيا المتديّنين: إنهم على استعداد لاحتقار كل صغيرة وكبيرة، وتدمير العالم، وإفنائه في سبيل إلههم. لا أحد من الفلاسفة القدامى احتقر الدنيا والكون وسبّ الإنسان بهذه الطريقة التي يفعلها المؤمنون. ولئن اعترفوا عن طريق التجربة بأن هذا العالم مليئ بالشرور وأن أعمال الإنسان عرضية وغير ذات قيمة فإنهم لم يَصِلوا إلى حد احتقار الكون في ذاته. لا أحد من الرواقيين أو الأرسطيّين، لا أحد من الإفلاطونيين، يمكنه أن يُدين الكون بأسره[22].
إن هذا الكون هو إله منظور، كما يقول أفلاطون في طيماوس، غاية في العظمة والجلالة، في الجمال والكمال، وحيد من نوعه. إن عجز الإنسان ومحدوديّته لا يَمنعانه من التسامي الذهني، والتوق لمعرفة المجهول والمسك بقوانين الكون. وهذا التوق المعرفي مُبَرّر لأنّنا ككائنات ذوات حس وعقل نُحقّق كمالنا الطبيعي عن طريق تفعيل طاقتنا الذهنية والتفاعل مع العالم الخارجي. لقد جعل أفلاطون من الظواهر الكونية السبب في انتاج المعرفة وابتداع الرياضيات والفلسفة التي هي أعظم الخيرات للإنسان الفاني. يقول في طيماوس: « النظر حسب رأيي، كان سببا لأكبر المنافع لنا نحن البشر. لأننا لو كنا لم نر النجوم والشمس والسماء، لما نطقنا بكلمة واحدة مما قلناه عن الكون. أما الآن فإن مرأى الليل والنهار، وتعاقب الأشهر، ودورات السنين، … قد خلقت الأعداد ومَنحتنا فكرة الزمن، وقدرة البحث في طبيعة الكون. ومن هذا [المصدر] أنتجنا الفلسفة (φιλοσοφίας γένος)، وهي الخير الذي لم يهب الآلهة الإنسان الفاني، ولن يهبوه، خيرا أعظم منه[23]».
وعلى نفس هذه الوتيرة سار أرسطو والعديد من الفلاسفة اليونانيين، فهم حتى وإن أبدوا بعض التشكك في كمال حياة الإنسان فإنهم لم يمكثوا عند تلك الحالة اليائسة، ولكنهم شقوا السّبل وأعطوا الوسيلة للخروج من حالة القصور والبؤس. والوسيلة هي العقل، الذي يصفه أرسطو بأنه إلهي وخالد «إذ ليس عند البشر ما هو إلهي أو مبارك سوى هذا الشيء الوحيد الذي يستحق أن يبذلوا الجهد (من أجلعه)، وأقصد به ما يوجد فينا من العقل وملكة التفكير. ويبدو أنه وحده الخالد، وهو وحده الإلهي من كل ما ينطوي عليه كياننا[24]». ومهما كان خطب الحياة ومهما اشتدّت المحن والبؤس فإن العقل كفيل بأن يُحرّرنا منها ويجعل حياتنا سعيدة بل مضاهية لحياة الآلهة. النتيجة هي أنه بالنسبة لأرسطو، تفعيل طاقات الذهن، أي التفلسف هو الترياق الوحيد لوجودنا، بحيث إن حياةً دون فلسفة، أي حياة محرومة من نعمة التأمل والبحث والتفكير العلمي، هي حياة ليست جديرة بالعيش: «إن حياتنا، على الرغم من أنها بطبيعتها شقية ومضنية، قد نُظّمت بفضل قدرتنا على المشاركة في هذه الملكة ـ تنظيما بلغ من الروعة حدّا يجعل الإنسان يبدو إلهيا بالقياس إلى سائر الكائنات الحية».
وفي موضع آخر من كتابه في الفلسفة يتعجّب أرسطو من الآراء التي تزعم بأن الكون آيل إلى الفناء، ويَتّهم بالمروق أولئك الذين يتنبّؤون بدماره النهائي. إنهم يُحقّرون الكون ويُنزِلونه مَنزِلة المصنوعات اليدوية الإنسانية؛ كيف يمكن أن يؤول إلى الزوال هذا الإله المنظور الرّحب الذي يحتوي على الشمس والقمر، والنجوم؟ يقول بِنَبْرة ساخرة، بأنه في وقت ما كان يَخشى على مَنزله التّهديم بسبب الرّياح العاتية أو العواصف القويّة أو مُرور الزمن أو لإهمال صيانته اللاّزمة، لكنّه الآن تحدوه رهبة أقوى جرّاء أولئك الذين، بواسطة تعاليمهم، يحاولون تدمير الكون بأسره[25].
لقد استعمل باسكال، من موقفه الإيماني المتشائم، نفس تقنية الترغيب والترهيب التي اعتادها المسلمون. فهم يضعون الناس بين خيارين كلاهما خيالي، مدقع عمليّا، وفاسد فلسفيا وعِلميا.
لكن ما يشدّ الإنتباه في خواطر باسكال (وهذا الحكم ينسحب على المؤمنين من أهل الملل الأخرى)، هو الطريقة العنيفة التي يصوّر بها الجنس البشري. لقد وصفه فولتير، بكاره البشر العظيم، وقال إن باسكال يسبّ الإنسانية كما يسبّ أعداءه من اليسوعيين. وقد اعترف أصحابه من بور روايال بالصّيغة الحربيّة التي صاغ بها أفكاره ودافع عنها أمام مخالفيه حتى وإن كانوا مسيحيّين مثله. والسبب في ذلك هو أن «حُبّه الجمّ وتقديره المتفرّد اللذين يكنّهما للدين، جعلا منه ليس فقط غير قادر على تحمّل من يُريد تهديمه والقضاء عليه كليا، بل حتى خدشه وافساده في أدنى جزء منه. بحيث إنه أراد إعلان الحرب على كل أولئك الذين يتهجمون على حقيقة الدين وقداسته، يعني ليس فقط على الملحدين، والكفار والهراطقة، الذين يمتنعون عن إخضاع الأنوار الكاذبة للإيمان، والإعتراف بالحقيقة التي يُعلّمُنا إياها، بل حتى على المسيحيين والكاثوليكيين الذين، بما أنهم في جسد الكنيسة الحقة، لا يعيشون طبقا لصفاء تعاليم الإنجيل، التي قُدّمت لنا كالنموذج الذي ينبغي علينا أن نعدّل ونسيّر كل أفعالنا على أساسه[26]».
الغريب في الأمر أن هذه الحماسة لله، التي يبديها بسكال، وتخييره الإنسان بين الرهان على الخسران الدائم ـ الخلود في الجحيم ـ أو الرّبح الأعظم ـ الخلود في النعيم ـ عوض أن تجلب له الإعجاب أو التعاطف من طرف المتَديّنين جَلبَت له الاستنكار والانتقادات. إذ أنهم استاؤوا، من منطلَق ديني، كيف أن رَجُلا فاضلا وتَقيّا يُسلم حياة الإنسان ومصيره إلى خطر مراهنة لا يدري هل هو الرابح فيها أم الخاسر.
الاستنكار جاءه من أحد اللاهوتيين الكاثوليك. قال له بضمير المتكلّم: لقد عيل صبري لسَماعك تتعامل مع أعلى الصناعات منزلة، وتدعّم أهمّ حقيقة في العالم ومبدأ كل حقيقة، بفكرة وضيعة جدّا وصبيانية، باختزالها في لعبة الوَجه والقِفَا (jeu de croix et pile)، قادرة على الإضحاك أكثر منه على الإقناع، وبحجج واهية جدا، قائمة على دعائم هشة، وربما خاطئة بالكامل[27]. ثم يقول له «لا أدري بأي ضمير يمكنك أن تقول لشخص ملحد: لا يمكن التحقق بالعقل من أن الله موجود. أنا أعرف العديد من الناس الذين سيستاؤون استياء شديدا من سماعك التعبير بهذه اللهجة الرهيبة». إن قوّة حجة باسكال تعتمد على حقيقة هذه القضية: أن كل لاعب يُراهن بِيَقِين على الربح بلا يقين. «لكن في حقيقة الأمر، يا باسكال، لو أن الألوهية هي بهذا القدر من الأشكلة، فنحن في وضعية حَرجة. كل الآباء والأزواج، إذن، الذين لا يريدون أن يتعاطى أبناؤهم ونساؤهم، لعب القمار هم ملحدون بالولادة، … إنه من الجنون أن نراهن على أموال أكيدة محفوظة في الجيب، والتي يمكن العيش بها دون بؤس، لكي نربح أموالا غير محتملة، والتعرّض هكذا، كما يحدث غالبا، إلى خطر خسران هذه وتلك». وكما هو معلوم فإن باسكال شن حملة ضد اليسوعيّين واتهمهم بالتفسّخ الأخلاقي، بل بالنفاق واختراع فتاوى في قضايا الضمير، واستعمال الحيل الفقهية لتبرير كل من أراد أن يفعل شيئا ضد قانون الكنيسة. هذه التهمة يرجعها الكاتب على باسكال، ويقول له لقد سمعتُ أنك كنتَ عدوّا لدودا لأصحاب الحيل الفقهية السؤال هو: «من أين يأتي إذن أنك لا تدين بالمرّة لعب القمار، بل تريد أن تجعل الدين والألوهية يعتمدان على لعبة الوجه والقفا».
فولتير هو بدوره وجّه نقدا لاذعا لرهان باسكال وقال إن هذا المقطع من خواطره «غير لائق وصبياني؛ إذ أن فكرة اللعب، الخسارة والربح لا تتوافق وجسامة المسألة[28]». من الخطأ الصريح القول: «إن عدم المراهنة على أن الله موجود، يعني المراهنة على أن الله غير موجود». لماذا؟ لأن من يشكّ، يقول فولتير، ويطلب الإيضاح، لا يراهن مع أو ضدّ. من الأفضل أن تبدأ بإقناع عقلي، عوض أن تُدغدغ مشاعري: «من مصلحتي دون شك، يقول فولتير، أن يكون هناك إلاه؛ لكن إذا كان هذا الإله، في نَسقكم، لم يَأت إلاّ لنزر قليل من البشر، إذا كان عدد المصطفين هو بهذه القلّة المفزعة، إذا كنتُ لست في شيء من أعمالي، قل لي أرجوك، ما الفائدة من الإعتقاد؟ أليست لديّ فائدة صريحة في الإقتناع بالعكس؟ بأي وجه تريد أن تريني سعادة لامتناهية، التي، من مليون إنسان بالكاد واحد منهم له الحق في التوق إليها؟ إذا أردتَ أن تقنعني، حاول طريقة أخرى، ولا تكلمني حينا على لعب القمار، رهان، وجه وقفا، وأحيانا ترهبني بالأشواك التي تزرعها على الطريق الذي أريد ويجب عليّ أن أسلكه. إن حجّتك لا تفيد إلاّ في تخريج ملحدين … بنفس القوة التي لها هذه الدقائق من ضعف».
إن تصوير الإنسان في حالة تيه وضياع، وكأنه يعيش وحيدا مقذوفا به في جزيرة قاحلة، دون أدنى وسيلة للخروج من حالة البؤس والوحدة، لهو تشبيه إرهابي. أنا أعجب يقول باسكال «كيف لا ندخل في حالة يأس من وضعية بائسة جدا كهذه». لكن فولتير يرد بأن البشرية ليست على هذه التعاسة الدائمة التي يصورها عليها باسكال والمؤمنون عموما. بالنسبة لي، حينما أشاهد مدينة باريس أو لندن لا أرى أي داع للسقوط في هذا اليأس الذي يتحدث عنه باسكال: أرى مدينة، يقول فولتير، لا تُشبه في شيء جزيرة قاحلة، بل هي معمورة، فاخرة، متحضرة، أين يسعد فيها الناس بقدر ما تسمح به طبيعتهم. ثم «مَن هو الإنسان الحكيم المُستعدّ لِشَنق نفسه لأنه لا يعرف كيف يرى الله وجها لوجه، أو لأن عَقله لا يستطيع أن يحلّ سر الثالوث؟ يجب بالمثل أن يتملّكنا اليأس لأننا لا نملك أربعة سيقان وجناحين[29]». لماذا هذه القسوة على البشرية؟ لماذا عدم الثقة بالإنسان؟ يتساءل فولتير: “لماذا يُرَاد إرعابنا بوجودنا؟”. فالوجود الانساني كما هو معلوم حسب أساطير الأديان هو وجود اجرامي، لأنه ناتج عن خطيئة أولى ـ (صبيانية وسطحية جدا، لا تستدعي في حدّ ذاتها ردّة فعل عنيفة من طرف خالق الكون) ـ اقترفها كائن أسطوري في غابر الأزمان. إن النظر إلى عالمنا، يقول فولتير، وكأنه سجن، وكل البشرية كمجرمين، هي فكرة إنسان متعصّب.
باسكال يَتلذذ بتصويرنا كلنا أشرارا وتعساء؛ فهو يكتبُ ضدّ الطبيعة الإنسانية بنفس القوّة التي كان يكتب بها ضد اليسوعيين؛ يُلقي على طبيعتنا تُهَما لا تنطبق إلاّ على بعض الناس: إنه يسبّ الطبيعة البشرية بفصاحة لا مثيل لها. لكن حسب فولتير، نحن لسنا أشرارا ولا تعساء كما يصوّرنا كاره البشر العظيم هذا[30].
لكن أكثر ما يشد الإنتباه هو تلك النزعة كارهة البشر التي تَميّز بها باسكال والتي على أساسها فضّل النفور حتى من أقربائه لإرضاء حبّه لله. وهي تصرفات لم تُثر اعجاب المفكرين ولا تعاطفهم. فولتير من موقع فيلانثروبي، يقول بأنه يجب حبّ المخلوقات جميعها: يجب حب الوالدين، حب الزوجة، والأبناء والوطن. المبادئ النقيضة ليس من شأنها إلاّ أن تُولّد مفكرين برابرة، أو لاإنسانيين. ماذا ستكون عليه حالة الإجتماع البشري لو أن الإنسان فضّل محبة كائن وهمي على ما هو أقرب منه؟
لقد أثار تشبيه باسكال الرهيب للبشرية على أنها مجموعة من المساجين يُذبَح كل واحد منهم على مرأى ومَسمع الآخر، سُخط فولتير. وقال إن هذا التشبيه لَفَضيع جدا، ومبالغ فيه وغير مطابق لواقع الحال: إن المصير الطبيعي للإنسان ليس هو بأن يُسجن أو يُذبَح، بل لكي يعيش ويؤدي وضائفه، ثم يموت ومنها يدخل في دورة المادة الكونية. إن البشرية، ككل الكائنات الحية الأخرى، مجعولة لكي تنمو، وتحيا لوقت ما، تُنجب أشباهها ثم تموت. يُمكن في عمل هجائي ساخر أن نُصوّر الإنسان كما نشتهي ونُمرّغه في الوحل، لكن حسبنا استعمال بسيط العقل كي نَعترف بأن الإنسان من بين الحيوانات هو الأكمل، الأسعد وهو الذي يعمّر أكثر. وعوض أن نَتَذمّر ونَشتكِي من سوء الحظ ومن قصر الحياة، يجب بالتالي أن نَغتَبط ونهنأ بسعادتنا ومُدّتها.
إن الاقتراح بشراء سعادة خالدة بثمن بخس وتفادي تعاسة بلا نهاية لا يمكنه أن يُقنع الأرواح الحرّة. لا يمكنه أن يُقنع رجلا يُفكّر مثل فرجيليوس الروماني الذي قال: «سعيد من استطاع أن يعرف علل الأشياء، وأن يدوس بقدميه كل المخاوف والقدر المحتوم وهدير الإله الجشع أقيرونت (فرجيليوس، جويروجيكا 2)». هذه الفكرة لا تقنع من هو متيقّن من أن لا حياة بعد الموت، وإذا ما أخذ الأمر بصرامة فلسفية سيردّ على كل من ساومه أنه غير مستعدّ أن يخسر ولو درهما واحدا، لشراء العدم أو الوهم؛ وأنه لا وجه للمقارنة والتناسب بين درهم وكائن غير موجود كما بين النّقطة واللانهاية[31]. على أية حال التفريق بين الإنسان الخيّر والإنسان الشرير ليس هو الوحيد الموجود في الطبيعة. قد نجد أيضا صنفا من الناس تشبّعوا بالفلسفة إلى حدّ أنهم يعيشون في أتم الراحة في هذا العالم، دون قناعة في حياة مقبلة، بل بقناعة معاكسة. من يريد انتزاع هؤلاء الناس من وضعيتهم تلك بتقديمهم فكرة الرهان، يتصدون له بالقول إنه من باب الجنون الخروج من حالة الراحة التي تتمثل فيها السعادة الأسمى في هذه الدنيا، للدخول في أخرى تعجّ شكوكا، مخاوف وانعدام يقين. إنه من العجرفة بمكان الركون إلى اللايقين والشك على أساس الرجاء فقط أو الخوف من مستقبل يُنظَر إليه وكأنه مجرّد استيهام؛ فضلا عن اليقين من أن لا واحد من أتباع الحزب الذي تقترحونه توصّل عن طريق معتقده أو إيمانه إلى نيل بصيص من السعادة في هذا العالم، لكن الحكماء استطاعوا الوصول إليها بفضل الفلسفة والعقل مُجرّدٌ من الأحكام المسبقة والسلطة الموروثة.
3. جحيم المؤمنين وجنة الملحدين
هل حياة الإنسان الملحد هي فعلا مُنغمسة في التعاسة والشقاء؟ هل حياته هي حياة بهيمية نازعة للملذات والخلاعة، وراغبة فقط في تلبية غرائزها دون هدف سام أو غاية أخلاقية عليا؟ هل إنها حياة متفائلة ومشرقة تلك التي يعيشها الإنسان المؤمن في ترقّب النعيم الذي سيحوزه، لا بأفعاله، بل برحمة إله اعتباطي غير مقيدة بشيء إلاّ بمشيئته المتقلّبة؟
لنقم بتجربة ذهنية “افتراضية” ونقارن لقطة من حياة وأعمال وتصرفات إنسان ملحد وآخر مؤمن، ونرى مَن منهما سيخرج مُهشّما بائسا تعيسا. أستعيرُ هذه المقارنة من سيلفان ماريشال (S. Maréchal)، أحد العقلانيين الملحدين الذين عاصروا الثورة الفرنسية، والذي اصطدم هو نفسه بادّعاء المؤمنين من أن الملحدين تعساء لا يستفيدون شيئا من دنياهم وهم في الآخرة في خسران. ولكي يُثبت العكس، اقترح هذه المقارنة بين طبع وعادات الإنسان دون الإله (l’homme – sans - Dieu) وعادات وطبع إنسان ـ الله (l’homme-de-Dieu). قال: شاهدوا هذا الأخير «إنه يعيش باستمرار في الخوف والمهانة، مثل العبد الذي يُقبّل السّياط التي تجلده. إذا عمل صالحا، عوضا أن يشعر باعتزاز مشروع، فهو يملك الغباء لكي يسندها إلى سيّدٍ أملاها عليه. إذا فكّر في عمل سخي، يطلب الإذن والنعمة للقيام به. طفل ضعيف، لا يجرؤ على وَضْع قَدَم أمام الأخرى، دون أن يَنظر إلى الأب، الله[32]». انظروا إلى تصرفات وحركات الإنسان المتديّن، يواصل ماريشال: قائما راكعا ساجدا، وهو يناجي ربّه، «هل هناك من كلمات أكثر سخافة أو أكثر غَفلة من تلك التي يستخدمها في صلواته؟ إذا فقَدَ زوجته أو أبناءه، فهو يشكر خالقه، لأن لا شيء يحدث دون أوامره. وفي فراش الموت، شبيه بالمجرم، يرتجف من قرب الحساب. إن فكرة إله غضوب، مُجاز ومُنتقم تمنعه من أن يُسلِم نفسه عن طواعية إلى الطبيعة. فهو يَنبذ بكل برودة أهلَه، وأصدقاءه، لكي يكون جاهزا للمثول أمام المحكمة السماوية[33]». كيف هي هذه الحياة؟ أليست هي التعاسة بعينها. «أجل بالتأكيد ـ يقول الكاتب ـ إن حياة من هذا القبيل هي عذاب دائم، وتُحَقِّقُ في الدنيا جحيم العالم الآخر[34]».
هذه العبارات التي يصف بها ماريشال عبادات الإنسان المؤمن، تُذكّرنا بآراء فرقة من الفرق التي انشقت عن الإسلام (الباطنية)، يصفهم الغزالي بأنهم كفار قالوا إن عبادات المسلمين من صلاة وصوم وزكاة وحج، وبالجملة كل الطقوس المفروضة عليهم، هي جحيمهم في هذه الدنيا. فالعبادات، بما هي كذلك، نِقمة على البشرية، والتكاليف جديرة فقط بالجهال والحيوانات: « إنما تَكليف الجَوارح في حَقّ مَن يَجري بجَهله مَجرى الحُمرِ التي لا يُمكن رِياضتها إلاّ بالأعمال الشاقّة وأما الأذكياء والمُدرِكون للحقائق فدَرَجتهم أرفع من ذلك[35]». هؤلاء الناس يسخرون من المسلمين عن طريق القرآن نفسه، حيث يُؤوِّلون تلك الصور الرهيبة من التعذيب التي جاءت فيه على أنها أمور تخصّ المؤمنين في هذه الدنيا، بحيث إن: « النار والأغلال عبارة عن الأوامر التي هي التكاليف فإنها مُوَظّفة على الجهّال بعلم البواطن، فما داموا مستمرّين عليها فهم معذّبون[36]».
إنسان الله لا يتنعّم بشيء في هذه الحياة، ووضعيّته هي أبشع من وضعية العبيد والسجناء. فالعبيد، كما يقول افلوطرخس، يَنسون أتعابهم وقسوة معاملة أسيادهم، والسجناء يَتخلّصون من ثِقَل أغلالهم إذا أخلدو للنوم. لكن لا يمكننا أن نقول نفس الشيء عن إنسان الله، لأن النوم ذاته لا يُمثل له لحظة هُدنة. فعَالمُه الخرافي لا يترك لروحه الفرصة كي تتنفّس، كي تستعيد قواها وتَدفَع الاعتقادات القاتلة التي اصطنعها عن إلهه[37]. إن راحة المؤمن الخرافي، يُضيف افلوطرخس، شبيهة بإقامة الكافر بعد الموت، حيث تتشخّص أمامه أشباح رهيبة، عذابات فضيعة تَقضّ مضجعه وتُوقظه في هزيع الليل: مُرتعدا من أحلام مرعبة، يَجلد ذاته، ويُعذبها، ويصبح لنفسه طاغية أقسى من طغاة الأرض. الناس في اليقظة لا يملكون إلاّ عالما واحدا مشتركا بينهم، كما قال هيرقليطس؛ وفي وقت النوم، كل واحد يعيش في عالمه الخاص. إنسان الله، أو الإنسان المؤمن الخرافي، ليس له أي عالم مشترك بينه وبين باقي البشرية: في حال اليقظة، فهو لا يَستخدم أبدا رُشده؛ في النوم، لديه دائما شيئا يُعذبه؛ وبينما يَغطّ عقله في سبات عميق، فإن الخوف يُحدّق به من كل جانب: لا يمكنه أن يفرّ منه ولا أن يتخلّص من براثينه. إن العبيد، يقول فلوطرخس، إذا يئسوا من الانعتاق فإنهم يَلوذون بالفرار أو على الأقل يُطالِبون بأن يُبتَاعوا من طرف سيّد أكثر إنسانية؟ إلى أي سيّد يستطيع أن يَبيع نفسه إنسان الله؟ إلى لا أحد. كم هي وحشية وتعيسة حياة أولئك الذين هم غير قادرين على الفرار ولا على تغيير السيّد[38].
كيف هي حياة الإنسان دون الله؟ الإنسان دون الله، بالمقارنة مع إنسان ـ الله، له تصرفات مغايرة، وفي الجهة النقيض. فلنتّبعه في أحد أيامه: « يستفيق من أحضان زوجته أو من النوم، لكي يشهد بزوغ الجرم العظيم (الشمس)، وإثرها يُنظّم شؤون المنزل ويُرتّب أعماله. بعد أن يعطي الدروس الأولى لأبنائه، يتناول فطور الصباح مع عائلته. إثر ذلك كل واحد يتّجه إلى قضاء حوائجه وتأدية إلتزاماته […] بممارسته ملكاته الطبيعية والمكتسبة، الإنسان ـ دون ـ الله لا يعرف الضّجر. كل ساعة تمنحه فرصة للقيام بملاحظة ما، لأداء عمل نافع. وكجزء لا غنى عنه من الطبيعة، فاعل مثلها، فهو ينسجم معها، لكي يقوم بواجباته التي تفرضها عليه علاقاته بباقي الكائنات. إذا جنّ الليل، يقضي لحظات ممتعة في وسط عائلته، أو مع صديق، ثم يخلد للراحة، أجرا مستحقا ليوم من التعب. تنتظره راحة ليلة كاملة، ينام فيها راضيا لأنه لم يترك أي فراغ في يومه المنتظم بحسب مسار الشمس. كيف هو الأمر بنهاية حياته؟ إنه يلتقط أنفاسه لكي يتمتع بالملذات الباقية، ويُغمض عينيه إلى الأبد، لكن مع اليقين من أنه تَركَ ذكرى جليلة وعزيزة في قلوب أقربائه، والتي يَجني منها آخر شهادات التقدير والإعتراف. انتهى دوره، ينسحب بهدوء من الركح لكي يُفسح المجال لمُمثلين آخرين، يأخذونه كنموذج. صحيح أنه يشعر بالأسف الشديد على فراق الأحبّاء، لكن العقل يقول له إن هكذا هو النظام الخالد للأشياء. وبعد، فهو يعلم أنه لن يموت كليا. إن أب عائلة هو خالد: فهو يُبعث ويحي مجددا في كل واحد من أبنائه، وحتى آخر ذرة من جسده، لا شيء منه يمكن أن يُعدَم تماما. حَلقَة غير فاسدة من السلسلة الكبرى للموجودات، الإنسان دون الإله، يَحتضن كل الامتداد بالفكر، ويُعزي نفسه بنفسه، غير جاهل بأن العبور هو ليس إلاّ تحوّلا في المادة وتغيّرا في الصورة. وفي لحظة مغادرته الحياة، يُراجع في ذاكرته، إذا سنحت له الفرصة، الخير الذي كان قادرا على فعله، وكذلك الأخطاء التي كان بإمكانه تفاديها. فخورٌ بحياته، لم يركع لأحد؛ سار في الأرض، مرفوع الرأس بخُطى واثقة، مساو للجميع، وليس له من واجب تقديم حساب إلى أي أحد إلا لضميره. حياته ممتلئة مثل الطبيعة: هذا هو الرجل (Ecce vir)[39]».
إن عالم الإنسان بدون الإله، يبدو أمام عالم الإنسان المؤمن أكثر إشراقا، وأقل نكدا. فعلا «الملحدون، يواصل الكاتب، يمشون بخطى واثقة، باجتماع متساو ولطيف؛ وهم الوحيدون الذين يعرفون التلذذ بلطف واعتدال، بحسب رغبة الطبيعة، والتي يستفتونها قبل كل شيء؛ إنه من النادر أن تَجد بينهم متعصّبين وموسوسين. سعداء وراضون بأقل تكلفة، لأنهم عارفون كم هي قصيرة الحياة، ويُفضّلون بالتالي قضاءها في الوئام بدل المشاجرة وفي المحبة بدل الكره. ولذلك فإنهم لا يرون ضيرا في أن يُفكّر أحدهم بخلافهم. فلاسفة دون ادّعاء، لا ينزعجون أبدا من السباب، وحتى من الإهانات التي غالبا ما يقذفهم بها رجل الله؛ إنهم ينظرون إليه كصبيّ سيء التربية[40]».
يقال بأنه لحفظ السلم الاجتماعي وترسيخ مكارم الأخلاق، وملئ فراغ القلب، من الضروري الاعتقاد في وجود الله، في خلود النفس، وفي يوم الحساب والعقاب. وإن مَن لا يتمسّك بهذه المعتقدات لا يقدر على الأعمال الصالحة ومن المحتمل أنه سيكون عنصرا خطيرا على السلم الإجتماعي. لا يمكن أن يُسخّر حياته إلا لأجل المصلحة الشخصية، والظفر بأشياء دنيوية متحولة، مثل الفخر والمجد، أو المال والثروة ورغد العيش. هذا اعتراض واهن لأن المتديّنين هم أكثر الناس شبقيّة وتلهّفا على الملذات في العالم. ألم يَسمح إله المسلمين، في القرآن، بأن يتّخذوا أربع نساء ويتلذذوا بما طاب لهم من الإماء التي يجوز لهم سَبْيها أو اشترائها من سوق النخاسة؟ ألم يَعد بزيجات عديدة حتى في الآخرة، بعد أن ينشروا ويدخلوا الجنة، بل إنهم منغمسون في جميع أصناف الملذات، على شكل مدينة الملذات الخليعة، حيث هناك الخمر والأكل والشرب والجماع (إلاّ التفكير الفلسفي). الملحد على العكس من ذلك، وعن طريق بسيط العقل، يعلم أكثر من أي أحد آخر، محدودية وزوال هذه الملذات الجسدية التي يُقبِل عليها العامي والمتدين. إن الحكماء العارفين المتبصّرين بهذه الحقيقة، حسب قول مسكويه، «هانت عليهم أمور الدنيا، كلها واستحقروا جميع ما يستعظمه الجمهور من المال والثروة والملذات الخسيسة، والمطالب التي تؤدي إليها، إذ كانت قليلة الثبات والبقاء سريعة الزوال والفناء … فاقتصروا فيها على المقدار الضروري في الحياة[41]».
إن الإنسان الملحد، بصفته ملاحظا مثابرا، وصديقا متنوّرا للطبيعة، يحتاج إلى أشياء عظيمة تستثير فضوله، وتُغذّي خياله. إن أولئك الذين يدعون إلى ضرورة ترسيخ الاعتقاد في إله ما، لحَمل العامة على الطاعة وحثها على الأعمال الصالحة، هم مخطؤون في حسبانهم، لأن الله غير صالح لا للمحكومين ولا للحكّام (Dieu n’est utile ni aux gouvernés ni aux gouvernants). إن الله، يضيف ماريشال، منذ سنوات عديدة، لم يعد لديه تأثير كبير في الأولين. فالشعب ليس هو بهذا القدر من البلاهة، لكي لا يرى أن الله لا يمكن أن يكون رادعا لحكّامه المتسلّطين الطغاة. وتكفي تجربة يومية حتى نتفطّن لذلك. وبعد فإن الجميع يتقبلون اعتقاداتهم الدينية باتباع الآباء كما تقبلوها هم من أجدادهم جيل بعد جيل. إن الله، يقول ماريشال « يُشبه ذاك الأثاث القديم الذي بعيدا عن أن يساعد، فهو يُحرج فقط، لكنه يُمَرَّر من يد إلى يد، داخل العائلات، ويُحافَظ عليه بقداسة، فقط لأن الإبن حصل عليه من أبيه، وأباه من جدّه[42]».
الملحد هو صديق البشر، والمؤمن هو كاره البشر. الملحد يَخدم الجنس البشري لأنه يحطّم الاستيهامات الضارة التي تعبث بعقولهم، لكي يرجعهم إلى الطبيعة والتجربة والعقل. إنه مفكّر، بحكم تأمله في المادة، في خاصياتها وضروب تفاعلاتها، لا يحتاج لتفسير ظواهر الكون إلى قوى متعالية، إلى عقول خيالية، والتي عوض أن تُجلي أسرار الطبيعة تزيدها غموضا وتجعلها غير صالحة لسعادة الإنسان. إنه من الجنون تفضيل المعلوم على المجهول، وتبجيل من يُمعِن في تجهيل الناس على من يرغب في تحريرهم.
الفيلسوف فرانسيس بيكون أصاب عين الحقيقة حينما قال إن الإلحاد يترك للإنسان العقل والفلسفة والتقوى الطبيعية، والقوانين والشهرة وكل ما يمكن أن يكون بمثابة دليل للفضيلة. لكن الإيمان الديني يدمّر كل هذه الأشياء وينتصب كطاغية في أذهان الناس. ولهذا السبب فإن الإلحاد لا يولّد أبدا اضطرابات في الدّول، ولكنه يجعل الإنسان أكثر حذرا عن نفسه، مثل ذلك الذي لا يرى أي شيء بعد هذه الحياة. ويضيف إنه في الأزمان التي كان فيها الناس أميل إلى الإلحاد، كانوا أكثر هدوءا. لكن الدين ألهب دائما الأرواح وأدّى إلى أخطر الإضطرابات والفتن، لأنه يُسكِر الشعب بالحماسة والتعصب ويسحب معه كل الحكومات[43]. إن نسق الإلحاد لا يمكن أن يكون إلاّ ثمرة دراسة مُعمّقة، ونتاج تدقيق وتحقيق لا مكان فيه للعواطف والخيالات العارمة. المسَالِم أبيقور لم يسبّب القلاقل والفتن في اليونان؛ شِعر لوكراسيوس لم يجلب الدمار والحروب الأهلية لروما؛ مؤلفات سبينوزا لم تُثر في هولندا نفس الاضطرابات التي أثارتها مماحكات اللاهوتيّيْن غومار (Gomar) وأرمينيوس (Arminius)؛ هوبز لم يُرق الدماء في انجلترا، رغم أن في عصره، شنق التعصّب الديني ملكا. نحن نتحدّى أعداء العقل الإنساني، يقول دولباخ، أن يعطونا مثلا واحدا يبرهن بصفة نهائية على أن آراءًا فلسفيّة بحتة أو إلحادية مضادة للدين تسبّبت في تشويش السلم العامّ.
يجب أن تكون فقيرة الموارد السياسية وعديمة الأنوار، تلك الحكومات التي تعتقد أنها في حاجة إلى الدين لتسيير شؤونها. إن الثورة الإلحادية تؤسّس لسياسة رشيدة وتجذّر فكرة الأنوار، وبالتالي تُحدِث مفعولا صحيّا يعود بالنفع على النفوس الطيّبة وعلى كل المؤسسات. المهمّة الملحّة هي إذن «التحطيم التام والكامل لخطإ طويل ومُهَيمن يَتدخّل في كل شيء، يُشوّه كل شيء حتى الفضيلة؛ والذي كان مَصيدة للضعفاء، رافعة للأقوياء، حاجزا للرجال العباقرة؛ إن التحطيم التام والكامل لهذا الخطإ المديد المُهيمِن سيُغيّر وجه العالم[44]».
الكلّ ينادون بالرّجل الخارق للعادة، المبعوث الإلهي الذي يحطّم الطاغوت ويملأ الأرض عدلا وإنصافا بعد أن مُلئت ظلما وجورا، الملحدون إن كان لهم أن يتمنّوا شيئا من هذا القبيل، فإنهم يودّون أن يأتي مُحسن الجنس البشري، هذا المشرّع الحكيم، كما يقول ماريشال، الذي يَجد السرّ لكي يفسخ من أدمغة البشر كلمة الله (effacer du cerveau des hommes le mot Dieu)، ذلك الطلسم الخبيث الذي ارتُكِبت من أجله أفضع الجرائم واقتُرفت أبشع الشرور[45]. وفي انتظار هذا الحدث الجلل الذي يَهابه العديد من الناس الذين يعيشون على الأكاذيب، والذي يتمنّاه الحكماء لكن دون التعجيل به، نقول لمعاصرينا الحيارى: «أرأيتم! الله له في صفّه الجهل والكذب، الخوف والاستبداد؛ ضدّه العقل والفلسفة ودراسة الطبيعة وحب الاستقلال الذاتي. الله يعتمد في ولادته على سوء تفاهم. لا يوجد إلاّ بسِحر الكلمات، معرفة الأشياء تَقتله وتُفنيه[46]»




